عبد الله عبد الدائم
01 08
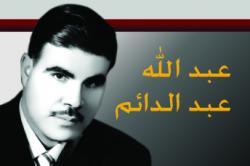
المحتويات
- حياته
- الوظائف التي شغلها
- مؤلفاته
- أهم مؤلفاته التربوية باللغة العربية
- أهم مؤلفاته القومية والفكرية
- بعض مؤلفاته المدرسية
- مؤلفاته بالفرنسية
- مقالات وبحوث متنوعة
- معرفته باللغات الأجنبية
- نشاطاته والجوائز التي حصل عليها
- حول فكر عبد الله عبد الدائم
- كيف ينظر الدكتور عبد الله عبد الدائم إلى تجربته
- وفاته
- مركز دراسات الوحدة العربية يؤبن الدكتور عبد الله عبد الدائم
- نص كلمة الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي الأستاذ معن بشور في تأبين الدكتور عبد الله عبد الدائم في مكتبة الأسد بتاريخ 27-10-2008
- قالوا فيه
- الدكتور عبد الله عبد الدائم، المفكر القومي والتربوي المتميز
- عبد الله عبد الدائم: حياته تأسيس مستمر
- منزلة سامية بين المؤلفين العرب
- علمني والدي
- مراجع
تمر الأمم بفترات تاريخية تكون أحوج ما تكون فيها إلى وعي ذاتها القومية، وتكوين أسس فكرية تستند إليها في مراحل نهوضها الكبرى، وغالباً ما تتبدى مظاهر ذلك الوعي من خلال علماء ومفكرين وقادة يقومون بتحديد سمات الأمة الحضارية وتبيان ملامحها الإنسانية، بحيث تتحول أفكارهم إلى تفاصيل عملية تهتدي بها الجماهير المنطلقة نحو مستقبلها، وتعتمد عليها في المضي على طريق تحقيق الذات القومية وفق أسس حضارية علمية سليمة، تبني الإنسان والمجتمع على حد سواء.
ولا نغالي إن قلنا إن المفكر القومي والعالم التربوي الكبير الدكتور عبد الله عبد الدائم هو واحد من الذين أناروا – بعلمهم ونضالهم – طريق الأمة العربية في تحولاتها الكبرى المصيرية، التي عاشتها منذ بداية القرن العشرين، انطلاقاً من وعيها بذاتها كأمة ذات كيان مستقل – في الثورة العربية الكبرى – وصولاً إلى نضالها اللاهب ضد قطعان الاستعمار الأجنبي، وتأسيس كيانات عربية منفصلة لم ترقَ إلى طموح الجماهير في دولة واحدة تجمع أمة واحدة، فظل هذا الحلم الهاجس الأكبر الذي يحرك الكتاب والشعراء والمفكرين والقادة السياسيين على حد سواء، وسط ظروف دولية أتت بالحيف والظلم على هذه الأمة، وكان من أسوأ نتائجها تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين العربية.
إلا أن رد الدكتور عبد الله عبد الدائم، اختلف عن ذلك الرد العاطفي الوجداني الذي تميزت به معظم المساهمات الفكرية والأدبية في مقاربة قضايا الأمة العربية المختلفة، بدءاً من مواجهة الحركة الصهيونية الغاصبة، وصولاً إلى معالجة مسألة الوحدة وكافة المشاكل المطروحة التي يفرضها تخلف المجتمع العربي في العلم والثقافة والاقتصاد، وضرورة البحث في هذه المشاكل بطريقة علمية لا لبس فيها، تستوعب الواقع بصورته الحقيقية وتعمل على تفكيك مشكلاته الواحدة تلو الأخرى ومعالجتها بروح موضوعية والبحث عن حلول قابلة للتطبيق، في عالم تتعقد أوضاعه يوماً بعد يوم.
إن الروح العلمية التي وسمت أعمال المفكر العربي الكبير، تدعو شباب العالم العربي اليوم إلى التأمل في إنجازاته الكبيرة، سواء على صعيد الفكر القومي أو مسائل التربية والتعليم، بشيء من التفكير العميق، لاستيعاب طريقته المبدعة واستعمال أدواته الفكرية في مواجهة المصاعب الهائلة التي تواجهها أمتها علنا نتقدم خطوة أخرى في الطريق الطويل الذي سار عليه عبد الله عبد الدائم ورفاقه.
حياته
ولد الدكتور عبد الله عبد الدائم في مدينة حلب في 30 حزيران عام 1924، في أسرة دينية، حيث كان والده رجل دين وقاضياً للشرع، وتابع دراسته إلى أن حصل على البكالوريا، ثم تابع دراسته الجامعية في مصر حيث حصل على ليسانس الآداب (قسم الفلسفة) من كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وذلك في عام 1946، ثم تابع دراساته العليا في فرنسا حيث حصل فيها على دكتوراه الدولة في الآداب (تربية) من جامعة السوربون بباريس، بتقدير مشرف جداً، عام 1956.
وكان الدكتور عبد الدائم قد تحدث عن حياته في حوار مطول أجراه معه عباس بيضون لجريدة السفير عدد 27 نيسان 2001، نورد هنا بعضاً منه، لأهميته من ناحية، وللطريقة الحميمة الرفيعة التي تحدث بها الدكتور عبد الله عبد الدائم عن مطلع حياته وقصة دراسته وتطوره الفكري والأدبي حيث دار بين الصحفي والمفكر الحوار التالي:
س ـ سؤالي الأول دكتور عبد الله عن مكان ولادتك، أي ولدت؟
ج ـ كثيرون حتى في سورية يحارون في أمر مولدي. فمنهم من يحسبني من حمص والسبب أن والدتي من حمص وعشت فترة طويلة في هذه المدينة، بعضهم يظن أني من دمشق باعتبار أنني قدمت إلى دمشق في مرحلة الشباب ثم أقمت فيها. والحقيقة أني ولدت في حلب عام 1924 ووالدي من حلب. وهو رجل دين وقاض شرعي وهذا شيء مهم أيضاً في حياتي، وهو بدأ بدراسات دينية في حلب ثم بدراسات دينية عليا في تركيا، ثم أصبح قاضياً شرعياً، بدءاً من عام 1930 تقريباً. قبل ذلك كان يدرس، وتحديداً اللغة العربية. أذكر ذلك لأن معرفته القوية باللغة العربية أفادتني بشكل هائل. فأنا حقيقة تعلمت اللغة العربية من حيث النحو وعمري لا يتجاوز عشر سنوات، تعلمتها بشكل كامل، وبكل تفاصيل النحو على الطريقة القديمة لا على الطريقة الحديثة. وبحكم عمله، كان والدي يتنقل من بلد إلى بلد، وكنت أتنقل معه، ومن هنا عرفت أكثر بلدات سورية ومناطقها وأنا صغير، إلى أن استقر به المقام بعد ذلك في دمشق، حيث أصبح عضواً في محكمة التمييز الشرعية، إلى أن أحيل على التقاعد.
س ـ هل يمكن أن تحدثنا قليلاً عن بيتك، إذ يبدو أنه بيت ميسور بما أن الوالد قاض، وهو بيت عريق اجتماعياً بتقاليده القديمة؟
ج ـ من حيث المستوى المادي والاجتماعي أستطيع أن أقول أنه بيت من الطبقة المتوسطة. لكن أنت تعرف أن الموظف في ذلك الحين، سواء كان قاضياً شرعياً أو غيره، كان يعد راتبه عالياً وكان يحسده عليه الكثير من التجار وهذا الأمر انعكس اليوم. كان كثير من التجار في ذلك الحين يتمنون الحصول على وظيفة، لأن الموظف كان مضرب المثل في الغنى. أذكر أنه في أيام والدي كانوا يقولون أن راتب والدي حوالي 15 ليرة ذهبية عثمانية، ويقولون أنه مهما حاول الإنسان أن يسرف ويتوسع في الرزق وفي الصرف لا يستطيع أن يصرف أكثر من ليرة ذهبية واحدة، فهو مضطر لأن يقتصد 14 ليرة مثلاً، ثمن البيت كان يعادل حوالي مئة ليرة ذهبية، إذاً في أشهر قليلة يستطيع أن يشتري بيتاً.
س ـ أبوك قاض في العهد العثماني، كان إذن ذا ثقافة عربية أصيلة وأيضاً ذا ثقافة عثمانية؟
ج ـ نعم، كان يتكلم التركية ويجيدها، وكان أيام الحرب العالمية إمام طابور، ومقره في عاليه. يتقن التركية كما العربية إتقاناً كاملاً، لأن طلاب المدارس الدينية كانت عنايتهم باللغة العربية كبيرة جداً، بحكم تعلمهم للقرآن الذي هو كتاب العربية الأكبر، على أي حال من ناحية اللغة، من جهة، وبحكم اهتمامهم من جهة أخرى بالطريقة القديمة لتعليم النحو.
س ـ هل كانت تربية الوالد كونه قاضياً ورجل دين تربية صارمة؟
ج ـ كانت تربية صارمة وشديدة، دوماً تحت الحراسة والمراقبة أنا وأخوتي، وبصورة خاصة أخواتي البنات، وكنت أساعد أخواتي البنات على شيء من الحرية ولو عن غير علم من والدي، أحاول أن أروح عنهن بعض الشيء من القسوة. وكنت أحظى بمكانة متميزة إلى حد ما عند والدي فكان يغض الطرف.
س ـ أنت البكر؟
ج ـ لا، لست البكر، لي أخ أكبر مني توفي، وعندي أخت أكبر مني مازالت على قيد الحياة. إذاً كان الجو صارماً، ولكن الشيء المهم جداً بنظري في ما يتصل بأثر البيئة الأسرية على تكويني ليس فقط صرامة التربية ولكن رغبة والدي الحاسمة في أن أدرس الدروس الدينية، وكان لايؤمن بكل المدارس الحديثة، ويعتبر ما يدرس فهيا كفراً وخروجاً عن المألوف. من هنا تدرك أني وقسماً من أبناء جيلي الذين في مثل هذا الوضع، معرضون لأن تقطع دراستهم بسبب هذا الجو التقليدي السائد.
س ـ هل استتبع ذلك صراعاً بينك وبين والدك؟
ج ـ لم يأخذ شكل الصراع. لحسن الحظ أني كنت مغرماً بالدراسة وحصلت على الشهادة الابتدائية أيام الفرنسيين. ونتيجة تفوقي في الشهادة طلب مني المفتش الفرنسي أن أتقدم إلى الشهادة الفرنسية (السرتفيكا). محبتي للدراسة وشغفي وولعي بها، رغم صغر سني، أنقذني إلى حد ما، فبعد أن نلت الشهادة الابتدائية كنت مهدداً بان أترك المدرسة. فإما أن أقبل الدراسة الدينية في مدرسة دينية وإما أن أترك المدرسة نهائياً. تعلقي بالدراسة جعلني ألجأ إلى الوساطات بيني وبين والدي، فرحت أحكي قصتي لمن يستطيع أن يؤثر في والدي من أصدقائه، وأبكي له أحياناً. بعضهم كان حكيماً فأقنع والدي بالموافقة على إكمال دراستي وإن على مضض، لكن على ألا يعلم بما يجري فلا يعنيه أبداً شيء من هذه الدراسة. وظلت الصلات بيننا جيدة لكنه لم يشأ أن يطلع على شيء من دراستي. كنت أنتقل من صف إلى آخر وكنت متفوقاً دائماً، درست المرحلة في مدن عدة، في حلب، وفي دمشق خاصة ودرست في حمص أيضاً. ولكن بشكل أساسي في حلب ودمشق.
س ـ إذا مرت دراستك في سلام مع الوالد؟
ج ـ نعم، الصلات الأخرى كلها كانت جيدة، أحترمه احتراماً كبيراً، وهو يحبني أيضاً، ولكني كنت أتفهم أن رأيه عبارة عن قناعات جيل وقناعات شخص في مثل تكوينه.
س ـ هل تشعر بأن تلك التربية الدينية تركت أثراً عميقاً فيك؟
ج ـ نعم، تركت أثراً من جانبين: الجانب الأول هو الموضوع الذي سبق أن أشرت إليه وهو موضوع اللغة العربية، فتربيت لها الفضل في ذلك. كان والدي يقوم بتدريس بعض الموظفين الكبار أحياناً في ساعات الفراغ، كنت أجالسهم وأتعلم قبلهم نظراً لصغر سني، وكنت البارز بينهم، وعندما يعسر شيء على أحدهم فأنا الذي أجيب. أما ما ساعدني أيضاً في تعلمي للغة العربية فمكتبة والدي الغنية بالكتب الدينية والفكرية والأدبية، والتي أفادتني أيضاً فائدة كبيرة. هذا هو الجانب الأول من موضوع تربيتي المنزلية، أما الجانب الآخر والمهم جداً الذي أثر في من التربية الدينية فهو الجانب الخلقي، فوالدي لم يكن رجل دين فقط بل رجل مبادئ صارمة أيضاً. كان قاضياً، كما كان يقال عن القاضي أيام عمر بن الخطاب، لا يعرف في الحق لومة لائم، واصطدم مع كثير من الحكام والوزراء في قضايا كثيرة من أجل إحقاق الحق الذي هو ديدنه، وطالما تمنى أن يتخلص من القضاء لولا شيخه الشيخ الحسني، الذي أقنعه بتولي القضاء، على قاعدة: قاض في الجنة وقاضيان في النار ...الخ وأيضاً مضمون الحديث: يأتي على الحاكم يوم يتمنى أن لا يكون قد فصل بين خصمين قط. وكان إذا حصلت مشكلة بين خصمين وحدث تدخل لغير مصلحة الحق يقدم استقالته فوراً ويتمنى أن تقبل، ولكنهم لا يقبلونها لأنهم يعرفون أنه رجل مخلص لعمله. تعلمت منه هذه الشدة في الحق، وفي هذه الناحية أعتقد أن هناك تشابهاً كبيراً بين طبعي وطبعه، فأنا لا أستطيع أن أقبل العوج بأي شكل من الأشكال، ولا أستطيع أن أقبل الحيد عن القانون وعن المبادئ وعن الصدق. وهذا جانب آخر مهم جداً أخذته عن والدي الذي كان في الحقيقة مناضلاً ومكافحاً في سبيل إحقاق الحق لدرجة أنه لم يخش لا رئيس دولة ولا رئيس وزراء ولا أحداً. ولطالما رفض أموراً تدخل بها سعد الله الجابري ويحيى حقي وغيرهما، يقف لهم جميعاً بدون أي وجل أو تردد.
س ـ إذا حاولنا أن نستعيد سيرة ثقافية لتلك الفترة، من هم الكتاب والمفكرون الذين بدأت بقراءتهم والتأثر بهم؟
ج ـ حين بدأت الدراسة الثانوية في حمص كنا مجموعة من الطلاب أيام الفرنسيين ذوي عناية باللغة العربية ومنهم مثلاً صديقنا الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق حالياً وهو يسكن معنا الحي نفسه، لذا جعلنا نتبادل الكتب والقراءات. أما نوعية الكتب فكانت كتب الأدب القديم بالدرجة الأولى، وهذا فارق أساسي بيننا وبين الجيل الجديد: في بداية المرحلة الثانوية كنا نقرأ مثلاً «العقد الفريد»، و«البيان والتبيين»، و«زهر الآداب» و«العمدة» لابن رشيق ...الخ، وحتى الآن أنا أفيد من هذه القراءات وأحفظ منها الكثير، فأستطيع أثناء الكتابة أن أستشهد بأشياء من ابن رشيق أو من الجاحظ أو القلقشندي في (صبح الأعشى مثلاً) وغيرهم، هذه القراءات مغروسة في أعماقي لا تغادرني وأنا أكتب في كل لحظة وكأن لغة أصحابها وأفكارهم تعيش معي باستمرار. بعد ذلك، حين اقتربنا من مرحلة البريفيه، تابعت هذا الخط لكن بدأت أهتم بالثقافة الأجنبية. أتقنت اللغة الفرنسية على خلاف زملائي كلهم، وكما قلت إني نلت الشهادة الابتدائية الفرنسية إلى جانب الابتدائية السورية مع أنها لم تكن مطلوبة مني بل هم قدموني إليها. بعدها قرأت كثيراً من الثقافة القديمة بإمعان وبدقة وبتعليقات وهوامش واختيارات، حتى أنني كنت أسجل ولا أزال حتى الآن أحتفظ بتسجيلات ومجموعات دفاتر لمقتطفات وملاحظات من الكتب التي أقرأها. بعد هذه الفترة بدأت باللغة الأجنبية، وهنا أقبلت على القراءة باللغة الأجنبية بنهم، ووجدت عالماً آخر مختلفاً كثيراً.
س ـ من قرأت من الكتاب الفرنسيين؟
ج ـ تستطيع أن تقول كل كتاب القرن التاسع عشر تقريباً، بدءاً من جورج صاند إلى بلزاك إلى ستاندال ولامارتين، وكثير مما قرأت روايات تشفي ظمأ المراهق في تلك السن، وفي الوقت نفسه كانت تعلمين اللغة الفرنسية. وهذا أيضاً زاد آخر أحتفظ به حتى اليوم، ولم يذهب من ذاكرتي، فمازلت أحفظ كثيراً من شعر لامارتين وألفرد دو موسيه.
س ـ هذه البداية الأدبية الواسعة، ألم تجعلك تحاول الأدب؟
ج ـ سؤال وجيه جداً، أنا أتكلم عن مراحل، ثمة سنوات معينة كانت القراءة المكثفة فيها من الأدب الفرنسي في القرن التاسع عشر. بعدها في المرحلة الثانوية، بدأنا بطبيعة الحال دراسة الأدب ودراسة الشعراء، وكان لنا أساتذة من فطاحل الأدباء لم يدرسوا مثل اليوم دراسات أكاديمية وما إلى ذلك، بل كانوا جميعاً من أعضاء المجمع العلمي. كان من بينهم محمد البزم وهو ضليع جداً باللغة العربية، وأيضاً سليم الجندي وعبد القادر مبارك وعز الدين التنوخي، وهؤلاء مستودع علم وأدب، ويتكلمون عن الأدباء كما يتكلمون عن أبنائهم، ويعيشون الشعر والأدب.. وقد تأثرت بهم تأثراً كبيراً. ثم بدأت أقرأ دراسات حول الأدباء، مثلاً دراسات طه حسين عن الأدب الجاهلي وتاريخ الأدب العربي (حديث الأربعاء) ودراسات عباس محمود العقاد والمازني، هؤلاء جميعاً بدأنا نقرأ لهم، وكان لكتاب العقاد حول ابن الرومي تأثير خاص علي وأعجبت به كثيراً فهو عميق جداً. كل هذا جعلني وأنا على أبواب البكالوريا الأولى أحلم بأن أكون أديباً وأحلم بأن أكون شوقي، وقرضت الشعر، أو قرزمته في طور مبكر أكثر. فقد بدأت بالقرزمة من بداية التعليم الثانوي، لكن ذلك لم يكن ذا بال. حين أصبحت في صف البريفيه كدت أصبح كما يقال شاعر المدرسة، في احتفالات المناسبات الوطنية، كنت المتحدث والشاعر. لكن هذا الشعر لا يرقى إلى مستوى جيد، ولا أزال أحتفظ ببعض القصائد لكني لم أنشر منها شيئاً لأني اعتبرتها بدايات آمل أن تتطور ومن ثم أتطور أنا إلى أن أصبح (شوقي) صغيراً لكن. ما كان يشهد على اتجاهي نحو الأدب: في تلك الأيام منذ الصف العاشر أي قبل البكالوريا بسنة كان يبدأ التفريع: شعبة أدبية وشعبة علمية، وكنت معروفاً بين زملائي بأني قوي جداً في الرياضيات والعلوم مع اهتمامي بالأدب، وينتظرون مني أن أختار شعبة العلوم لكني اخترت الأدب وفوجئ الجميع بأني فعلت ذلك لأني شعرت بأن الأدب هو الأقرب إلى نفسي. ودخلت فعلاً في البكالوريا الأولى شعبة خاصة هي شعبة الأدب القديم، وكان فهيا اهتمام خاص بالأدب الفرنسي، وكان عندنا أستاذ فرنسي يدرسنا الأدب الفرنسي القديم الذي تابعته بشكل منهجي بعد القراءات المتعددة لي حوله، ثم دخلت صف البكالوريا الثانية قسم الفلسفة، وكنت الناجح الأول في البكالوريا الأولى. يقول بعض الفلاسفة أن الفلسفة تعطل الشعر إلى حد ما، وبعضهم يقول أن الفيلسوف شاعر أخطأ موهبته، لا أدري ماذا حدث معي ولكني أولعت بالفلسفة أكثر، فانتقلت من الأدب إلى الأدب المعمق إذا شئت، أي عمقت الاتجاه الأدبي بحيث أصبح اتجاهاً فلسفياً، شعرت بأن الفلسفة تغريني لا أقول أكثر من الأدب، لأنها توسع ميدان الأدب وتحفر أكثر في الأعماق، فكنت متفوقاً في صف الفلسفة بشكل نادر ربما، وكان أستاذي أنطون المقدسي، وهو من الشخصيات المعروفة، مازال حياً إلى الآن، ويظل من أكثر الأساتذة ثقافة وفهماً وعمقاً، كان له في الحقيقة تأثير كبير علي. ولحسن الحظ ساعدتني الظروف وأنقذتني. وهنا أرجع إلى الظروف العائلية والبيت، ماذا سأفعل بعد نيل البكالوريا من دون مساعدة أهلي، كان متوافراً لي في دمشق في ذلك الحين إما دراسة الحقوق أو الطب، ولم تكن الكليات الأخرى الإنسانية قد استحدثت، فأنا تخرجت من الثانوية سنة 1942 ولم يكن هناك من كليات سوى كليتي الطب والحقوق، وهما كليتان قديمتان أنشئتا منذ عهد الأتراك ثم جددتا في حكومة الملك فيصل، وكان من المستحيل أن أفكر في أن أطلب من والدي إرسالي إلى كلية الطب أو حتى إلى كلية الحقوق غير الواردة عنده أصلاً لأنه كان يكره المحامين ويعتبرهم جماعة دجالين. كلية الطب تحتاج إلى نفقات ومصاريف، كان الوضع حرجاً. تقدمت، كما كان يفعل الكثير من زملائي في ذلك الحين الذين لم تكن عندهم وسيلة أخرى، تقدمت بطلب إلى وزارة التربية لأكون معلماً في قرية ما، في حوران أو غيرها وكان هذا قدري. وقعت على إعلان في وزارة المعارف وكنا لانزال تحت الانتداب الفرنسي عن مسابقة لاختيار أستاذة للتعليم الثانوي، يسافرون للحصول على الليسانس ويعودون أساتذة للتعليم الثانوي، وهذه السنة كانت شائعة في أيام الانتداب لكن (بالقطارة)، فقد كان عدد المدارس الثانوية محدوداً، ففي دمشق كلها ثانوية واحدة وفي حمص واحدة. اختيار الأساتذة يتم على رؤوس الأصابع، عندما تظهر الحاجة إلى أستاذين أو ثلاثة أو أربعة يرسلون إلى فرنسا العدد المعين من الأساتذة ليدرسوا بعض الاختصاصات ثم يعودون إلى التدريس في التعليم الثانوي.
س ـ هكذا اتجهت إلى التربية والتعليم في ذلك الوقت؟
ج ـ لا، عندما أعلن عن المسابقة كانت الحرب العالمية الثانية قائمة، كان مفروضاً أن أرسل إلى فرنسا ذا نجحت في المسابقة، هذا هو المتبع، لكن طريق فرنسا مغلق، هكذا توجهت أول بعثة سورية رسمية أيام الفرنسيين للدراسة في مصر، في القاهرة، تقدمت إلى المسابقة وكان هناك حوالي خمسة اختصاصات: الأدب الفرنسي، التاريخ والجغرافيا والأدب العربي، والفلسفة، وكل اختصاص بحاجة إلى أستاذ واحد، فينبغي أن يكون المتقدم الأول من بين المتقدمين حكماً. وجدتها فرصة ذهبية أحلم بها فتقدمت إلى المسابقة ونلت المركز الأول، وأرسلت، هذه نسجلها لا لنمتدح حكم الانتداب الذي كان يعد الاختصاصيين اللازمين لخدمة الاستعمار، لكن من الحق أن نقول أنهم لا يتلاعبون قط في قضية الكفاءة، فمن أنا حتى يتم اختياري لبعثة. لو أريد في أي بلد عربي اليوم اختيار شاب لإرساله في بعثة إلى الخارج، لا أعتقد أن الأمر يتم بمثل هذه النزاهة، وأن الناجح الأول يرسل وكفى. من هذه النقطة مرت في ذهني قناعة بأننا لو أردنا أن نبدأ الإصلاح الحقيقي في البلدان المتخلفة علينا أن نفسح المجال للكفاءة، أن نختار حقاً لكل منصب من هو كفء له. هذه هي بداية الإصلاح الحقيقي. وترك ذلك أثراً في نفسي، أنا الطالب المتخرج من البكالوريا ولا حول لي ولا طول ولا أعرف أين سأكون. ثم فتح لي الباب وأثبت جدارتي، وهذا شأن بقية زملائي الذي تقدموا معي أيضاً وأكثرهم في مثل هذه الحال، ومنهم الدكتور شاكر فحام الذي ذكرته، وغيره. أتيح لنا بحكم كفاءتنا أن تتابع دراستنا. وحصلت على الليسانس في قسم الفلسفة، في مصر حيث قضيت أربع سنوات، كنت خلالها أزور سورية في الصيف.
س ـ هل أثر فيك الجو المصري الفكري والثقافي والسياسي في تلك الآونة؟
ج ـ في الحقيقة، تأثرت بالجو المصري، لكن أريد أن أركز خاصة على جانب مهم، عندما قدمنا إلى مصر، كانت مصر ماتزال بعيدة عن العروبة والقومية العربية والفكرة العربية غير مطروحتين. إذا دار الحديث عن فكرة تتجاوز مصر فالحديث يذهب إلى الرابطة الإسلامية وإلى شيء من هذا النوع، أما الرابطة القومية العربية بالشكل الذي كنا نفهمه نحن هنا في بلاد الشام وخاصة في سورية ولبنان، فلم تكن موجودة إطلاقاً في مصر، والأشخاص الذين يعتبرون إلى حد ما من أنصار العروبة والفكر العربي: علوبة باشا ومحمود عزمي وعبد الوهاب عزام وغيرهم. كنا نلتقي بهم كطلاب فنشعر بأن أفكارهم عن القومية العربية غامضة جداً وملتبسة وليس عندهم فلسفة قومية حقيقية. قسم من أساتذتنا الشباب الذين كانوا دخلوا ميدان التدريس حديثاً وكانوا من النابهين ومنهم الدكتور عبد الرحمن بدوي وعبد العزيز الأهواني، وغيرهما. كنا نلتقي بهؤلاء ونناقشهم ثم ألفنا رابطة أسميناها (رابطة الطلاب العرب)، من أهم مؤسسيها المرحوم حسن صعب من لبنان الذي درس آنذاك في قسم اللغة العربية وكان ناشطاً سياسياً ومتحركاً وديناميكياً، لكن الأفكار الأساسية في الحقيقة صدرت عن مجموعتنا. أقمنا حفلات دعونا إليها الأساتذة والعمداء وصرنا نعرف الأوضاع العربية ونتكلم في الفكرة العربية وأحياناً نعرف بالفنون الموجودة في كل بلد والأزياء والمسرحيات ...الخ.
س ـ بأي لغة قرأتم الفلسفة في مصر؟
ج ـ في مصر، اللغة السائدة هي العربية، أما المراجع ففي اللغة الإنكليزية، لم ترونا المراجع العربية إلا في مجال الفلسفة الإسلامية وما حولها، وباعتبار أني أتقن اللغة الفرنسية، كنت الجأ دوماً إلى الكتب الأجنبية وخاصة الفرنسية.
س ـ أي فلسفة لفتتك في تلك الآونة؟
ج ـ الفلسفة التي بدأت أحبها وتابعتها وقمت بنشاط فكري فيها هي فلسفة برغسون الذي كان في ذلك الحين شائعاً وذائعاً في العالم، وكان فيلسوف ما بين الحربين العالميتين، مع أن سمعته الكبيرة جداً عادت وانطفأت. في مرحلة الشباب بشكل خاص كان برغسون يغرينا، لأنه بالإضافة إلى عمقه الفلسفي لديه ذهن ميتافيزيقي متفتح وهو ذو آفاق، وأيضاً عنده أسلوب أدبي وحرارة أدبية في الكتابة، وهذا أغرانا وجعلنا نتعشق برغسون، وكنت في ذلك الحين مع زميل لي هو المرحوم الدكتور سامي الدروبي وكان سفير سورية في مصر والذي ترجم دستويفسكي، بدأنا الترجمة معاً سنة 1943 وعمري آنذاك 19 سنة. ترجمنا أولاً كتاب «منبعا الأخلاق والدين» لبرغسون. ترجمة أعجب بها الكثيرون، وحتى اليوم لا يصدق الكثيرون أن هذا الكتاب مترجم، لجمال لغته وغير ذلك. رحنا ندور من ناشر إلى آخر ثم تعرفنا إلى مكتبة قبلت أن تنشر لنا بدون أجر وبورق سيئ. رغم ذلك فقد فرحنا بنشر الكتاب. بعده تابعنا نشر كتابات برغسون. كان الكتاب الثاني «الضحك» الذي إذا قرأته اليوم ستلاحظ أيضاً أن أسلوبه فريد، فكثير من المجيدين للغة الفرنسية الذين قرؤوه قالوا أنه برغم أن أسلوب برغسون مجنح وشعري وجميل فإن النص العربي أكثر جمالاً من النص الفرنسي. كنا نكتب وروحنا مع الترجمة، لا نترجم حرفاً حرفاً بل نصب شعورنا في الترجمة. بعد إنهاء الترجمة جاءت مشكلة النشر. في هذه الأثناء أنشئت دار الكاتب المصري في مصر، وكانت لا تنشر إلا للكتاب المشهورين، وحاولنا نتنطح ونتقدم لهذه الدار. ذهبنا إلى المدير التجاري للدار، فلم يأبه بنا حين رأى سننا ولم يكترث، لكن أحد أساتذتنا رأى الترجمة وأعجب بها وهو يعرف طه حسين الذي كان مستشاراً ثقافياً للدار. قدم الترجمة إليه فأعجب بها طه حسين كثيراً وأرسل في طلبنا فوراً لمقابلتنا. حين ذهبنا والتقيناه طلب المدير ووبخه لرفضه طلبنا وبهدله وقال له: من يحكم في هذه الدار أنا أم أنت، كيف ترفض هذا الكتاب ومن أين لك العلم؟ والتفت إلينا، أيضاً بشيء من الحدة والقوة قائلاً: أعلمكم منذ الآن، هذا الكتاب سينشر حالاً، وأي شيء في المستقبل تترجمونه أ تكتبونه لا أسمح لكما بأن تنشراه إلا في هذه الدار. بعد ذلك نشرنا كتباً أخرى لبرغسون. ثم بدأت الوجودية تظهر في مصر كان أستاذنا عبد الرحمن بدوي مهتماً بها ويعد رسالة عن الزمان الوجودي. كان معنى بهوسرل وهايدغر والوجوديين الألمان. أيضاً تابعنا سارتر والوجودية الفرنسية والدنماركية. ونظراً لتفوقنا في الدراسة، وتبعاً لتقليد متبع في جامعات مصر، يقضي بأن الطلاب الذين يحصلون على درجة الامتياز بعد السنة الثانية يقومون في السنتين الثالثة والرابعة بدراسات إضافية ويختارون لغة من اللغات القديمة أو من اللغات الحية. اخترت الألمانية ثم اخترت دراسات أخرى. وكنت أتمنى أن أتطور أكثر في اللغة الألمانية لكن مع الأسف، نظراً لقلة شيوعها في بلادنا، لم يكن لدي مجال بعد عودتي لتقويتها والحفاظ عليها، وقد قرأت لغوته بالألمانية لكني الآن بت ضعيفاً في هذه اللغة. بعد عودتي إلى سورية عينت أستاذاً للفلسفة في ثانوية حمص عام 47 ثم نقلت إلى دمشق عام 1948، وكانت الجامعة بكل كلياتها: الإنسانيات والعلوم والمعهد العالي للمعلمين قد أنشئت حديثاً وهي من ثم بحاجة إلى كوادر وأساتذة، فكان يتم اختيار النابهين من بين الأساتذة للتعليم في الجامعة. وكنت من بين من اختيروا لذلك. فعلمت في كلية التربية التي كانت تسمى آنذاك المعهد العالي للمعلمين، ودرست أولاً بصورة خاصة تاريخ التربية ثم سائر المواد. وتابعت دراستي في الجامعة. طموحي في ذلك الوقت كان السفر غلى فرنسا والحصول على الدكتوراه، فذهبت إلى ساطع الحصري في فندق أوريان بالاس كما أتذكر، وكان في ذلك الحين مستشاراً لوزارة المعارف السورية وقلت له: لو كنت مصرياً لكنت الآن موفداً للدراسة، لكن حسب النظام السوري لا أستطيع الحصول على المنحة مع الأسف. فأنا الأول في كلية الآداب في قسم الفلسفة والأوائل يوفدون حالاً حسب القوانين المصرية. أردت منه أن يساعدني في الحصول على منحة للدكتوراه، فقال لي الأيام معك وسيأتي يوم تسافر فيه حتماً لإعداد الدكتوراه ولكن لابأس من أن تبدأ هنا وتكتسب بعض الخبرة، ومازلت صغيراً، وقد طمأنني إلى حد ما. تابعت التدريس في الجامعة ولكن نتيجة ملابسات مختلفة لا أريد أن أتكلم عنها تم أخيراً إيفادنا مع المرحوم سامي الدروبي الذي ذكرت اسمه ومع صديق آخر هو حافظ الجمالي، الذي أصبح وزيراً للتربية في سورية، إلى فرنسا لإعداد الدكتوراه وذلك في أواخر عام 1949 في آخر الحرب التي كانت آثارها لاتزال بادية. أوفدت لإعداد الدكتوراه في التربية بحكم تدريسي في الجامعة.
س ـ هل تكون جو عربي في فرنسا من مثقفين عروبيين؟
ج ـ عندما كنا في فرنسا حصل نوع من التلاقح والتثاقف بيننا وبين أبناء المغرب العربي الذي كان عدد كبير منهم في فرنسا وأصبح لهم في ما بعد شأن مهم. هؤلاء تلقفوا إلى حد كبير الفكرة القومية عن طريقنا. ومع أنهم كانوا مقتنعين بذلك، إلا أنهم لم يكونوا يستطيعون أن يفصلوا الفكرة العربية عن الإسلام. نحن لا نقول بفصل الإسلام عن العروبة، لكن ليس بالمعنى الذي يفهمه الجزائريون. فالجزائري يعتبر المسلم والعربي شيئاً واحداً، بينما نحن نفهم أن الفكرة القومية العربية شيء آخر، لكن هناك صلة عضوية بين العروبة والإسلام. فالإسلام هو تراث بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين وهو تراث ودين بالنسبة للمسلمين، ولكن نحن نعمل من أجل كيان قومي لا من أجل كيان ديني. لذلك كنا نجد عنتاً في شرح هذا المفهوم مع المغاربة. ثم كان منهم بعد ذلك قادة في الفكر القومي العربي خاصة في تونس والمغرب وحتى في ليبيا. إذاً أتيح لنا أن نلتقي ونتصل بمجموعة من أبناء المغرب، أما مع أبناء المشرق فلم تكن هناك اتصالات ذات بال في فرنسا، لأنهم كانوا أفراداً قلائل، وليس هناك جاليات كبيرة منهم، بينما كان للمغاربة جالية كبيرة ولهم نواد وكنا نلقي عندهم محاضرات.
الوظائف التي شغلها
- أستاذ للفلسفة بثانويتي حمص ودمشق (1964-1948).
- أستاذ بكلية التربية بجامعة دمشق (منذ عام 1948 إلى عام 1966).
- أستاذ كرسي أصول التربية ورئيس قسم أصول التربية بجامعة دمشق (من 1/12/1960-28/2/1966).
- مدير للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإرشاد القومي بسورية (1959-1960).
- وزير للإعلام في الجمهورية العربية السورية (1962).
- وزير للإعلام في الجمهورية العربية السورية (1964).
- وزير للتربية في الجمهورية العربية السورية (1966).
- أستاذ التخطيط التربوي بالمركز الإقليمي لتخطيط التربية وإدارتها في البلاد العربية، بيروت (من آب 1962- نيسان 1972).
- أستاذ بكلية التربية بالجامعة اللبنانية (1974-1975).
- خبير التخطيط التربوي بالمركز الديمغرافي بالقاهرة (التابعة لهيئة الأمم المتحدة)، عام 1973.
- مدير مشروع اليونسكو لتطوير التربية في سلطنة عمان (1975-1976).
- ممثل اليونكسو ورئيس بعثتها في دول غربي أفريقيا (نيجيريا، بينين، غانا) من أيلول 1976 إلى تشرين الأول 1978.
- رئيس قسم مشروعات التربوي في البلاد العربية وأوربا بمقر اليونسكو بباريس (تشرين الأول 1978- أيلول 1985).
- عضو لجنة تقويم النظام التربوي في دولة الكويت (تشرين الأول 1985- تشرين الأول 1987).
- عضو مراسل بمجمع اللغة العربية بدمشق (بدءاً من عام 1992).
- عضو في مجلس أمناء «مركز دراسات الوحدة العربية بيروت» منذ عام 1974 حتى وفاته.
مؤلفاته
أهم مؤلفاته التربوية باللغة العربية
1- التخطيط التربوي، أصوله وأساليبه الفنية في البلاد العربية، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة التاسعة، تموز 1999.
2- التربية التجريبية والبحث التربوي، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة، شباط 1988.
3- التربية عبر التاريخ، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة السابعة، كانون الثاني 1997.
4- التربية العامة (مترجم عن أوبير) بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثامنة، كانون الثاني، 1996.
5- التنبؤ بالحاجات التربوية تحقيقاً لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية (مترجم عن باريس)، بيوت المركز الإقليمي لتخطيط التربية وإدارتها في البلاد العربية، 1964.
6- الثورة التكنولوجية في التربي العربية، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، تشرين الأول 1981.
7- الجمود والتجديد في التربية المدرسية (مترجم عن آفانزيني)، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية، تموز 1995.
8- التربية في البلاد العربية، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة السادسة، آب 1998.
9- التربية والعمل العربي المشترك، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، آب 1988.
10- التربية وتنمية الإنسان في الوطن العربي، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية، تشرين الأول 1997.
11- نحو فلسفة تربوية عربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، آذار 2000.
12- المدارس الحديثة (مترجم عن فولكييه مع آخرين) عدد خاص من مجلة المعلم العربي الصادرة عن وزارة التربية بدمشق، 1953.
13- بحث مقارن عن الاتجاهات السائدة في الواقع التربوي في البلاد العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 1993.
14- مراجعة استراتيجية لتطوير التربية العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 1995.
15- الاستراتيجية العربية للتربية في المرحلة السابقة على التعليم الابتدائي (مرحلة رياض الأطفال)، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 1966.
16- الآفاق المستقبلية للتربية في البلاد العربية. بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، عام 2000.
أهم مؤلفاته القومية والفكرية
1- دروب القومية العربية، بيروت، دار الآداب، 1958.
2- التربية القومية، بيروت، دار الآداب، 1959.
3- القومية والإنسانية، بيروت، دار الآداب، الطبعة الأولى، حزيران 1957، الطبعة الثالثة حزيران 1960.
4- الاشتراكية والديمقراطية، بيروت، دار الآداب، 1961.
5- الجيل العربي الجديد، بيروت، دار العلم للملايين، 1961.
6- الوطن العربي والثورة، بيروت، دار الآداب، 1963.
7- التخطيط الاشتراكي، دمشق، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 1965.
8- في سبيل ثقافة عربية ذاتية، بيروت، دار الآداب، 1983.
9- منبعا الأخلاق والدين (مترجم عن برغسون بالاشتراك مع سامي الدروبي)، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية، 1984.
10- الضحك (مترجم عن برغسون بالاشتراك مع سامي الدروبي)، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، 1985.
11- القومية العربية والنظام العالمي الجديد، دار الآداب، بيروت، 1994.
12- إسرائيل وهويتها الممزقة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1996.
13- دور التربية والثقافة في بناء حضارة إنسانية جديدة، دار الطليعة، بيروت، أيار 1998.
14- نكبة فلسطين عام 1948: أصولها أسبابها وآثارها السياسية والفكرية والأدبية في الحياة العربية، دار الطليعة بيروت، تشرين الثاني 1998.
15- صراع اليهودية مع القومية الصهيونية، دار الطليعة، بيروت، كانون الثاني 2000.
16- العرب والعالم وحوار الحضارات، دار طلاس، دمشق، 2002.
17- عبد الله عبد الدائم: الأعمال القومية (1957-1965) المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2002.
بعض مؤلفاته المدرسية
1- الموجز في علم النفس (للصف الثاني عشر) بالاشتراك مع سامي الدروبي، مطبوعات وزارة التربية، دمشق، 1950.
2- علم الاجتماع (بالاشتراك مع حافظ الجمالي)، مطبوعات وزارة التربية، دمشق، 1950.
3- المجتمع ومشكلاته (بالاشتراك مع حافظ الجمالي وأديب لجمي)، مؤسسة الكتب المدرسية، دمشق، 1959.
مؤلفاته بالفرنسية
-L’orientation scolaire dans L’Enseignement secondaiere (Presses Universitaires de Damas), 1954.
-L’Oniromancie Arabe (Presses universitaires de Damas), 1958.
مقالات وبحوث متنوعة
له بحوث ومقالات في الكثير من المجلات العربية والأجنبية (ولاسيما الآداب البيروتية، ومجلة العربي الكويتية، وصحيفة التخطيط التربوي التي أصدرها المركز الإقليمي لتخطيط التربية وإدارتها ببيروت والتي عمل رئيساً لتحريرها خلال عشرة أعوام، ومجلة (شؤون عربية) الصادرة عن دامعة الدول العربية، ومجلة الثقافة العالمية الكويتية، ومجلة المستقبل العربي التي يصدرها مركز دراسات الوحدة العربي ببيروت ...الخ) بالإضافة إلى البحوث والدراسات التي قدمها للعديد من الندوات والمؤتمرات العربية والدولية، وبالإضافة إلى المحاضرات الكثيرة التي ألقاها في العديد من البلدان العربية والأجنبية ويناهز إنتاجه المبعثر هذا ثلاثمئة دراسة وبحث ومحاضرة ومقال وندوة وسواها.
معرفته باللغات الأجنبية
كان الدكتور عبد الله عبد الدائم يتمتع بقدرة كبيرة على تعلم واستيعاب اللغات، ولم يكن الأمر يقتصر على مجرد إجادة اللغة، بل اتسع ليشمل قدرته على التأليف فيها في مواضيع معقدة، ناهيك عن ترجمة عدد من أمهات الكتب الفكرية والفلسفية إلى اللغة العربية، ويمكن إدراك ذلك من قائمة اللغات التي كان يجيدها حيث نجد:
- يجيد الفرنسية.
- يحسن الإنكليزية.
- لديه إلمام بالألمانية.
- لديه إلمام باللاتينية.
نشاطاته والجوائز التي حصل عليها
لم يقتصر عمل الدكتور عبد الله عبد الدائم على الأدوار المتعددة – الفكرية والثقافية والسياسية والعلمية والتربوية – التي كان يقوم بها، بصفته وزيراً مرات عدة وأستاذاً جامعياً يعد مرجعاً في مجال اختصاصه وكذلك بوصفه مفكراً قومياً أسهم بمؤلفاته وكتبه في وضع ملامح الفكر القومي العربي، إذ لم يثنه كل ذلك عن المساهمة في أي نشاط يجد فيه منفعة وأهمية لقضيته الفكرية والقومية ومن ذلك:
- المشاركة في معظم المؤتمرات والثقافة العربية.
- المشاركة في معظم المؤتمرات التربوية العالمية، ولاسيما المؤتمرات الخاصة بالتخطيط التربوي.
- المشاركة في وضع أسس السياسة التعليمية والتخطيط التربوي في بعض البلدان العربية.
- الإسهام في تقويم النظام التربوي بدولة الكويت.
- الإسهام في مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت (عضو مجلس الأمناء).
- المشاركة في كثير من نشاطات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
- المشاركة في العديد من مؤتمرات منظمة اليونسكو وندواتها وحلقاتها الدولية والعربية.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات الفكرية الهامة، ولاسيما تلك التي تنعقد في البلاد العربية.
الجوائز التي حصل عليها
يحمل الدكتور عبد الله عبد الدائم عدداً من الأوسمة التي استحقها من خلال عمله الكبير وهي:
- وسام الاستحقاق من الجمهورية العربية السورية.
- وسام الاستحقاق من الجمهورية المصرية.
- وسام النهضة من المملكة الأردنية الهاشمية.
- جائزة سلطان العويس الثقافية، في ميدان الدراسات الإنسانية والمستقبلية، لدورة عامي 1992-1993.
حول فكر عبد الله عبد الدائم
تميز فكر الدكتور عبد الله عبد الدائم بسمة الموسوعية المبنية على اطلاع واسع على معارف متنوعة ومتعددة، مكنته من أن ينظر إلى واقع الأمة العربية – شغله الشاغل – بمنظار المتكمن من قاعدته المعرفية، والقادر على تفكيك مشاكلها بأدوات علمية صرفة لا تعرف للمحاباة أو خداع الذات سبيلاً، ولا غرو أن هذه النظرة التي ميزت كتبه ومحاضراته ونظرياته في تطوير الواقع العربي ومحاولة إيجاد منهج علمي للخروج من مأزق أزماته إلى رحاب التطور التدريجي باتجاه أمة عربية قادرة بأدواتها الخاصة على إعادة بناء دورها الحضاري في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، كل ذلك وفق رؤية فكرية شفافة تعي واقعها وتستشرف آفاق مستقبلها، قد جعلت من الدكتور عبد الله عبد الدائم واحداً من مفكري القومية العربية الأكثر مقاربة وملامسة لعصرنا هذا، والأكثر قدرة على ممارسة دور فكري وتربوي سيبقى مشهوداً له على مدى عقود.
وفي محاولة لإلقاء نظرة على فكره بلغته هو، نجد هذا الحوار الممتع الذي أجراه الأستاذ سمر روحي الفيصل مع المفكر الكبير لصالح جريدة الأسبوع الأدبي التي يصدرها اتحاد الكتاب العرب بدمشق، في عدد خاص عن عبد الله عبد الدائم، وذلك بتاريخ 3 آذار 1988، وتظهر في هذا الحوار الأسس الموضوعية والفكرية التي بنى عليها الدكتور عبد الدائم منهجه القومي التقدمي الواضح:
الدكتور عبد الله عبد الدائم واحد من أبرز التربويين العرب، وأكثرهم صلة بالمنظمات القومية العربية والمنظمات الدولية العاملة في حقل التربية. وهو ـ قبل ذلك وبعده ـ مفكر ذو توجه قومي أصيل، وباحث تتصف مؤلفاته بالأصالة والدقة، ومترجم تمكن ورفيقه الدكتور سامي الدروبي ـ رحمه الله ـ في منتصف السبعينات من ترجمة كتابي هنري برغسون (الضحك، ومنبعا الأخلاق والدين) بأسلوب عربي رائق بدلاً من أسلوب صاحبهما الصعب، مما ساعد القراء العرب على تعرف هذا الفيلسوف وفهمه. وهذا الحوار محاولة للاستفادة من تعدد جوانب الدكتور عبد الدائم، كما أنه سعي إلى التذكير بقضايا رئيسة في التربية العربية، وهو ـ على إيجازه ـ كاف لمن يجيد القراءة بين السطور.
- أستاذنا الكريم، تؤرقني قضية القيم، وأكاد أقلق للتناقض الذي يتحلى به سلوك الإنسان العربي، المتعلم خاصة، وهذا الأمر يدفعني إلى التساؤل عما إذا كانت القيم التي تطرحها التربية العربي هامشية، لا تمس القيم الإيجابية الأصيلة التي تبني شخصية الإنسان العربي بناء سليماً، كالحرية واحترام الرأي والاعتراف بالآخر، بدلاً من قيم التصفيق والتهليل والرضوخ والصمت، كيف ينظر الدكتور عبد الله إلى هذا الأمر؟
* الموضوع شائك فعلاً ومتسع الأبعاد، ولعله موضوع الساعة، ليس في الوطن العربي وحسب وإنما في العالم كله. فأزمة القيم غدت في عالمنا المعاصر أزمة تثير القلق والتساؤل، وتحمل المنظرين والمفكرين على التأمل ملياً في الواقع العالمي والعربي لاستخلاص الوسائل الناجعة القادرة فعلاً على تجاوز هذه الأزمة. أما جوابي عن هذه المشكلة فيمكن أن ألخصه في أبعاد ثلاثة:
الأول: إننا لآ نستطيع أن نبحث في أزمة القيم في بلادنا إلا إذا بحثنا، في الوقت نفسه، في أزمة القيم في العالم.
والثاني: إن التربية وحدها، على شأوها وقيمتها، ليست العصا السحرية التي تستطيع أن تعالج أزمة القيم هذه. ولابد من التفاعل والتكامل بين جوانب الحياة المختلفة ـ اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو تربوية ـ من أجل معالجة هذه المسألة.
والثالث: إن معالجة أزمة القيم في نظرنا شرط لازب لأي مشروع حضاري نريد أن نبنيه في الوطن العربي، وإن التقدم في أي أمة لا يمكن أن يبلغ مداه إلا إذا انضافت إلى الجهود التي تعنى بتكوين المهاد العلمي والتكنولوجي والأرضية الاقتصادية الضرورية، جهود متكاملة معها، قوامها التكوين الخلقي والقومي السليم للمواطنين، وتعبئة إرادة العمل المشترك بينهم، وتحريك مشاعر التضامن والتعاون من أجل بناء مصير مشترك.
ودون أن أدخل في تفصيل الحديث عن كل بعد من هذه الأبعاد الثلاثة، إذ يحتاج مثل هذا التفصيل إلى أسفار برأسها، أقول بإيجاز فيما يتصل بالموقف اللازم لمعالجة مشكلة تردي القيم في الوطن العربي:
أولاً: لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن التغيرات الضخمة التي حدثت في العصر، وعلى رأسها التغيرات العلمية والتكنولوجية التي قلبت بنية المجتمعات رأساً على عقب، واقع يملي علينا أن نبحث في نظام للقيم يأخذ بعين الاعتبار مستلزمات هذه التغيرات وانعكاساتها.
ثانياً: هنالك في تاريخ الإنسانية تجارب ناجحة جديرة بأن تتأملها حين نبحث مسألة القيم في وطننا، من مثل التجربة اليابانية منذ أيام الإمبراطور الشهير ميجي عام 1868. هذه التجربة اليابانية تشير إلى حقيقة، هي أن التقدم السريع في أي بلد من البلدان لا يمكن أن يتم إلا إذا توافر شرطان متلازمان:
أولهما تمثل التجربة العلمية والتكنولوجية الحديثة وتبنيها، والعزم الجماعي الملتزم على السير فيها، وتوفير كتلة ضخمة من العلماء والباحثين القادرين على تحقيق الثورة التكنولوجية والعلمية المنشودة.
وثانيهما الدمج العضوي، لا مجرد الإضافة والضم، بين القيم التي يفرضها التقدم العلمي والتكنولوجي، من مثل قيم النجع والفاعلية والديناميكية والمثابرة والمبادرة وسوى ذلك، وبين جذور هذه القيم في تراث الأمة. ولقد استطاعت اليابان حقاً منذ ذلك العصر، عصر ميجي، حتى اليوم، أن تحقق هذا الدمج العضوي، وأن تجعل من الارتباط بالتراث الياباني وبالقيم الروحية اليابانية المتمثلة في التعاليم البوذية والكونفوشيوسية وفي التقاليد العريقة الشائعة في المجتمع الياباني ولاسيما في المجتمع الياباني الزراعي منطلقاً ومتكأ، وأن تحيل مثل هذه القيم التاريخية إلى تراث حتى يمنح اليابانيين طاقة جديدة في سيرهم نحو نشر التقدم العلمي والتكنولوجي. والأمة العربية مدعوة في نظرنا إلى مثل هذه التجربة. إنها مدعوة أولاً وقبل كل شيء إلى أن تجعل من قيمها التراثية قيماً حية ترتبط بقيم العصر وتغدو محركاً فعالاً لعملية التقدم.
ثالثاً: لابد أن تلعب التربية دورها في تجاوز أزمة القيم هذه إلى جانب الميادين الأخرى. وثمة أمور عديدة يمكن أن تقال فيما يتصل بوسائل نهوض التربية بمثل هذا الدور لا مجال للتريث عندها جميعها، وحسبنا أن نقول: لعل رأس هذه الوسائل إشاعة روح العمل المشترك والتعاون والتضامن في الحياة المدرسية من جانب، والعمل على تفتيح القدرات والطاقات الخلاقة لدى الطلاب منذ نعومة الأظفار وفي مراحل الدراسة المختلفة من جانب آخر.
رابعاً: لابد في معالجة أزمة القيم من معالجة موازية للمشكلات العديدة القائمة في الوطن العربي، وعلى رأسها المشكلات الاقتصادية والمشكلات الإدارية والمشكلات المتصلة بالديمقراطية والحرية وسوى ذلك.
- كنت في السبعينات، قد قرأت كتابك «التربية في البلاد العربية، حاضرها ومشكلاتها ومستقبلها». وأود أن أسألك عما إذا كانت المشكلات التي تحدثت عنها في هذا الكتاب قد لقيت الحلول الملائمة لها، أو أن عددها زاد عما ذكرت، أود أن أشير إلى أن المستقبل الذي صيغ في أهداف محددة لم يتحقق منه شيء بعد عقد ونصف العقد على صدور كتابك؟ وأين الخلل؟
* إن أي اتجاه من الاتجاهات التي نريد أن نكونها لدى الأطفال والطلاب عن طريق التربية، سواء اتصل بالقيم أو سواها، لابد في نهاية الأمر أن ينبغ من فلسفة تربوية واضحة متكاملة تنعكس في شتى مقومات العمل التربوي، سواء اتصلت هذه المقومات بالمناهج أو بطرائق التدريس أو بإعداد المعلم أو بالتقويم المدرسي والامتحانات أو بالنشاطات اللاصفية أو بالإدارة التربوية أو بالتخطيط التربوي أو بغير ذلك.
والمسيرة من أجل تجويد أن مقوم من هذه المقومات التربوية تظل مسيرة عمياء ضالة إذا لم تهد خطاها فلسفة تربوية تحدد لأهداف الكبرى والغايات النهائية للتربية. أن تحدد في نهاية الأمر أي إنسان نريد أن نكون عن طريق نظامنا التربوي.
ومن المؤسف أن مثل هذه الفلسفة التربوية العربية الواضحة ماتزال ضالة النظم التربوية في الوطن العربي. ورغم القرزمات الأولية التي تمت في هذا المجال لا نسرف إن قلنا إن الأهداف التربوية في الوطن العربي ماتزال تتصف بالغموض وبعدم التحديد وبالتناقض في بعض الأحيان يضاف إلى هذا كله أن الأهداف المرسومة والتي نجدها مكتوبة لدى كثير من النظم التربوية في البلاد العربية قلما تتبعها جهود جادة من أجل ترجمتها إلى أهداف سلوكية ومناهج وطرائق، ومن أجل الربط العضوي الوثيق بينها وبين السياسات والاستراتيجيات والخطط التربوية. على أننا حين ننادي بأهمية توضيح الفلسفة التربوية في البلاد العربية وبأهمية ترجمتها إلى واقع حي في مسيرة العملية التربوية، ينبغي ألا ننسى أن مثل هذه الفلسفة التربوية العربية لا يمكن أن تتوافر لها الشروط الضرورية والمنطلقات السليمة إلا إذا كانت بدورها انعكاساً لفلسفة تعلو عليها، هي الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أي الفلسفة الشاملة للبلد الذي تنتمي إليه.
ومثل هذه الفلسفة الشاملة التي تتضح من خلالها سائر أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية أي بلد من البلدان العربية ماتزال ـ أيضاً ـ متعثرة، وما يزال التفاوت في شأنها قائماً بين البلدان العربية المختلفة.
- تضع كل دولة من الدول العربية لنفسها أهدافاً عامة للتربية، فإذا نظرنا في الوطن العربي نظرة كلية خيل إلينا أن التربية السائدة فيه تتجه إلى الفردية وتعمل على ترسيخها تبعاً لتباين الأهداف وتناقضها بين الأقطار العربية. أين العمل التربوي الذي يرسخ الاتجاه القومي إذن؟ وقد ذكرني كتابك (تاريخ التربية) الذي درست فيه التربية عن الغزالي وابن خلدون، بسؤال آخر هو: هل تستطيع تربيتنا الحديثة الاستفادة من التراث التربوي العربي؟
* ما قلناه قبل قليل ينقلنا إلى سؤالك المتصل بدور العمل العربي المشترك في بناء تربية عربية موحدة في اتجاهاتها الأساسية. والحق أن الجهود العربية في طريق التعاون التربوي جهود كبيرة وقديمة، ترجع على أقل تقدير إلى المؤتمر التربوي الأول الذي عقدته جامعة الدول العربية الناشئة عام 1945. وقد تابعت هذه الجهود، كما نعلم مؤسسات تربوية عربية مشتركة، على رأسها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد نقابات المعلمين العرب وسواها.
كما أن جهوداً أخرى موازية تمت في طريق التعاون العربي في مجال التربية لم تنطلق من المنظمات العربية المشتركة، وإنما انطلقت من التبادل الثنائي والتعاون المباشر بين الأقطار العربية المختلفة، وما تبعه من تبادل المعلمين والطلاب والمناهج والكتب والبحوث وسوى ذلك.
غير أن هذه الجهود كلها، وهي جهودكما ترى عديدة وقديمة العهد، لم تؤت كامل الثمرات المرجوة منها عبر هذه المسيرة الطويلة وخلال تلك الحقبة الممتدة. يتجلى ذلك في قصير التربية في الوطن العربي ككل عن بلوغ المستوى الكمي المطلوب، وفي تقصيها بوجه خاص عن بلوغ المستوى الكيفي النوعي اللازم. أما الكم فالحديث عنه يطولن وحسبنا أن نذكر الذين يرتادون رياض الأطفال في جملة الوطن العربي ممن هم في سن هذه المرحلة لا يجاوزون عشرة بالمائة، وأن نسبة الذين يرتادون التعليم الابتدائي إلى فئة السن المقابلة لهذا التعليم لا يجاوزون ثماني بالمائة في جملة الوطن العربي، وأن نسبة الذين يختلفون إلى التعليم الثانوي لا يجاوزون أربعين بالمائة من فئة السن المقابلة، وأن الذين يلتحقون بالتعليم العالي لا يجاوزن اثني عشر بالمئة من فئة السن المقابلة. هذا فضلاً عن نسبة الأمية المرتفعة حتى اليوم. ومما يؤسف له أن تشير الإسقاطات المتصلة أعداد الطلاب المتوقعة في الوطن العربي عام ألفين إلى أن بعض البلدان العربية كاليمن الشمالي والسودان وموريتانيا وجيبوتي والصومال سوف تعجز عجزاً واضحاً عن تعميم التعليم الابتدائي حتى في نهاية هذا القرن وبدايات القرن المقبل. أما القصور النوعي الكيفي في التربية العربية فهو أدهى وأمر، لاسيما أن التطور الكمي السريع الذي حث في معظم البلدان العربية في مراحل التعليم المختلفة ثم يرافقه تطور مماثل في هياكل العليم وفي الإدارة التربوية والمدرسية، وفي المناهج وإعداد المعلمين وسوى تلك م عنصر العملية التربوية.
على أن الدرس الأول الأساسي الذي تقدمه لنا للتجربة التربوية في البلد العربية فهو أن أي عمل قطري محض منغلق، على نفسه في مجال التربية عمل مخفق، وأن التربية في أي بلد عربي مهما تعد إمكاناته البشرية أو المالية سوف تقصر عند مداها إذا لم يقم تعاون عربي حق، ولاسيما في المجالات العلمي والتكنولوجي، ومجال البحث العلمي، ومجال تطوير الدراسات العليا بوجه خاص في التعليم العالي، ومجال التعليم التقني والمهني وربد مخرجات التربية بحاجات العمالة والتنمية الشاملة. وكما دلت الدراسات التي قام بها الاقتصاديون العرب والأجانب على أن التجربة القطرية في البلاد العربية مجال الاقتصاد تجربة مخفقة، فقد دلت الدراسات الكثيرة التي قام بها المربون العرب على أن التجربة القطرية في ميدان التربية، شأنها في أي ميدان آخر، تجربة لابد أن تكون عاجزة.
وقد فصلت الحديث عن ذلك كله في مناسبات عديدة ولاسيما في كتابي الذي أشرت إليه: «التربية في البلاد العربية» الذي صدرت طبعته الثانية المزيدة المنقحة عام 1982.
- يدفعني كتابك «الثورة التكنولوجية في التربية» إلى سؤالك عن موقع تربيتنا الحديثة من العصر؟ أين نقف في هذا العصر الموار بالحركة؟
* الإشارة السابقة إلى كتابي «التربية في البلاد العربية» تنقلنا إلى تساؤلك الذي تستمده من كتابي «الثورة التكنولوجية في التربية العربية». وقد طرحت في هذا الصدد سؤالاً في محله، هو علاقة تربيتنا بالعصر الحديث. والجواب عن هذا السؤال يلتهم الصفحات الكثيرة أيضاً، ولكن الذي لابد من قوله هو أننا مانزال حتى اليوم في معظم أنظمتنا التربوية في البلاد العربية نعمل ونجهد وكأن شيئاً لم يكن.
كأن الثورة العلمية التكنولوجية في ميدان التربية لا تعنينا. مانزال بتعبير آخر، نلجأ إلى الوسائل التقليدية في التربية، وقوامها معلم وسبورة وعند واسع غالباً من الطلاب، في حين أن ثمة ثورة تكنولوجية في التربية انتشرت وذاعت في العالم منذ عقود عديدة، وفي حين أننا أحوج ما نكون لاصطناع هذه الثورة التكنولوجية التربوية، لأسباب عديدة على رأسها مواجهة أزمة التزايد الكمي، والتفجر العددي السريع في أعداد الطلاب. هذه الأزمة ينبغي أن تدعونا كما دعت سوانا إلى التفكير في بنى تربوية جديدة وطرائق تربوية حديثة من شأنها أن تعلم أكبر عدد ممكن من الطلاب تعليماً أفضل بنفس الإمكانات المادية والبشرية المتاحة. وهذا يدعونا إلى التنبيه إلى أمر قد يغفله بعض المتحدثين عن تكنولوجيا التربية، هو أن تكنولوجيا التربية لا تعني مجرد استخدام الآلات والأدوات، ولا تعني مجرد إدخال الوسائل السمعية والبصرية إلى المدرسة على شأنها وقيمتها، ولا تعني حتى مجرد إدخال الحاسبات الآلية إلى الحياة المدرسية، بل تعني فوق هذا وقبل هذا إحداث تغييرات عقلانية علمية في بنية النظام المدرسي وفي مناهجه وإدارته والتخطيط له. وإلى جانب التكنولوجيا التي يمكن تسميتها آلية ينبغي أن يقر في ذهننا أن ثمة تكنولوجيا عقلية، بل ثمة تكنولوجيا خلقية.
- ما الهموم التي تؤرق الدكتور عبد الله عبد الدائم في هذه الأيام؟
* قد يكون في الجواب عن هذا السؤال عود على بدء. فالذي يؤرقني في التربية وسواها أزمة القيم من جانب، وضعف الارتباط بين النظام التربوي وحاجات سوق العمل من جانب آخر. وبين هذين الجانبين جذع مشترك. فالتربية التي لا تعنى بإعداد المتعلمين من أجل الإنتاج ومن أجل مهن يتطلبها التطور الحاضر والمستقبلي لسوق العمل تربية تؤدي في نهاية الأمر إلى تخريج مثقفين عاطلين، وكثيراً ما يكون هدفها تأجيل البطالة بضع سنوات، أو رفع البطالة من بطالة جاهلة إلى بطالة مثقفة. فمن قبيل المصادفة أنني استمعت بالأمس إلى أغنية فرنسية جاء فيها أن الإنسان في هذه الأيام لكي يكون عاطلاً ينبغي أن يحمل شهادة. وتخريج مثقفين عاطلين تربة خصبة لتوليد مشكلات نفسية واجتماعية خطيرة، ولإصابة القيم الخلقية والقومية إصابة تكاد تكون قاتلة.
والحق أن أكبر أزمة يواجهها العالم اليوم، نتيجة عوامل كثيرة على رأسها العامل الاقتصادي والأزمة الاقتصادية العالمية، هي أزمة الطلاق المتزايد بين مخرجات النظم التربوية وبين الحاجات الفعلية لسوق العمل. وهذه الأزمة في البلدان النامية وفي البلدان العربية أدهى وأمر. ومن هنا تقوم الجهود تترى من أجل إعادة النظر في هياكل التعليم ومحتوياته وبجه أخص في أنواع التعليم وفروعه وتخصصاته. كما تقوم جهود جادة للتزاوج في ميدان إعادة وتدريب القوى العاملة في شتى المجالات بين المؤسسات التربوية وبين المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والشركات وعالم العمل بوجه عام. كما تقوم جهود دائبة من أجل تحقيق أقصى حد من المرونة في بنية التعليم الثانوي ومناهجه وفروعه، وفي بنية التعليم العالي ومحتواه واختصاصاته بحيث يتم اللقاء بين ما تنتجه التربية وما تنتجه التربية وما تحتاج إليه عجلة التقدم ومستلزمات التطور والتجديد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لقد فات الزمن الذي كانت التربية تعتبر فيه أي تربية أداة من أدوات التقدم. ولرب تربية اليوم تسير في عكس أهداف التنمية وفي عكس أهداف التقدم. والتربية لا تكون توظيفاً مثمراً واستخداماً منتجاً للموارد البشرية إلا إذا وضعنا فيها سلفاً، في بناها وفي محتواها وفي إدارتها، الأهداف المؤدية إلى العمل والإنتاج، والقادرة على التنمية. ولابد أن نقول إن فتح أبواب التربية للجميع، لأكبر قدر ممكن تحقيقاً لديمقراطية التربية، يستلزم بالضرورة ألا نقدم تربية من نوع واحد للجميع.
وجملة القول في خاتمة المطاف إن همي وشاغلي تكوين نظام تربوي عربي قادر على تحقيق التنمية الشاملة السريعة والتقدم العلمي والتكنولوجي الجدير بالعصر، والبناء البشري الذي يمتلك القيم والاتجاهات والمواقف التي تفجر قدرات العطاء من أجل بناء مجتمع عربي متقدم، ومن أجل صياغة مشروع عربي قادر على توليد الوجود العربي الذي يواجه التحديات الكبرى.
كيف ينظر الدكتور عبد الله عبد الدائم إلى تجربته
في كلمة له كتقديم لموقع الإنترنت الذي يحمل اسمه، تحدث الدكتور عبد الله عبد الدائم ملخصاً تجربته الشخصية والفكرية الطويلة، إذ يقول:
تأملات فيما مضى
لا أغلو إذا قلت إن تجربتي الفكرية هي تجربة جيل. إنها تجربة جيل من لداتي وأقراني من المثقفين في البلاد العربية، حرصوا ـ عبر مسيرتهم ـ على تحقيق مطلبين متكاملين: أولهما التزود منذ ريعان الصبا ـ عن طريق الجهد الذاتي وبفضل عشقهم للمعرفة ونهمهم لارتياد شتى مجاليها ـ بالثقافة التي تتعانق فيها وتتكامل الدراية الواسعة العميقة بالتراث الثقافي والحضاري العربي-الإسلامي، مع التهام شتى عطاءات العلوم والآداب والفنون الغربية القديمة والحديثة. وثانيهما الغوص في هموم مجتمعهم وأمتهم العربية والبحث عن أسباب تخلفها، والعمل بالفكر والنضال من أجل تجاوز ذلك التخلف ومن أجل توليد كيان عربي موحد وحديث ومتكامل، يرفد بطائه الأمة العربية وسائر شعوب العالم.
ومع تقدم الزمن أخذت هذه الهموم الثقافية والقومية تزداد لدي نضجاً، وتتسع عطاء، وأخذت تحمل وتتئم وتولد شتى ضروب النتاج العلمي والفكري والقومي، في مختلف المجالات، وعلى صور وأشكال متعددة ولكنها متآخذة ينظمها عقد واحد، هو عقد العمل النظري والعملي من أجل بناء كيان عربي متقدم منيع يرقى ـ عن طريق تفتحه وعطائه ـ بالإنسانية جمعاء، كما يرتقي بذاته ويستخرج كامل إمكاناته عن طريق حواره مع عطاء سواه وتفاعله معه.
وهكذا أسهمت مع سائر لداتي من أبناء ذلك الجيل في عملية البناء هذه: بناء ثقافتي التي تمتد جذورها إلى التراث العربي- الإسلامي والتي يوقد نارها اتصالها الحي بثقافة العصر الحديث، ثم بناء تصوري المتكامل للكيان العربي المرجو، الكيان الموحد الحر العادل المتقدم.وقد تجلى إسهامي هذا في كتبي القومية بوجه خاص التي يجمع أهمها كتاب (الأعمال القومية 1957-1965)، وفي نضالي القومي الدائب منذ أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، كما تجلى في مؤلفاتي التربوية ـ على اختلاف موضوعاتها ـ التي تربط ربطاً وثيقاً بين تطوير الكيان العربي (تطويراً محوره التربية وبناء الإنسان، بوصفه محور أي تنمية حقة) وبين تحقيق الوجود القومي المتقدم (مادام التقدم في العلم والمعرفة صلب بناء الحياة القومية، ومادام العمل في إطار الوجود القومي المتكامل، هو الشرط اللازب للتقدم والحداثة في الوطن العربي).
وهكذا عنيت في مؤلفاتي التربوية، التي تهدف إلى بناء الإنسان العربي الموعود، عناية خاصة بالمشكلات التربوية الكبرى في البلاد العربية، وعلى رأسها: التخطيط التربوي ـ فلسفة التربية ـ تطوير نظم التربية في البلاد العربية ـ تطوير الاستراتيجيات التربوية العربية.
وقد كان من الطبيعي أن يرفد أمهات مؤلفات القومية والفكرية والثقافية والتربوية زاد واسع متصل من المحاضرات والمقالات والندوات والدراسات والأبحاث، فضلاً عما يسر لي من آفاق العمل الميداني في مجال التربية في البلاد العربية جميعها، بحكم عملي خلال نيف وخمس وعشرين سنة مع منظمة اليونسكو، مسهماً عن كثب في تطوير النظم والمشروعات التربوية العربية في شتى المجالات.
ومع ذلك أشعر اليوم، وأنا على أبواب الثمانين من عمري، أن ما قدمته الثقافة وللفكر القومي وللتربية لا يعدو أن يكون جزءاً يسيراً مما كنت أتمنى أن أقدمه. على أن مما يهون علي هذا الحرمان، شعوري ـ رغم مرور الزمن وتوالد الأحداث وتغير البلاد وما عليها ـ أن ما شرعته وغرسته في هذا المجال ت مجال الثقافة والفكر القومي والتربية ـ يحتفظ بكامل شأنه وشأوه، ويظل منطلقاً لأي خطوة صادقة على طريق بناء الحياة العربية الغنية القوية المتقدمة القادرة.
ويسعدني أن أهدي هذا العطاء إلى أساتذتي وإلى لداتي وأقراني من أبناء جيلي، وغلى الأجيال العربية الجديدة التي أرجو أنتحمل أمانة متابعته وإغنائه وتحديثه، وإلى رواد الفكر القومي الإنساني والفكر التربوي المجدد في الوطن العربي والعالم.
لزام علي أن أشيد في هذه الكلمة بالجو الحميم والعون الكبير الذي قدمته لي بصمت زوجي دعد المرادي، التي صحبتني في أعمالي كلها مشجعة ميسرة صبورة، وشكري موصول إلى أولادي وأحفادي الذين أرنو من خلالهم إلى مستقبل الجيل العربي الجديد وطموحاته وآماله.
عبد الله عبد الدائم
دمشق في 24/4/2003
وفاته
توفي الدكتور عبد الله عبد الدائم في العاشر من أيلول عام 2008، عن عمر يناهز 84 عاماً، إثر وعكة صحية ألمت به في باريس، وكان لوفاته وقع كبير على الأوساط الفكرية والثقافية في سورية والعالم العربي التي عهدته فارساً مجلياً في ميادين الفكر والثقافة، وفي تأسيس وصياغة الفكر القومي العربي الحديث. وقد ظهر ذلك جلياً في كلمات الوداع والتأبين التي تقاطرت من كل حدب وصوب تنعي المفكر القومي الكبير الذي مزج العلم بالعمل، وبقي يمارس عمله الفكري والتربوي الكبير حتى آخر لحظات حياته.
مركز دراسات الوحدة العربية يؤبن الدكتور عبد الله عبد الدائم
في وداع عبد الله عبد الدائم
أنسب تخليد لذكرى رحيل المفكر القومي التربوي العربي الكبير الدكتور عبد الله بعد الدائم (1924-2008) هو أن نستعيد تجربة جيل الرواد الكبار في الحركة القومية العربية الحديثة، الذين انغرسوا في الفكرة العربية بمقدار ما غرسوها في النفوس والعقول، وطوروها وتطوروا فيها. ولا نستعيد هذه التجربة لمجرد استعادتها بل لإعادة قراءتها واستئناف التفكير في أسئلتها التي ماتزال راهنة حتى الآن. لقد كان الراحل الكبير ينتمي بعمق إلى هذا الجيل الذي آمن بالفكرة القومية وذاد بالكلمة والموقف، بقدر ما رأى دوماً أن «تجربته الفكرية تجربة جيل» برمته. ويعني بعد عبد الدائم جيل الفكر في الحركة القومية العربية الحديثة، الذي انغرس فيها على حد تعبير الراحل الكبير «لا لقطف الورود بل لنزع الأشواك» التي تعيق وحدة العرب ونهضتهم وحداثتهم، ومن أجل أن يكون لهم «رأس» في هذا العالم.
لم يكن هذا الجيل الذي انتمى إليه عبد الدائم «جيلاً عابراً» في تاريخ الفكر العربي الحديث، وحركته القومية التي عملت من أجل الاستقلال والوحدة والنهضة والتقدم، بل جيل «أساتذة» و«معلمين» كبار اضطلعوا بمهام التأسيس ليس على صعيد الفكر القومي العربي فحسب، بل وعلى صعيد الفكر العربي الحديث أيضاً. ولقد انتسب الراحل الكبير إلى الحلقة الوسيطة الرائدة في هذا الجيل المنتج للأفكار والرؤى والأسئلة الكبرى الذي رأى في الفكرة العروبية فكرة الحداثة والنهضة والتحرر. لكنه تميز باختياره الحاسم للوجه التربوي والتنويري من الفكرة العروبية.
انغرس الراحل الكبير في الفكرة العربية على غرار انغراس ساطع الحصري فيها. كان يشبه أستاذه في تربيته العثمانية، وفي اختياره الواعي المستقل للفكرة العروبية. فلقد عبد الدائم تربية عثمانية صارمة من والده الذي كان قاضياً شرعياً، وسبق له أن كان «إمام طابور» في الحرب العالمية الأولى (1941-1918)، والذي كان يرى دوماً أن «القضاء» حسب العرف الإسلامي هو الذي يحقق العدالة بالنسبة إلى نظام العدالة الحديث الذي تخرج كليات الحقوق رجالاته. ولقد أخذ الابن عن أبيه تلقي المعارف العربية في أصولها، فكان متقناً تمام الإتقان لها، وأخذ عنه على مستوى السلوك استقامة القضاء، لكنه تبنى بشكل مبكر النظام التعليمي الحديث بوصفه يعبر عن مهارات وأخلاقيات في الوقت ذاته، هي مهارات حركة الحداثة وأخلاقياتها. وعبر في ذلك عبد الدائم المنغرس في معارف العرب وعلومهم عن حداثته وتنويريته المبكرة بالفعل.
لم يكن اختيار الراحل الكبير لمجال التربية والتربية القومية والتنوير متعارضاً لديه مع العمل، فلقد ترجم عبد الدائم الشاب إيمانه بالفكرة العربية عملياً بمشاركته في المؤتمر التأسيسي الأول لحزب «البعث العربي» في حديقة «لونابارك» في دمشق يوم 7/نيسان/أبريل/1946. ولقد كان بهذه الصفة أحد المؤسسين، غير أنه لم يؤد القسم الحزبي لمرة واحدة، مع أنه سيغدو ممثلاً «رسمياً» للحزب في أكثر من حكومة تمثل فيها الحزب في الستينات. ولقد مثل الحزب على كل حال في مرحلة «اقتلاع الأشواك» لا «قطف الورود». وكان عبد الدائم في ذلك متسقاُ تماماً مع بعض اتجاهات جيل المؤسسين الكبار. ويعني ذلك، من وجه ثان، أن انتماء عبد الدائم إلى الفكرة العربية وحركتها كان أعلى من شكل الانتماء الحزبي التقليدي.
في تدوينه الشخصي جداً لسيرته الذاتية، يسقط عبد الدائم تجربة توليه الوزارة من هذه السيرة، مع أنها تجربة تشمل جزءاً لا يتجزأ من حياته، وتمثل فوق ذلك تجربة شديدة الغني في فهم تعقيدات الحياة السياسية المباشرة للحركة القومية، وتمت على وجه الضبط في مرحة الانعطافات المصيرية. ولم يكن ذلك بسبب «قصر» التجربة، بل بسبب أنه اعتبر نفسه مفكراً تربوياً يسمو فوق السلطات كافة، والذي يرى السلطة مجرد وسيلة لهدف أسمى. نستطيع هنا أن نفهم عبد الدائم بعمق حيث يقول إننا أتينا إلى الحركة القومية «لا لقطف الورود بل لنزع الأشواك».
اعتبر عبد الدائم دوماً تجربته مع السلطة تجربة «عابرة» تماماً، إلى درجة أنه لم يكن يستذكرها إلا حين يتم تذكيره بها. ليس لمرارتها فحسب بل ولكونه يرى نفسه رجل تربية يعلو فوق التجارب، ويعمل في أسس الأمة وليس في مظاهر حركية عابرة أو انتقالية. فلقد كان في المحصلة الجوهرية وليس في مظاهر حركية عابرة أو انتقالية. فلقد كان في المحصلة الجوهرية رجل فكر وتربية يهب تأسيسه لما نطلق عليه اليوم «المجتمع المدني». لقد كان على وجه الضبط رجل التربية في العمل القومي.
مسيرة عبد الدائم الفكرية التي تبحث عن «الهيمنة» الفكرية بتعبير غرامشي مطور وليس عن «السيطرة». أي بواسطة قوة الفكرة وليس سلطويتها، وبقوة الاقتناع وليس الفرض. ومنذ مشاركته في المؤتمر التأسيسي الأول «لحزب البعث العربي»، عن شغل عبد الدائم بمسألة الفكرة وهيمنتها، ووجد كمالها بالنسبة إليه في التربية. لم يكن ذلك يعني أبداً أن الراحل الكبير كان يستخف بفكرة العلم، بدليل أنه وضع حياته في إطار العمل، ولكنه كان يقدر دوماً أن مجال عمله هو في التأسيس العميق: تأسيس التربية، أي أن شغفه الحقيقي العميق كان بـ «التربية» وليس بـ «السلطة».
كان عبد الدائم من جيل «المعلمين القوميين» الشغوفين بالفلسفة، وهذا الشغف يعرف في حد ذاته بشخصيته الفكرية العميقة، ويضيء أبعادها المتسائلة والنقدية، ولقد كان ميالاً للأدب، غير أن انشغاله بالفلسفة أكبر. ولقد شارك في هذا السياق، الوحدوي والمثقف الكبير سامي الدروبي خياره الفكري الذي وهب فيه الفكر العربي إنجازات لا تنسى ولا يمكن أن تهمل كما في ترجمة برغسون الذي كان من أهم فلاسفة ما بين الحربين. وقد شرع بذلك مع الدروبي للدهشة في العم 1943 حين ترجما «بين منابع الأخلاق والدين» ثم «الضحك». حظيا بدعم مباشر من قبل عميد الأدب العربي طه حسين.
أنتج الراحل الكبير بشكل مبكر، ومنذ العام 1947، كتابات لامعة عن الفكرة القومية، واستأنف تأصيلها وتطويرها بشكل باتت فيه مؤلفاته جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الفكرة العربية الحديثة. وفي كامل إنتاج عبد الدائم القومي لا نرى سوى القومية الإنسانية المنفتحة والتنويرية والنهضوية التي ليس لها أدنى علاقة بأفكار العرق وأوهامه.
إن مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية إذ يودع المفكر القومي، التربوي الكبير، الدكتور عبد الله عبد الدائم عضواً مؤسساً، فإنه سيذكر المناقب الأخلاقية والفكرية والعلمية السامية للراحل الفقيد وإسهاماته في ميادين البحث والتأليف، وما قدمه للمكتبة العربية من إسهامات جادة ورصينة، وبشكل خاص في ميدان التخطيط التربوي.
المستقبل العربي
مركز دراسات الوحدة العربية
في ذكرى مرور أربعين يوماً على وفاة
المفكر التربوي والعربي الكبير د. عبد الله عبد الدائم
دمشق – مكتبة الأسد
قلّما اجتمعت شمائل خلقية وعلمية، وفضائل فكرية وثقافية، كما اجتمعت في مسيرة الراحل الكبير الدكتور عبد الله عبد الدائم الذي ملأ حياته حتى اللحظة الأخيرة بعطاء لا ينضب، وبإنتاج لم يتوقف فكان الخصب دون صخب، وكان الضوء دون ضوضاء، وكان الإنجاز دون منّة، وكان التوهج والتألق دون تعالٍ أو استعلاء.
ولم يكن ذلك غريباً عن من كانت ولادته في حلب الأصيلة في عراقتها، ودراسته في حمص المشرقة دوماً بمبدعيها، وإقامته في دمشق الوفية لتراثها الذي يختزل تراث الأمة وحضارة الشرق، وكان الوطن الكبير ميدان حركته من خليجه الى المحيط، وكان العالم بأسره موضع متابعته الدقيقة عبر نوافذه المتعددة التي أبى أن يغلقها لا لأنه كان إنسانياً في عروبته، وعالمياً في مداركه فقط، بل ايضاً لأنه كان يدرك أن إغلاق نوافذ الأمة على العصر، وعلى العالم، هو حرمان لها من النور والهواء كما من القدرة على حمل رسالتها الخالدة، رسالة التوحيد والإيمان والإسهام في بناء الحضارة الإنسانية.
تنقل عبد الله عبد الدائم بين السياسة والثقافة، بين العمل الحكومي والتدريس الجامعي، بين الالتزام القومي والتخطيط التربوي، بين دمشق وبيروت والقاهرة والدوحة ومسقط والكويت وغرب أفريقيا وباريس، غير انه بقي على الدوام ثابتاً على مبادئه، صامداً في مواقفه، مسترشداً بأبجدية الوحدة العربية، مطوراً لمفاهيمها ومسالكها ودروبها في ضوء تجارب الامة، وخبرات الشعوب، فبدا وكأنه في حال دائمة التأسيس، وفي روح متدفقة من التجديد، وفي نظرة شمولية ترفض التقوقع والتحجر والرؤية المجتزئة للأمور، فاستحق أن يكون واحداً من الأحرار الاستشرافيين القابضين على جمر مبادئهم ، بل من الذين لم يبدلوا تبديلاً.
وها نحن اليوم، وفي غمرة الأزمة المالية العالمية التي كشفت تهافت النظام العالمي الجديد وكل النظريات التي ساقها منظروه، وهو تهافت يذكرنا بالكثير من كتابات د. عبد الدائم وإشاراته في العقدين الماضيين، نقف أمام الاعتراف الخطير لغرينسبان الحاكم السابق للمصرف الفدرالي الأمريكي وأحد مهندسي النظام المالي العالمي حين قال :«لقد كنت مخطئاً على مدى أربعين عاماً»، نقول له نحن اليوم لقد كان عبد الدائم وأمثاله بالمقابل مصيبين في تقييمهم لهذا النظام على مدى أربعين عاماً أيضاً.
لن تفي الكلمات حق هذا الرجل الكبير مهما كانت بليغة أو معبّرة، لأن الرجل كان موسوعة في الفكر، وسفراً في الفلسفة، وصرحاً من صروح النهوض والانبعاث في الأمة، فحبذا لو أن مراكز البحث والدراسات وعلى رأسها مركز دراسات الوحدة العربية، الذي واكبه راحلنا لسنوات طويلة كعضو في مجلس أمنائه، أن ينظم ندوة أو أكثر عن جوانب العطاء الفكري والتربوي لهذا العالم المتميّز، والملتزم الصادق، والمفكر النهضوي الذي لم يدخل قلبه اليأس يوماً لا لشدة الإيمان في قلبه فحسب، بل ايضاً لرجحان عميق في عقله، ولصوابية دقيقة في رؤاه.
حين اختار عبد الله عبد الدائم البعث حركته للنضال في سبيل أمته، كان يدرك مع المؤسسين الأوائل أن الأمة تنتصر إذا انتصر فيها الإنسان، وتنهض إذا نهض الفرد، وتتحرر إذا امتلك فيها المواطن حريته، لذلك حين خرج من دائرة العمل السياسي المباشر، وهو عمل قلّما استغرقه أو شغله، اندفع إلى التربية كما الى الفكر، مدركاً أنه بهما يبني حيث ينبغي البناء، ويحصّن حيث يجب التحصين، ويطور حيث تحتاج المجتمعات الى التطوير، فكان الإنسان لديه الغاية والوسيلة، وكان المواطن هو الهدف والأداة، وكان تلازم العلم والحرية هو جوهر رسالته التربوية، تماماً كما كان تلازم التفكير العلمي والنهج التحرري الوحدوي التقدمي هو جوهر رسالته القومية.
ولا أجافي الحقيقة أبداً إذا صارحتكم أن بعض أحلى لحظات حياتي، وهي الممتلئة، كحياة كل عربي، بخيبات وانكسارات واحباطات، كانت حين اتحدث مع أبي أرود أو أتلقى منه اتصالاً هاتفياً يحيي فيه نشاطاً نقوم به من اجل المقاومة في فلسطين أو العراق أو لبنان أو أي قطر عربي، أو يدعم فيه مبادرة نطلقها لتوحيد الجهود، وتجاوز الانقسامات، والتركيز على ما يجمع، ونبذ ما يفرق، أو من أجل أن يشيد بفكرة أو رأي يعبّر عن استمرار المدرسة الفكرية، بل الجامعة القومية، التي كان فيها عبد الله عبد الدائم مؤسساً ومعلماً بل مُعلماً كبيراً من معالمها.
وفي مثل هذه الأيام قبل ثلاث سنوات، وكانت الضغوط والتهديدات ضد سورية وخياراتها القومية في ذروتها، التأمت في دمشق الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، الذي كان راحلنا الكبير من أبرز مؤسسيه، أذكر أنه بعد عودتي الى بيروت تلقيت اتصالاً من الدكتور عبد الدائم يحيينا على هذه المبادرة التضامنية وعلى ما رشح عن لقاء الأمانة العامة مع الرئيس الدكتور بشار الأسد من صدق وبحث في سبل مواجهة تلك الضغوط ولا أنسى كلماته آنذاك: «هكذا تكون الروح القومية الأصيلة، روح تتجاوز كل اعتبار حين يكون قطر عربي مهدداً كما حال سورية آنذاك».
لذلك، فإننا ندرك جميعاً أن ما من أمر ترتاح إليه نفس راحلنا الكبيرة في عليائها، وتطمئن إليه، وترضى عنه، اكثر من أن نكمل مسيرة بدأها عبد الله عبد الدائم ورفاقه في كل حركات النهوض والتقدم والتواصل مع التراث والانفتاح على العصر التي كانوا فيها رواداً، وهي مسيرة الوحدة رغم كل أسافين التجزئة والتفرقة، ومسيرة الاستقلال والحرية رغم كل حراب الاحتلال والاستبداد، ومسيرة العدالة رغم كل جشع المحتكرين وتلاعبهم واحتيالهم، ومسيرة التنمية رغم كل عوائق التخّلف والجهل والفقر والمرض، ومسيرة التجدد الحضاري رغم كل مخططات الفصل المصطنع بين تراثنا والعصر، بين هويتنا وعقيدتنا، بين حضارتنا العربية والإسلامية الجامعة ذات المدى الرحب وبين خصوصيات دينية أو عرقية أو أثنية تعتز بها أمتنا، ويسعى أعداؤنا إلى تحويلها إلى عصبيات مدمرة.
فيا أبا أرود، سنبقى مقيمين على العهد، وأنت الذي ما نقضت في حياتك عهداً ، ولا نكثت بوعد، ولا وهنت في موقف أو ضعفت في التزام.
فتحية لك حيث أنت في جوار الصديقين والأبرار بإذن الله، وكل التقدير لرفيقة العمر أم أرود، وللأحباء أرود وأوس وميساء وحكمت، ولكل قريب وصديق ومحب وتلميذ وما أكثرهم.
قالوا فيه
لقد حركت وفاة الدكتور عبد الله عبد الدائم الكثير من الأقلام والقرائح التي انطلقت تصف الفقيد الكبير في حياته وما خلفه من تركة علمية وإنسانية كبيرة، وتدعو إلى الاستفادة من تراثه المهم في الفكر القومي العربي والفكر التربوي والفلسفي.
الدكتور عبد الله عبد الدائم، المفكر القومي والتربوي المتميز
ما أقسى غياب العلماء من أبناء الأمة وما أعظمها من خسارة!
وإذا كان الوطن قد مني بخسارة المربي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الدائم في العاشر من هذا الشهر فإنه لرزء كبير لأن الفقيد من جيل المكابدة وهو جيل القدوة والمثال علماً وقيماً وحرصاً على الثوابت القومية والأمانة العلمية والنزعة الإنسانية.
لم يكن الدكتور عبد الله عبد الدائم شخصية عادية وإنما كانت شخصية متعددة الأبعاد بثقافتها الشمولية والموسوعية، كان متخصصاً في التربية إلا أن تخصصه لم يكن بحائل بينه وبين بقية العلوم الإنسانية فلسفة وأدباً واجتماعاً وعلم نفس يزين ذلك كله لغة عربية صقلت عباراتها وجزل أسلوبها وسلمت بنيتها.
طالما تردد اسمه على نطاق الساحة القومية مفكراً قومياً وتربوياً متميزاً وطالما استشهد برأيه الرزين والرصين في المؤتمرات والندوات وفي البحوث وأوراق العمل وفي الكتب التربوية والثقافية.
ولم يكن تميزه ناجماً إلا عن موهبة منحها منذ طفولته وثابر على إغنائها وصقلها باطلاعه على ثقافة أمته وتراثها وبنهله من ثقافات الأمم الأخرى، وقد ساعده على ذلك تمكنه من لغته الأم (العربية الفصيحة) ومن اللغتين الفرنسية والانكليزية وحرصه على التفوق في الأداء إن في مسيرته الدراسية أو في عمله العلمي بعد نيله الشهادات العليا بتقديرات مشرفة، إذ إنه تسلم وزارتي التربية والإعلام وعمل في مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية في بيروت ومن ثم في مقر المنظمة بباريس، وكان قد عمل أستاذاً مجلياً في كلية التربية بجامعة دمشق.
ولم تحل المناصب التي تقلدها من الانقطاع عن البحث والتأليف فأغنى المكتبة العربية بتراث عقله المتقد متمثلة في (تاريخ التربية) ودرس في التربية القومية الآفاق المستقبلية للتربية العربية نحو فلسفة عربية للتربية، مراجعة إستراتيجية، تطوير التربية العربية، استراتيجية الطفولة المبكرة.. الخ.
وكان كتاب «الجامع في التربية العامة» لمؤلفه «رونيه أوبير» مرجعاً أساسياً نقله الدكتور عبد الدائم إلى العربية فسد فراغاً في المكتبة العربية في مجال التربية العامة.
وقف نفسه للبحث والتأليف، وطالما كلفته إنجاز بعض المشروعات التربوية عندما كنت مديراً لقطاع التربية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) فكان نعم الخبير التربوي والباحث الجاد والملتزم وقد دفع ضريبة ألقه ونجاحه وتميزه من حسد نفر لا يروق لهم أن يتميز امرؤ عليهم، ورحم الله الشاعر بدوي الجبل إذ يقول:
قل لمن يحسد العظيم تمهل إن خلف الأمجاد هماً وجهدا
لقد توطدت العلاقة بيني وبينه في العقدين الأخيرين وتعددت الزيارات واللقاءات، فوجدت فيه المربي الفاضل والمثقف المجلي والصديق المخلص وطالما كانت الموضوعات التربوية تحتل الحيز الأكبر من أحاديثنا في لقاءاتنا.
اشتركنا معاً في ندوات تلفزيونية ومؤتمرات تربوية وثقافية عقدت في بعض عواصم الأمة (القاهرة، تونس، المنامة، عمان، بيروت، دمشق).
فكان مميزاً في أدائه وبارعاً في طرح أفكاره ومحيطاً بموضوعه. ما صدر له كتاب في الآونة الأخيرة إلا أرسل لي نسخة منه هدية مقدمة بعبارة «إلى الصديق الأثير» ولكم كانت صداقته متينة في الدنو والبعاد وكان حريصاً عليها فما عاد من سفره مرة إلا بادر بالاتصال والسؤال وما سافر إلى باريس في الآونة الأخيرة إلا ويتصل هاتفياً وفي سفرته الأخيرة هتف إلي ليخبرني أنه سافر إلى باريس قائلاً: إذا كنت تريد أن ترسل أي شيء إلى ابنك (بيان) فأنا جاهز لإيصاله فشكرته للطفه وذكرت له أن ابني قادم إلى دمشق بعد بضعة أيام وما كنت أدري أن هذا الهاتف إنما كان الهاتف الأخير.
لقد حضر لي محاضرة في مجمع اللغة العربية في شهر أيار الماضي وكانت المحاضرة «عن التربية على المواطنة» وقدم بعض السادة الحضور مداخلات حول بعض النقاط التي تضمنتها المحاضرة وطلبت إلى أستاذنا الدكتور عبد الدائم أن يغني المحاضرة بملاحظاته القيمة التي تعودنا عليها فنظر إلي بابتسامته اللطيفة المعهودة ولم يعقب وعندما وصلت إلى البيت هتف إلي مهنئاً ومبدياً إعجابه بما تضمنته المحاضرة من فكر ولاسيما الإشارة إلى منظومة قيم المواطنة في تراثنا العربي ولكم كان معتزاً بتراث أمته وغناه معرفة وقيماً وأداء!
لقد آمن أن التربية تستطيع إحداث التغيير في المجتمع العربي بشرط أن يسعفها أهلها أرباب التربية وأن يؤمنوا برسالتها وقيمها الإنسانية يرقى في معارج القيم وبطريقها يرقى إلى آفاق العلم والمعرفة والعطاء للأمة والإنسانية.
ومن هذا كان يربط بين القومية والإنسانية وبقدر اعتزازه بقوميته يعتز بتوجهه الإنساني بعد أن رأى أن إنسانية الإنسان إنما تتحقق كاملة في الكيان القومية وتتفتح فيها وتزدهر لأن القومية هي غاية مطاف الإنسان وغاية وجوده ولأنها تضعه في صحنه الطبيعي وتحتاج لديه أقصى قواه الإنسانية.
والوجود الذي تتصوره القومية وجوداً مكوناً من قوميات متآخية متآزرة هو عينه الوجود الإنساني. وطالما عزز دعوته إلى القومية الإنسانية البعيدة عن روح الغلبة والاعتداء وتدرك الإطار الطبيعي الذي تتفتح فيه الروح الإنسانية إطار الأمة والقوم فضمن هذا الإطار وحده يمكن أن يكتب للنزعة الإنسانية أن تترعرع انطلاقاً من أن جوهر كل منزع إنساني إلى التعايش إنما هو الإيمان بالفكرة القومية لأنها هي التي تعني في نهاية الأمر حق الشعور في تقرير مصيرها ولا سبيل إلى صيانة الفكرة الإنسانية حقاً إلا عن طريق الإيمان بحق كل أمة في تقرير مصيرها وبحق القوميات في بناء كيانها المستقل واختيار النظام الصالح لها.
وأمتنا العربية التي حملت رسالة الإنسانية في الماضي والتي اصطبغ تاريخها دوماً بالوحدة العميقة بين العمل القومي والتعايش الإنساني وقيمته بأن تؤدي الدور الأكبر في هذا الميدان إن هي أدركت طبيعة وجودها ومهمتها في ظلال هذا العصر الذي تجتاح القيم المادية وتنحسر منه القيم المعنوية والإنسانية.
رحم الله الدكتور عبد الدائم الرحمة الواسعة سعة ما قدمه لأمته من عطاء متميز في مجالات العلم والمعرفة وسيبقى فكره القيم وفكره التربوي من الصوى التي تهتدي بها الأجيال في مسيرة نضالها نحو تحقيق الأجمل والأبهى والأكمل في هذه الحياة.
الدكتور محمود السيد
عبد الله عبد الدائم: حياته تأسيس مستمر
لم تغب الصورة الأولى لأستاذنا الراحل الكبير الدكتور عبد الله عبد الدائم عن البال أبداً منذ لفتتني تصريحاته في ربيع عام 1962، وكان وزيراً للإعلام في حكومة المرحوم الدكتور بشير العظمة وكنت طالباً في المرحلة الثانوية في بيروت.
يومها كانت الأمة كلها مشدودة إلى دمشق فيما الشعب العربي السوري يخوض معركته ضد الانفصال، تماماً كما تنشد الأمة اليوم إلى فلسطين والعراق حيث أهل البلدين الحبيبين يخوضان وببسالة استثنائية مقاومتهما الأسطورية ضد الاحتلال، وكانت آنذاك، كما اليوم، كل كلمة محسوبة، وكذلك كل موقف.
وفي تلك الأيام الحبلى بالتطورات كان أسماء قادة كبار وشخصيات لامعة قد بدأت تخرج من الحلبة، فيما بدأت تبرز أسماء أخرى، بينها اسم عبد الله عبد الدائم وهو يطلق الموقف الوحدوي تلو الآخر، فيما يضيق به ذرعاً أولئك الذين اضطروا للقبول به وزيراً لإسكات الشعب الغاضب والجيش المتململ ضد الانفصال.
وأقبلت بفرح بعد ذلك على كتب د. عبد الله عبد الدائم اغرف منها علماً وثقافة والتزاماً قومياً، وأدركت يومها أن السياسي الوحدوي الذي شدني هو أيضاً مثقف من طراز رفيع، وخريج متفوق من جامعة السوربون في فرنسا بل هو مفكر وباحث يتنقل بين كتابات الرصينة في القومية العربية، وبين كتبه الرائدة في شؤون التربية وشجونها، تماماً كما النحلة بين الورود فيتحول معه رحيق العلم والثقافة إلى عسل الوعي وشهد الالتزام.
ومرت سنوات قبل أن أتعرف شخصياً إلى د. عبد الله عبد الدائم، لأكتشف عبر السنين والعقود، في هذا المفكر والباحث والكاتب الملتزم قدرة على التجدد، وطاقة على العطاء، لا تتوفر عادة إلا عند جيل الآباء المؤسسين.
فالمؤسسون الأصيلون، والأصليون، كالدكتور عبد الله عبد الدائم، لا يكون التأسيس مرحلة في حياتهم، أو في حياة الأفكار التي يطلقونها، والحركات التي يحملون لواءها، بل تكون حياتهم كلها عملية تأسيس مستمر، وأفكارهم وحركاتهم تبقى في طور التأسيس أبداً.
والتأسيس لدى هؤلاء هو رسالة ومسؤولية وهو رهبة وخوف دائم من التجمد في موقع أو التسمر موقف، بل أن هذه الروح لديهم هي دعوة إلى المراجعة الدائمة، مراجعة تتمسك بالجذور وتتفتح على الآفاق المفتوحة باستمرار، لذلك لا عجب أن تكون أبرز كتابات الدكتور عبد الدائم الأولى تتركز على إنسانية القومية العربية لتحريرها من كل شوائب الغلو العنصري أو العرقي وللتأكيد على ارتباطها الوثيق بالرسالة الخالدة التي اختار الله لها أرض العرب منطلقاً لتشمل كل أرض، واصطفى لها من بين العرب رسولاً يحملها إلى كل البشر.
كما لا عجب أيضاً أن تكون كتاباته في السنوات الأخيرة تركز على علاقة العرب مع العالم وفق معادلة التفاعل الخلاق التي ترفض الانغلاق عن حضارات الآخرين كما ترفض الالتحاق بها، سيما وأن حضارتها العربية الإسلامية، التي ساهم فيها مسلمون وغير مسلمين، وعرب وغير عرب، استوعبت ما سبقها من حضارات وساهمت فيما تلاها من حضارات أيضاً، ولذلك فهي ترفض لحضارات الآخرين أن تسحق الهوية الثقافية والحضارية لأمتنا.
هذه الرؤية التي تتكامل في جنباتها حضارة الأمة مع متغيرات العصر شكلت، وتبقى تشكل أحد مصادر هذه الروح التأسيسية التي حملها د. عبد الله عبد الدائم وجيله من الآباء المؤسسين، إذ كيف يستقيم الجمود مع حمل الرسالة، وكيف يتعايش التحجر مع حال التغير التي هي سنة الكون وسر استمراره، وبالتالي كيف تغيب عن الوعي العربي العميق الضرورة الحادة المتأججة إلى تأسيس مستمر.
ولست أدري ما إذا كانت الروح التأسيسية هذه هي وراء انغماس د. عبد الله عبد الدائم في الفلسفة والتربية في آن معاً، أم أن هذين العلمين المهمين هما اللذان حفزا لدى أستاذنا كل هذه الرغبة والقدرة على التجدد.
فالفلسفة بما هي وعاء الأسئلة الكبرى التي تطرح نفسها على الإنسان، وجوداً ومصيراً، هي أكثر العلوم الإنسانية اتصالاً بالقلق الذي بدوره هو أكثر المشاعر الإنسانية المحفزة للهمم، والملهمة للإنجاز، بل إن القلق هو أكثر المشاعر الإنسانية اتصالاً بروح التأسيس حيث لا قعود ولا استكانة، ولا اطمئنان كاذباً.
أما التربية، بما هي علم التواصل مع الأجيال، فهي أكثر العلوم الإنسانية حاجة إلى المراجعة الدائمة، في ضوء هذا التواصل، بل هي أكثرها تأثراً بتطورات العصر والعلم على كل مستوى، وبالتالي هي فعل تأسيس بامتياز، إذ لا يتم عبر التربية تأسيس الطلبة فوجاً بعد فوج، وتأهيلهم عاماً بعد عام فحسب، بل يعاد من خلال العملية التربوية ذاتها إعادة تكوين المعلم نفسه من خلال تفاعله مع دورة الحياة المتدفقة أمامه جيلاً بعد جيل، فكما أن «النهر لا يمر أمامك مرتين»، حسب المثل الصيني، فكذلك لا يتكرر طالب أمام معلمه مرتين.
ولم يكن أبداً من قبيل الصدف أن يسمى الفلاسفة الكبار بالمعلمين، فما ذلك إلا تعبيراً ساطعاً عن عمق الارتباط بين الفلسفة والتربية، وبينهما وبين روح التأسيس المتجذرة، الذي تسكن جوارح كل معلم كبير.
وبهذا المعنى فالدكتور عبد الله عبد الدائم هو معلم كبير، إأنه معلّم بل مَعْلم في حياتنا الثقافية والقومية، كما هو كبير في تواضعه ودماثة خلقه وبساطة عيشه وتوقد ذهنه وصفاء رؤيته ونقاء سريرته وعمق إيمانه، وسلامة التزامه.
بل بهذا المعنى أيضاً، فإن فكر د. عبد الدائم هو فكر العروبة الجديدة، عروبة التشبع بتراث الأمة الروحي والحضاري، وعروبة التطلع إلى فهم العصر ومواكبة تطوراته، عروبة المساواة لا التمييز، عروبة التكامل لا الإقصاء، عروبة المواطنة لا المحاصصة، عروبة التفاعل لا الإلغاء، عروبة التواصل لا الانقطاع، عروبة المشاركة لا الاحتكار، عروبة التكافؤ لا الاستئثار، عروبة الحرية لا القهر والاستبداد، عروبة الالتزام بالمقاومة بمعناها الشامل، مقاومة الاحتلال الخارجي من أجل حرية الأوطان، ومقاومة الاختلال الداخلي من أجل حرية الإنسان.
معن بشور
منزلة سامية بين المؤلفين العرب
يحتل الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الدائم المنزلة السامية بين المؤلفين العرب، لما أوتيه من مقدرة بالغة في التأليف، وما قدمه من النتاج الغزير، فقد عرف باطلاعه الواسع على ما يصدر باللغة العربية، وباللغات الأجنبية، وكان يتوخى في عمله دائماً وأبداً الإحاطة بموضوعه إحاطة تامة، وأن يبلغ به غاية الإتقان. كان في تأليفه صاحب رسالة، قد ملأه الإيمان والحماسة، فوقف نفسه داعياً من دعاتها.
لقد آمن بوحدة الأمة العربية، والعمل الدؤوب لنهضتها حتى تستعيد مكانتها. وكان للغة العربية مكانتها الرفيعة في نفسه، ومن هنا فقد تخير لتحقيق ما تصبو إليه نفسه أن تكون الغلبة في تأليفه لموضوعين هامين هما: التربية والفكر العربي القومي.
د. شاكر الفحام
يقول المثل العربي: كل فتاة بأبيها معجبة. هذا المثل ينطبق علي إلى حد بعيد. ويا ليت كان بالإمكان أن يكون هذا لسان حال كل فتاة، ولكن هناك آباء شرسين قلما يفسحون المجال لبناتهم للافتخار بهم. لذلك أشكر ربي الذي وهبني أباً أكثر من عظيم. فيه وجدت الأب المثالي منذ أن فتحت عيني على الدنيا ورأيته ينتظرني بابتسامة. وكان إعجابي به يزداد يوماً عن يوم. كان طبعه الرصين الهادئ أول ما جعلني أتعلق به كأب وصديق وكانت نصائحه الرزينة تنمي حبه في قلبي. أحب الناس كما يحب نفسه، وهبهم ما عنده من خير. وكانت يد المساعدة التي يمدها للناس هي التي علمتني التآخي. ويده المثقوبة لقنتني الكرم والعطاء. أما تواضعه وصداقته مع الصغير والكبير فعلماني أن التواضع رفعة. أصدقائي يحسدونني عليه، هم يجدون فيه الجنتلمان المهذب، ويهمسون في أذني «نيالك»، يعجبون بحديثه وتروق لهم تصرفاته، بعد أن أنست من معاملته آية الخير وشممت في أفعاله كل بركة، وبعد أن وهبني العلم وزود عقلي بالمعرفة. أدركت أن والدي هو الأب المثالي، وأنني مهما أعطيته من وفائي ومهما أغدقت عليه من حبي سأظل مدينة له بالكثير. وإن أقل عرفان بالجميل هو في صيروتي الفتاة التي حلم بتنشئتها وانتقالي إلى المرأة التي أرادها أن تكون. أنا ابنته، وكم تراني فخورة بذلك. فلا أحلم ـ بالرغم من كوني فتاة ـ إلا أن أكون مثل بابا تماماً. أكثر ما أحب في الرجل شخصيته، وككل فتاة، أفضل الشخصية القوية البارزة. وسيظل الرجل برأيي ذاك الذي يتحمل أعباء الحياة. إعجابي بوالدي إعجاب برجولته ووقاره وشخصيته الفذة، إعجاب ينبع من التفهم والتقدير الذين يسودان معاملته لي. في طفولتي، وإن كنت لا أذكر منها الكثير، كان يقاسمني أحاسيسي وكأنه الطفل في مشاعره. وفي مراهقتي، التي مازلت أمر بها، يهبني من التفهم ما يحملني على تصوره ذلك المراهق الكبير، لأنه يفهمني وكأنه لم ينته من مراهقته بعد. هذا في معاملته لي، أما بالنسبة لأخوتي فأراه يجمع بين الطفولة والمراهقة، ثم لا يلبث أن يعود إلى صورة المربي والمرشد الكبير الذي ينشر الإخلاص والتفاني في ميدان العمل والحياة. لم أبالغ فيما قلته، بل لم أعط والدي، بعد، ما يستحقه من الثناء، قدرني الله على أن أكون الابنة البارة التي يستحقها والد كهذا. والآن اسمحوا لي بكلمة أتوجه بها إلى بابا: اعذرني يا بابا، أنا أعلم أنك ستنزعج لهذا الثناء وستسارع إلى إنكار ما نسبته إليك وما يمنعك تواضعك من الإقرار به، ولكنني أردت أن أفاخر بك أمام صديقاتي بنات 17، ومن يدري فلربما وصلت رسالتي هذه إلى قلب والد آخر فيتأثر بمزاياك ويحذو حذو فتسعد بنت 17 أخرى.
ميساء عبد الدائم
مجلة الحسناء اللبنانية 10 شباط 1969
مراجع
- مؤلفات الدكتور عبد الله عبد الدائم.
- المفكر والمربي العربي الكبير الدكتور عبد الله عبد الدائم، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، 2008.
- موقع الدكتور عبد الله عبد الدائم.
اكتشف سورية











 نزار قباني
نزار قباني بدوي الجبل
بدوي الجبل الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي
الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي قصة الحب بين ولادة وابن زيدون
قصة الحب بين ولادة وابن زيدون منتجع نسمة جبل.. جمال طبيعي لا يوصف
منتجع نسمة جبل.. جمال طبيعي لا يوصف زكريا تامر
زكريا تامر أدونيس
أدونيس منبج
منبج أبو فراس الحمداني
أبو فراس الحمداني صور جديدة للجامع الأموي في دمشق
صور جديدة للجامع الأموي في دمشق السادس من أيار
السادس من أيار السيف الدمشقي أسطورة لا تزال حية
السيف الدمشقي أسطورة لا تزال حية آيات قرآنية كريمة بالخط العربي الكوفي للفنان محمد الجندلي
آيات قرآنية كريمة بالخط العربي الكوفي للفنان محمد الجندلي نذير نبعة يعرض استعادياً تجربته الفنية في صالة تجليات
نذير نبعة يعرض استعادياً تجربته الفنية في صالة تجليات صور جديدة لمدينة تدمر من السماء
صور جديدة لمدينة تدمر من السماء