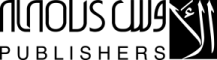|
الصفحة الرئيسية | شروط الاستخدام | من نحن | اتصل بنا
|
فضاء فاتح المدرس
أيها الوحيد والأخير
كم مرة تحترق
في وهج الصور المتباعدة
بلى وتسقط العاصفة بلا حراك
نظر
الشيء إلى السماء
قال مبتسماً
ـ هل أنا أيضاً سجين
ـ قالت السماء:
ألم يدهشك، وأشارت
إلى ظله
ـ سيدتي، سيدتي
هلا أريتني الوجه الآخر
للكون؟
الحب: الحديث عن الحب مثل الحديث عن الشيطان تماماً، يبقى الأمل العظيم إن الخلايا الاجتماعية تنتظم ثقافياً وتمنح الجنس شرف التحكيم العقلي.
الصداقة: مفهوم مطاط جداً يكاد يكون موجوداً على هامش العقل البشري، يعني العقل البشري يتأمل وجود مفهوم الصداقة، ولكن إذا نظرنا إلى نتائج العلاقات الاجتماعية نجد أن الصداقة أيضاً مسكينة جداً ووهم، هذا الوهم يحاول أن يتبلور وأن يكون شيئاً فعالاً في العلاقات الاجتماعية، ربما كان هذا الحلم، الاحتمال تثبيت مفهوم الصداقة في حياة الفرد أرى أنه لب الخلايا الاجتماعية المنظمة لكن الوصول إليه في منتهى الصعوبة، الصداقة تعني أن يكون لك إنسان آخر بجانبك في السراء والضراء وهذا شيء صعب جداً وليس سهلاً ويعني العاطفة والنية الحسنة لا تكفي في الصداقة. مفهوم الصداقة في العربية أوسع بكثير ولكنها أقل فعالية. فالعرب يتكلمون عن الصداقة كما يتكلمون عن الحب.
كل ما كتب، أو قيل -أو ما كان يمكن أن يكتب، أو يقال- يؤكد أن فاتح المدرس قد بقي، لفترة تناهز نصف القرن، واحداً من أكثر المبدعين في وطننا حضوراً، وإشعاعاً، وإثارة للنقاش في حياتنا الثقافية. وقد تجاوز بريق هذا النجم الحلبي حدود الوطن الصغير ... فالكبير... فبعضاً من العالم!
منذ خمسينات هذا القرن بدأت شخصية فاتح المدرس الفنية الفكرية تتفتح، مدللة على خصوصية أثارت الحوار بشخصه... بتصرفاته... بآرائه وأفكاره الطليعية.. وبعطائه المتميز... المتين أساساً...
في آخر لقاءاتنا، ولم يكن مبنياً على موعد، وإنما هكذا بين بابين، كان فاتح المدرس الذي خسرته الفنون العربية نهار أول من أمس، أي بعد ظهر الاثنين 28حزيران 1999، أشبه بالحال الشفافة التي تختزن طراوة الزمن، وكأننا أمامه في حضور الوجه السري للأشياء، ظلال وأطياف معقودة على حكاياتها، ولا تزن أكثر من صداها، وتكاد تعبر كما الصور في الذاكرة، وناس وأحداث ومدن تتراكم لمجرد مرور فاتح المدرّس في هذا اليوم، في هذا المكان، باريس، دمشق، بيروت، في بيروت خاصة، وكان يبدو دوماً بيروتياً أكثر من العديد منا، مائي وهوائي وملون وكأنه يحط في خفة طيارة على الأشكال. وكأنه يوحي وبعدئذ يدل. ويصل دوماً إلى قول ما يريد من دون ثقل في المفردات وتثاقل في الجمل. وفيه خفر يبعد عنه طنين البلاغة. وفيه بساطة تشده إلى سكون يشي بشاعر يغذيه صمت على إيماء. وفيه حيوية مبللة بعرق التجارب التي اختلت دوماً دوران الصور في مخيلته، بصورة كأنها ذاتها، وأن تزين بألف صورة وصورة.
لا زمن في لوحة فاتح المدرس الذي مات قبل أيام (1922-1999)، فتاريخها متحرر من الوقت، كما لا حدود للمشهد الطبيعي المترامي الذي يقيم وحدة روحية وعضوية بين الأرض والسماء، كما لا حدود أيضاً لتلك النظرات التي تبدو أحياناً أنها طفولية، ساهمة وطائشة، ثم تبدو في آنٍ واحد أنها تتطلع إلى مكانٍ ما، مكانٍ أبديّ موجود في الوهم، فتوحي للعين أنها لا تجد ملجأها في أرجاء السطح التشكيلي وأنها في بحثٍ دائم عن ذلك الأمان الذي يحررها من القلق والألم ويمنحها سر الاستلقاء في المطلق.
لن أرثي فاتح المدرس، فرحيل جسده كان القضاء، أما بقاء فنه وثقافته التي كان هو شخصياً مصدر إشعاع ساهمت نتائجها في بناء الحداثة الجديدة، فهو القدر.
ورحلة فاتح المدرس الطويلة القصيرة ابتدأت مع موهبته المبكرة، فالفنان الراحل بجسده عن دنيانا، هي واحدة من الشعلات القليلة في حياتنا الثقافية من فن تشكيلي ورؤية أدبية خلافة وتفكير متألق نحو الأمام، فكلنا الآن يدرك أن لوحات المدرس قد استوحت ألوانها وأشكالها من تربة الأرض تعكس شمساً شرقية وتكتوي بنار الإنسان المتجذر في الأرض السورية التي جمعت في مطبخها ثقافات عديدة تعاقبت على الجغرافيا لتصنع تاريخاً غنياً.
لم يكن الفنان الراحل فاتح المدرس سوريالي النزعة التأليفية، ولا تجريدياً، ولا حروفياً، إنه فقط تعبيري-رمزي في أسلوبه ومعالجته التقنية وفرادته التأليفية والتوليفية. تعبيري ينتمي للأرض العربية وضوء الشمس فيها وصفاء السماء بكل ما فيها من زخم حضاري وقصص وذكريات وجماليات بيئية وإنسانية وموروث، مشبع بروحية الحداثة الفنية التشكيلية بكل ما فيها من تقنيات التصوير الزيتي المعاصر.
ارتبطت تجربة الفنان فاتح المدرس بالإنسان، وعبرت دوماً عما هو إنساني، والإنسان هو المحور الرئيسي الذي تدور التجربة حوله، وهو المنطلق إلى الموضوعات التي يعالجها، يصوره في لحظات الأزمات التي تهدد وجوده، ويقدمه في حالات الحصار أو الاستلاب، التي يعيشها منذ البداية وحتى النهاية.
هذا بحر، زرقته تشي به، تلك بادية الوطن، جفافها يدبغ عروقنا بالعطش والسهوب والشمس التي تنقش على وجوه الفلاحين تجاعيد التاريخ، هذه سماء، مخزوقة بأزلية وجودها تاجاً، على رأس الشساعة الإنسانية اللامحدود الإبداع والمترامية التجليات، وفي السماء يرحل البدو إلى الماء والنار، وفي زرقتها يحاصر الهواء طهر الإنسان وبحثه عن بذور العدالة والحقيقة كائنات أسطورية تنزع ذاكرتها كما ننزع إلى ترك الصدى يعبر ذاته في واد سحيق.. هذه مساحة التوتر، أو لوحة فاتح المدرس، مادة تتجلى في نارية بحثها ووحشة مناخها وأسهل مما يمكن أن تحقق من رؤيتك للممتنع على الرؤية، تراكيبها محكومة بأعصاب المدرس ورائحة النعناع النفاذ إلى فضائه الموسيقي الصارم.. مادة خطوطها رقصة الشاعر في حضرة الحضارة والثقافات المتعددة وإعجاز الانتماء إلى سحر الأصباغ وهوية الإنشاء والمعمار والتنظيم ونبالة الاختيار والخيار. لوحة دنياها قشرة الأصباغ، وآخرتها بدائع النبوغ وفيض الروح على الأنفاس وهي تنسج ملاحم التودد للحياة وما وراء الفن ليحضر ما هو غائب على هيئة الضوء أو الصوت أو الزمان، ولتبرق منازل الجنون في رهانها على الشوق وهي ترحل من شمال سورية إلى جنوبها، ومن الافتتان برهان الروح على الجمال إلى ساحات المدن القلقة على غدها.
مع نهايات هذا القرن رحل فاتح المدرس مغلقاً ملفه الكبير (كعطاء فني ووقائع حياتية) أمام القرن القادم. ليفسح لنا المجال بأن نعتبره بحق (فنان القرن العشرين عربياً) ولو توفرت له الآلية الإعلامية كما توفر لغيره من فناني العرب لاعتبر فاتح (عالمياً واحداً من كبار الفنانين في هذا العصر.
لقد عرفت الفنان فاتح المدرس قبل أكثر من ثلاثين عاماً، كنا فيها بشكل متصل أكثر من عشرين عاماً، كان خلالها ولأكثر من عشر سنوات نقيباً للفنون الجميلة، وكنت أنا مديراً للفنون الجميلة.
أواخر أيار الماضي وبرعاية من السيدة الدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة دعت المهندسة سمر حمارنة لحضور ندوة حول كتابها المنجز مؤخراً بعنوان «كيف يرى فاتح المدرس؟...» وذلك في قاعات الصليب-بالقصاع.
ثلاثة كتب وعدد يصعب حصره من الدراسات في الكتب والمجلات المختصة والدوريات والصحف، هي حالة غير مسبوقة في الفن التشكيلي السوري تشير إلى أهمية «فاتح المدرس» فيه.
من رحم القبو الرطب المعتم الذي حوله الفنان مرسماً، في أحد الأحياء الدمشقية الجميلة والحيوية، كانت تخرج لوحات فاتح المدرس إلى النور، لتسافر إلى المعارض العربية والأجنبية، حيث تأخذ مكان الصدارة، وتعلّق على أبرز الجدران وفي أفضل الزوايا، فتحظى بالقسط الأوفر من اهتمام الزائرين. لكن كيف تنسى اللوحات، في مطافها الغريب، إنها تنتمي إلى جغرافيا أخرى؟ كيف يسعها أن تتنكر لمسقط رأسها في ذلك القبو، حيث طالما أسندت بالعشرات بعضها إلى بعض... وحيث يغص المكان بزحمة التفاصيل التي بعثرتها يد الفنان، ألواناً طالعة من اللوحات (أم تراه العكس؟)، كتباً، قشور ليمون، تفاحاً، أقداح شاي، رسائل، جرائد، أسماء أصدقاء، ومن يعرف ماذا أيضاً؟
 أدونيس يوقع كتاب «حوار: فاتح وأدونيس»
أدونيس يوقع كتاب «حوار: فاتح وأدونيس»
 صفحات من كتاب «حوار: لفاتح وأدونيس»
صفحات من كتاب «حوار: لفاتح وأدونيس»
 حوار فاتح المدرس وأدونيس في صالة أتاسي
حوار فاتح المدرس وأدونيس في صالة أتاسي
 معرض استعادي للفنان الراحل فاتح المدرس بمناسبة ذكرى رحيله العاشرة
معرض استعادي للفنان الراحل فاتح المدرس بمناسبة ذكرى رحيله العاشرة
 فاتح وأدونيس: حوار
فاتح وأدونيس: حوار
 شكران الإمام بعد عشر سنوات على رحيل فاتح المدرس
شكران الإمام بعد عشر سنوات على رحيل فاتح المدرس
 تفاصيل من حياة فاتح المدرس
تفاصيل من حياة فاتح المدرس
 اكتشف سورية يحاور فادي المدرس
اكتشف سورية يحاور فادي المدرس
 جبل الشيخ تعود إلى مرسم فاتح المدرس
جبل الشيخ تعود إلى مرسم فاتح المدرس
 ساعات مع فاتح المدرس
ساعات مع فاتح المدرس
 عادل قديح في مرسم فاتح المدرس
عادل قديح في مرسم فاتح المدرس
 نورا درويش: رحلة من الوجوه إلى الوجوه
نورا درويش: رحلة من الوجوه إلى الوجوه
 ما لم يعرض من حياة فاتح المدرس
ما لم يعرض من حياة فاتح المدرس
 فيلمٌ وثائقي في الثقافي الفرنسي يتناول حياة فاتح المدرس
فيلمٌ وثائقي في الثقافي الفرنسي يتناول حياة فاتح المدرس
 بورتريه سوسن الزعبي في مرسم فاتح المدرس
بورتريه سوسن الزعبي في مرسم فاتح المدرس
 معرض أحبك يا دمشق في صالة فاتح المدرس
معرض أحبك يا دمشق في صالة فاتح المدرس
 معرض جماعي في مرسم فاتح المدرس
معرض جماعي في مرسم فاتح المدرس