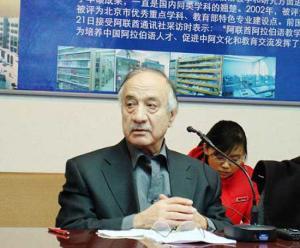فراس السواح

المحتويات
لم يكن فراس السواح كاتباً ضيق الأفق ولا مفكراً متسرع الأحكام، بل كان مفكراً يتميز بسعة الأفق والنظرة الموسوعية، ولم يكن يقرأ الأديان وتاريخها لينتصر إلى هذه الفرقة أو تلك. يقول فراس السواح: «كل الطرق تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى، والفرقة الهالكة هي الفرقة التي تؤمن باحتكارها للطريق المؤدي إلى الله».
سئل فراس السواح ذات مرة، كيف كانت طفولتك؟ فأجاب: «كنت طفلاً متسائلاً عن كل ما يحيط بي من ألغاز الوجود، وهذا التساؤل هو ميزة يشترك بها كل الأطفال، ولكن قسماً من هؤلاء يقنع بما يقدمه له الكبار من أجوبة جاهزة تعلموها بدورهم من آبائهم ومن ثقافة مجتمعهم، وقسماً آخر، وهم قلة، يبقون أمينين للسؤال ويجدون فيما يُقدَّم لهم من صيغ جاهزة موضوعاً لتساؤلات جديدة، وأنا من هذه القلة التي لم تقنع بالجاهز والموروث وراحت تبحث في داخل النفس وفي آفاق الثقافة العالمية بماضيها وحاضرها عن أجوبة على تلك التساؤلات الطفولية الأولى التي تؤلف في واقع الأمر المشكلات التي تصدت الفلسفة للتعامل معها».
إن الدهشة هي الأساس الكوني لبناء معارف، والرجال العظماء هم الذين تسكن الدهشة عقولهم ونفوسهم حتى أجسادهم، وأكاد أصيب الهدف عندما أقول إن فراس السواح واحدٌ من هؤلاء العظماء الذين سكنت الدهشة عقولهم.
حياته وأعماله
- باحث من سورية.
- من مواليد حمص، 1941.
- مفكر وباحث سوري في الميثولوجيا وتاريخ الأديان كمدخل لفهم البعد الروحي عند الإنسان.
أهم أعماله
- كتاب التاو، إنجيل الحكمة التاوية في الصين.
- آرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراتي.
- الأسطورة والمعنى، دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية.
- جلجامش، ملحمة الرافدين الخالدة.
- دين الإنسان، بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني.
- الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم، هل جاءت التوراة من جزيرة العرب.
- لغز عشتار، الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة.
- مغامرة العقل الأولى، دراسة في الأسطورة، سورية وبلاد الرافدين.
- طريق إخوان الصفاء- المدخل إلى الغنوصية الإسلامية.
ويشرف على تحرير موسوعة تاريخ الأديان وقد صدر منها حتى الآن أربعة مجلدات.
من الترجمات
- توماس ل. تومبسون (تحرير): أورشليم.
- القدس بين التوراة والتاريخ ، مؤسسة دراسات الوحدة العربية، بيروت 2003.
صدرت له المؤلفات التالية (بالإنكليزية)
كتاب مشترك مع توماس ل. تومبسون، وكيث وايتلام، وفيليب ديفز، ومرغريت شتاينر، وعدد من أهم المؤرخين وعلماء الآثار في أوروبا والولايات المتحدة. الكتاب من تحرير توماس تومبسون، تحت عنوان: Jerusalem in History and tradition.
أعمال صدرت عن دار علاء الدين في دمشق (بالعربية)
- مدخل إلى نصوص الشرق القديم.
- الوجه الآخر للمسيح، موقف يسوع من اليهود واليهودية وإله العهد القديم.
- تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود.
- الرحمن والشيطان، الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ في الديانات المشرقية.
مقالات للكاتب
- من هو إله يسوع؟
- يأجوج ومأجوج/هاروت وماروت، بين القرآن والتوراة.
- خفايا إنجيل مرقس.
- قصة سقوط الإنسان بين القرآن والتوراة.
- أهل الكهف بين الأدب السرياني والقرآن.
- الملك داود بين التوراة والقرآن.
- ميلاد يسوع في الفكر اليهودي.
- النبيّ إلياس بين التوراة والقرآن.
- الأسطورة: كيف نفهم الأسطورة؟
- ألغاز الإنجيل.
أولاً: الأسطورة: أنماط التاريخ المقدس
في مقالات سابقة تحدثت عن المفهوم الديني للتاريخ والمفهوم الدنيوي. وفي هذه المقالة سوف أتحدث عن ثلاثة أنماط رئيسية للتاريخ المقدس، تتبدى في الفكر الديني للثقافات العليا.
ينطلق الفكر الديني في تصوره للبدايات من اللحظة التي خرجت عندها الألوهة من كمونها وتجلت في الزمان وفي المكان الدنيويين، مبتدئةً فعالياتها في الأزمنة الميثولوجية الأولى، عندما أطلقت الزمان ومدت المكان، وتواشجت مع تاريخ الكون وتاريخ الإنسان. فهنا تتحول الألوهة من مفهوم نظري إلى مفهوم عملي، وتتجلى في شخصية ذات إرادة وقصد وفعل، وفي إله يعلن عن نفسه في سياق زمني تاريخي، مبتدئاً تاريخاً مقدساً يشتمل على فعاليات الألوهة ومنعكساتها في العالم وفي المجتمع الإنساني.
وهنالك ثلاثة أنماط لصيرورة هذا التاريخ المقدس في الفكر الديني للثقافات العليا. النمط الأول هو التاريخ المفتوح، حيث يسير الزمن من لحظة البداية نحو مستقبل مفتوح بلا نهاية. والنمط الثاني هو التاريخ الدوري المتناوب، حيث يسير الزمن في دورات مغلقة يتبع بعضها بعضاً إلى ما لا نهاية، ومع اكتمال كل دورة ينهار الكون القديم ليبتدئ كون جديد مع انطلاق الدورة الثانية. والنمط الثالث هو التاريخ الدينامي الذي يتطور بشكل خطي منذ لحظة الخلق عبر عدد من المراحل إلى لحظة النهاية، حيث ينتهي التاريخ وتنفتح الأبدية.
يتصل بهذه المفاهيم الثلاثة للتاريخ ثلاثة أشكال اعتقادية في طبيعة الألوهة وعلاقتها بالعالم، وهي: المعتقد الربوبي، والمعتقد الألوهي، ومعتقد وحدة الوجود.
1- المعتقد الربوبي والتاريخ المفتوح:
يقوم المعتقد الربوبي على الفصل بين الألوهة وخلقها. فعلى الرغم من أن الإله (أو الآلهة) قد خلق العالم، إلا أنه مستقل عنه ومفارق له على كل صعيد؛ وعلى الرغم من أنه قد أسس في الزمان البدئي لجميع أسباب الحضارة الإنسانية ولجميع المؤسسات الكفيلة بوضع الإنسان على سكة التاريخ، إلا أنه لا يتدخل في مسار هذا التاريخ بشكل منهجي، وليس لديه خطة توجهه وفق مقاصد معينة ونحو أهداف بعيدة مرسومة؛ كما أنه لا يؤسس لصلة وحي دائمة بينه وبين خلقه. قد تتدخل المقدرة الإلهية في بعض الأحداث الجسام، أو تعلن عن حضورها في العالم من خلال الكوارث الطبيعانية كالطوفان أو الأعاصير، إلا أن مثل هذه التداخلات عرضية وهي لا تسير على خطة محكمة مسبقة، كما أنها لا تنتظم في تتابع يفصح عن رابطة بينها، ولا تنم عن تكَشُّفٍ تدريجي لمقاصد محددة.
وينجم عن مفارقة الألوهة واستقلالها عن خلقها، عدم اتصافها بالعدالة أو ممارستها على الأرض. من هنا فإن أعمال الفرد في الحياة الدنيا لا تلقى مكافأة أو عقاباً في حياة ثانية، ولا وجود لبعث أو حساب أو لعالم آخر أفضل من الأول. فالآلهة وحدها هي الخالدة، أما مصير البشر فإلى موت يتبعه وجود شبحي في العالم الأسفل المظلم الذي تؤول إليه أرواح الصالحين والطالحين على حد سواء. من هنا فإن العلاقة الطقسية هي الوسيلة الوحيدة للتواصل بين العالمين، فمن خلال الذبائح والقرابين يعمل الإنسان على استرضاء القوى العلوية، وحثها على تحقيق أغراضه الدنيوية، واتقاء غضبها غير المفهوم من قبله. وينجم عن ذلك أن الأخلاق هي شأن دنيوي تنظمه الجماعة الإنسانية ولا علاقة له بالآلهة.
تقدم لنا ديانات الشرق القديم النموذج الأمثل عن المعتقد الربوبي والتاريخ المفتوح على اللانهاية. فالإنسان قد خُلق منذ البداية لغرض واحد هو خدمة الآلهة، على ما يؤكده عدد من الأساطير البابلية، والعلاقة بين الطرفين تبقى أبداً علاقة السيد بالعبد. الآلهة خالدة أما الإنسان ففان، والخط الفاصل بين العالمين حاد وحاسم، ولا يعطي أملاً للإنسان حتى بمجرد التفكير بالخلاص من شرطه الأرضي والالتحاق بالعوالم القدسية بعد فناء جسده وانتهاء كدحه على الأرض. ولذا فإن أفضل ما يصبو إليه هو اللذائذ الحياتية الصغيرة خلال عمر قصير ينتهي به إلى العالم الأسفل. وهذا ما عبَّر عنه خطاب فتاة الحان إلى جلجامش الباحث عن الخلود عندما قالت له: «الحياة التي تبحث عنها لن تجدها، لأن الآلهة لما خلقت البشر جعلت الموت لهم نصيباً وحبست في أيديها الحياة. وأما أنت يا جلجامش فاملأ بطنك وافرح ليلك ونهارك. اجعل من كل يوم عيداً وارقص لاهياً في الليل وفي النهار. هذا نصيب البشر».
والآلهة الرافدينية تصنع الخير مثلما تصنع الشر أيضاً. ففي أسطورة الطوفان البابلية تقرر الآلهة إفناء البشر لغير سبب واضح. وفي نص هلاك مدينة أور السومرية، يقرر مجمع الآلهة تدمير مدينة أُور وإفناء أهلها قدراً من السماء وأمراً مقضياً. وفي ملحمة أتراحاسيس يتكاثر البشر وتزعج ضوضاؤهم الإله إنليل، فيضع خططاً شريرة لإنقاص عددهم حتى يخلد إلى الراحة، وعندما لا يفلح في ذلك يقرر إفناء بذرة الحياة على الأرض. إن عدم توصل الألوهة إلى حسم مسألة الخير والشر في سلوكها قد انعكس على علاقتها بعالم الإنسان. فالآلهة الرافدينية لم تكن أخلاقية من جهة، ولم تستن لعبادها شرائع أخلاقية يتبعونها، بل لقد تُرك المجتمع الإنساني ليدير شؤونه بنفسه، ويتعامل أفراده وفق اللوائح الأخلاقية المتعارف عليها منذ القدم، وكان حكماء المجتمع يعيدون صقل هذه اللوائح والتذكير بها في كل مناسبة.
ويتصل مفهوم العدالة بمفهوم الخير عند الآلهة. فإذا كانت الآلهة لا تقيم وزناً للخير في سلوكها مع الإنسان، ولا تطلب منه بذل الخير كعنصر لازم في العلاقة بينهما طالما أنه ملتزم بالطقوس والشعائر، فإنها ليست معنية بثواب الإنسان على حسناته وعقابه وعلى شروره وفق مرجعية أخلاقية سماوية، ناهيك عن عنايتها بخلاصه إلى عالم آخر يعوضه عن بؤس التاريخ وشقائه. أي أننا أمام مفهوم مفتوح للزمن دونما نهاية منظورة، فلا بعث ولا نشور ولا قيامة عامة للموتى.
2- معتقد وحدة الوجود والتاريخ الدوري:
يقف معتقد وحدة الوجود على الطرف النقيض من المعتقد الربوبي، فهو يقدم مفهوماً صوفياً عن العلاقة بين الله والإنسان يذيب الفوارق بينهما، لأن الروح الإنسانية هي قبس من روح الله الكلية، على الرغم من حجاب الجهل الذي يستر عنها هذه الحقيقة في الحياة الدنيا. وبالمقابل، فإن الله ليس شخصية محددة مفارقة للعالم تمارس تأثيرها عليه عن بُعد، بل هو الحقيقة الكلية التي تتمظهر في العالم وتختفي وراءه في آن معاً. فكما يظهر الماء تحت أشكال وأسماء متعددة، منها البخار والغيم والجليد والثلج والبرَد والرطوبة، بينما هو في حقيقة الأمر واحد، كذلك تتحول الألوهة إلى ما لا يحصى من الظواهر المادية والنفوس الحية، مع بقائها في جوهرها واحدة غير مجزأة. وكما صدرت هذه الأجزاء عن الحقيقة الواحدة، فإنها تعود إليها وتذوب فيها كما تذوب الأنهار في لجة البحر الذي صدرت عنه.
تقف الديانة الهندوسية باعتبارها الممثل الرئيسي في تاريخ الدين لمعتقد وحدة الوجود. والطوائف الهندوسية على تنوعها تشترك في عدد من الأفكار والمعتقدات الأساسية التي لا يصح دين الهندوسي بدونها. أول هذه المعتقدات وأهمها هو الإيمان بتناسخ الأرواح، يليه معتقد «الكارما» الذي يرتبط به أشد الارتباط. والكارما تعني في الأصل «الفعل»، ولكنها في السياق الإيديولوجي المعني هنا تعني الفعل وجزاؤه ثواباً كان أم عقاباً. على أن ما يميز فكرة الثواب والعقاب في الهندوسية عن نظيرتها في أديان الوحي الشرق أوسطية، هو أن الجزاء غير مفروض من قبل شخصية إلهية تتصف بالعدل، بل يتم بشكل أوتوماتيكي من خلال قانون الكارما الكوني الذي يعمل في استقلالية تامة عن أي شخصية إلهية. فما تراكمه الروح من كارما في تجسدها الحالي سوف يؤثر على سلسلة تناسخاتها التالية، إما صعوداً وارتقاءً أو رِدةً إلى أسفل سافلين. وهكذا تتابع الروح الفردية تجسداتها في دورة سببية أزلية لا تنتهي، تدعى بالسنسكريتية «سمسارا»، وهي دورة لا بداية لها ولا نهاية، تتجاوز عالم الإنسان لتطال عالم الظواهر المادية بأكمله. كل شيء واقع في إسار الزمن، والزمن نفسه عبارة عن عجلة تدور على نفسها، كلما بلغت دورة منتهاها عادت إلى نقطة البداية، دون أن تنشُد غاية أو تسعى إلى هدف. ومع ذلك فإن الانعتاق من هذه الدورة ممكن التحقيق، وهو بؤرة الحياة الدينية للهندوسي والنهاية التي يطمح إليها من كدحه الروحي.
يدعو الهنود دينهم بـ «الدهارما» الخالدة. وهذا التعبير يشير إلى القانون الأبدي الثابت الذي يحكم الكون برمته، وهذا القانون يعمل بطريقة أشبه ما تكون بطريقة عمل القوانين الطبيعية بالمفهوم العلمي الحديث، ولكن مع فارق هام وهو أن هذا القانون الهندوسي لا يقوم بذاته وإنما يستند إلى مستوى أعمق للوجود، هو الأرضية غير المتغيرة لكل عرض متغير، ويدعى «براهمن»: القاع التحتي غير المشخص للوجود، الذي صدر عنه الناس والآلهة ومظاهر الوجود طراً. ولبراهمن نفسٌ تدعى «أتمان» منبثة في جميع الكائنات الحية من آلهة وبشر وحيوانات. فالنفوس رغم تجزئتها الظاهرية وتباينها، هي في حقيقة الأمر نفس واحدة؛ وإلى هذه النفس الواحدة ترجع النفوس المنعتقة لتذوب فيها. إن ما يحقق للنفس هذا الانعتاق النهائي هو انكشاف بصيرتها الداخلية على حقيقة أن هذا العالم المتكثر هو واحد في جوهره، وأن كل ما في الوجود هو براهمن.
على الرغم من تسرب بعض أساطير الخلق والتكوين من الديانة الفيدية الأقدم، إلا أن الهندوسية، وعبر جميع أطوارها لم تأخذ مسألة الأصول والبدايات بشكل جدي. فالعالم لم يُخلق مرة واحدة، وليس له نهاية منظورة أو منقَلب يرتفع به من مستوى أدنى من الوجود إلى مستوى أعلى. فالزمن يدور على نفسه، ومع كل دورة يفنى الكون القديم ويُخلق كون جديد، فلا بداية ولا نهاية وإنما عَوْدٌ أبدي بلا هدف أو غاية. هذه الرؤية للزمن الدوري المتناوب في الهندوسية، تنطوي على إصرار شديد على رفض التاريخ باعتباره حركة دائبة تهدف إلى تحسين الكون وتطوير الجنس البشري، ولا ترى فيه إلا نسخاً يكرر بعضها بعضاً إلى ما لا نهاية. وبالتالي فلا وجود لخطة إلهية تتجلى في هذا التاريخ بشكل تدريجي، وتهدف إلى تخليص الكون وتخليص الإنسانية.
3- المعتقد الألوهي والتاريخ الدينامي:
يقع المعتقد الألوهي في نقطة الوسط بين المعتقد الربوبي ومعتقد وحدة الوجود. فالإله مفارق للعالم من جهة، ولكنه متصل به كل الاتصال من جهة ثانية. ذلك أن الحاجات الروحية الدفينة عند الإنسان تتطلب الإحساس بألوهة مشخصة يمكن الدخول معها في علاقة ثنائية، سواءً أكانت علاقة الأب بالابن، أو علاقة المحب بالمحبوب، أو علاقة السيد بالعبد. وهذه الألوهة على الرغم من مفارقتها واختلافها من حيث الطبيعة مع العالم، إلا أنها حاضرة فيه على الدوام، في كل هبة ريح وفي تفتح كل زهرة وفي تنفس كل كائن حي. وعل حد قول إخوان الصفا في الرسالة 39: «فوجود العالم عن الباري ليس كوجود الدار عن البَنَّاء، أو كوجود الكتاب عن الكاتب بعد فراغه من الكتابة، ذلك الوجود الثابت المستقل بذاته المستغني عن الكاتب بعد فراغه من الكتابة، وعن البنَّاء بعد فراغه من أبنية الدار؛ ولكن كوجود الكلام عن المتكلم الذي إن سكت بطل وجود الكلام. فالكلام يكون موجوداً مادام المتكلم به يتكلم، ومتى سكت بطل وجوده؛ أو كوجود نور السراج في الهواء، فما دام السراج باقياً فالنور باق موجود، أو كوجود ضوء الشمس في الجو فإذا غابت الشمس بطل وجود الضوء من الجو».
إن الله في حالة انغماس دائم في مسائل العالم، ويبذل عناية لا تني من أجل تطويره في الزمن وفي التاريخ نحو غاية منظورة على الرغم من كونه خارج التاريخ. فمن خلال فعاليات الألوهة في الزمن والتاريخ تتخذ وجه الإله المشخص، ومن خلال محافظتها على موقعها المفارق خارج التاريخ تحافظ الألوهة على طبيعتها الغفلة وغير المشخصة مما تؤمن به عقيدة وحدة الوجود. ويستدعي اتصال الله بالعالم تحويل مفهوم العدالة الأوتوماتيكي الذي يعمل من خلال مبدأ الكارما في عقيدة وحدة الوجود، إلى صفة من صفات الله، فالله عادل، وكما تتجلى عدالته على المستوى الكوني في النظام المتوازن الدقيق الذي يحكم عالم المادة والطبيعة، كذلك تتجلى عدالته على المستوى الاجتماعي في النظام الأخلاقي الذي يحكم علاقات الأفراد والجماعات. هذه العدالة هي أهم التجليات لصفة الخير عند الله. وتؤدي عدالة الله وخيره إلى مطلبه الأساسي من الناس الالتزام بحياة أخلاقية، وهذا يستدعي بدوره الثواب والعقاب، سواء عند نهاية حياة الفرد أم مع نهاية الزمن والبعث العام والحساب الأخير. فالتاريخ من هذا المنظور ذو طبيعة دينامية يسير عبر عدة مراحل نحو نهاية محتومة ينتهي عندها زمن الناس وتنفتح بوابة الأبدية في وجود روحاني لا يشبه في شيء الوجود المادي السابق. وكل ذلك يجري وفق خطة خلاصية أعدها الله منذ البداية.
يظهر مفهوم التاريخ الدينامي لأول مرة في تاريخ الدين في المعتقد الزرادشتي (القرن السادس قبل الميلاد) ففي البدء لم يكن سوى الله الذي دعاه زرادشت «أهورا مزدا». ثم صدر عن الله روحان توأمان هما «سبيتنا ماينيو» و«أنجرا ماينيو»، أعطاهما الله منذ البداية خصيصة الحرية، فاختار سبيتنا ماينيو الخير واختار أنجرا ماينيو الشر. ولقد قرر الله السير بخطته التي تقوم على الحرية إلى آخرها، فعمد بمشاركة الروح المقدس سبيتنا ماينيو إلى إظهار ستة كائنات روحانية إلى الوجود تدعى بالأميشا سبيتنا يستعين بها على مقاومة الروح الخبيث أنجرا ماينيو. وقد شارك هؤلاء في ما تلا ذلك من أعمال الخلق والتكوين وإظهار العالم المادي إلى الوجود. ثم إن هؤلاء أظهروا إلى الوجود عدداً من الكائنات الروحانية الطيبة تدعى بالأهورا، وراح الجميع يكافح الشر كل في مجاله. وبالمقابل فقد استنهض أنجرا ماينيو عدداً من القوى الروحانية المدعوة بالديفا وعمل على ضلالتها فانحازت إلى جانبه وراح الجميع يهاجمون خلق الله الطيب الحسن ويعملون على إفساده. وبذلك ظهر لاهوت الملائكة والشياطين لأول مرة في تاريخ الدين.
يسير التاريخ في الزرادشتية عبر ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى هي مرحلة الخلق الحسن والطيب عندما كان العالم خيراً كله، والمرحلة الثانية هي امتزاج الخير بالشر عندما عدى الشيطان على خلق الله ولوثه، والمرحلة الثالثة هي الفصل بين الخير والشر ودحر الشيطان ورهطه. وهنا يتم تطهير العالم القديم ليعود كاملاً وطيباً إلى الأبد ويأتي التاريخ إلى نهايته بمعونة الإنسان الذي ساهم في مكافحة قوى الشر من خلال وعيه وحريته وخياره الأخلاقي.
ثانياً: الديانة الزرادشتية وميلاد الشيطان
لم تكتمل ملامح الشيطان الكوني في تاريخ الدين الإنساني إلا مع الديانة الزرادشتية التي أسسها النبي زرادشت في زمن غير مؤكد من النصف الأول للألف الأول قبل الميلاد. ولد زرادشت في إحدى المناطق الإيرانية النائية عن مركز الحضارة. وعلى ما تقوله النصوص المقدسة الزرادشتية، فإن مظاهر الطبيعة كلها احتفلت بولادته، وحدثت سلسلة من المعجزات التي رافقت هذا الحدث المهم في تاريخ الكون والإنسانية؛ أما الشيطان فقد هرب واختبأ، ثم ما لبث أن أرسل زبانيته لإهلاك الرضيع، فلما اقتربوا منه تكلم في المهد ونطق بصلاة لله طردت الشياطين. وعندما شب على الطوق جاء الشيطان ليجربه وعرض عليه أن يعطيه سلطاناً على الأرض كلها مقابل تخليه عن المهمة التي كان يعد نفسه لها، ولكن زرادشت نهره وأبعده عنه.
انخرط زرادشت منذ يفاعته في سلك الكهنوت، وصار كاهناً على دين قومه. غير أن هذا الكاهن ما لبث أن انشق على المعتقدات التقليدية، وأحدث انقلاباً كان له أعمق الأثر في الحياة الروحية لإيران وللإنسانية على حد سواء، عندما جاءه وحي النبوة وهو في سن الثلاثين. فبينما كان الكاهن الشاب يشارك في إحدى المناسبات الطقسية، دعت الحاجة إلى بعض الماء، فتطوع زرادشت لجلبه ومضى إلى النهر القريب؛ وبينما هو يملأ قربته تجلى له على الضفة كائن نوراني، فخاف منه وحاول الفرار، ولكن الكائن طمأنه وكشف له عن هويته قائلاً بأنه ملاك من عند الله، وأنه واحد من الكائنات الروحانية الستة التي تحيط بالإله الواحد وتعكس مجده. ثم أخذ بيده وعرج به إلى السماء حيث مَثَلَ في حضرة أهورا مزدا، وهو الاسم الذي يطلقه زرادشت على الله، وتلقى منه الرسالة التي يتوجب عليه إبلاغها للناس.
العقيدة:
يتميز المعتقد الزرادشتي بابتكاره لأكثر التفسيرات منطقية لوجود الشر في العالم. ففي البدء لم يكن سوى الله (أهورا مزدا)، وجود كامل وتام، وألوهة قائمة بذاتها مكتفية بنفسها. ولكن هذه الألوهة اختارت أن تخرج من كمونها وتُظهر ما عداها إلى الوجود، فكان أول خلقها روحان توأمان ها سبينتا ماينيو وأنجرا ماينيو. ولكي يكون لهذين الروحين وجود حقيقي مستقل عن خالقهما، فقد منح لهما خصيصة الحرية. وبداعٍ من هذه الحرية المطلقة فقد اختار سبينتا ماينيو الخير ودُعي بالروح القدس، واختار أنجرا ماينيو الشر ودُعي بالروح الخبيث. بعد هذا الخيار الأخلاقي للتوأمين، كان لا بد من تصادمهما ودخولهما في صراع مفتوح. على الرغم من أن الله كان قادراً منذ البداية على سحق أنجرا ماينيو ومحو الشر في مهده، إلا أنه آثر عدم التناقض مع نفسه بالقضاء على مبدأ الحرية الذي أقره، والسير بخطته التي تقوم على مقاومة الشر استناداً إلى ذات المبدأ الذي أنتج الشر. وهنا عمد بمعونة الروح القدس سبينتا ماينيو إلى خلق ستة كائنات روحانية قدسية شكلت بطانته الخاصة التي تحيط به على الدوام، ويُدعَون بالأميشا سبينتا أي الخالدون المقدسون. وقد أوجدهم الله من روحه كمن يشعل الشموع من مشعل متقد. ثم إن هؤلاء أظهروا إلى الوجود بالطريقة نفسها عدداً كبيراً من الكائنات القدسية الطيبة هم الآهوريون، فعهد إليهم الرب بمهمة مكافحة الشر كل في مجاله. وبالمقابل فإن أنجرا ماينيو أظهر إلى الوجود عدداً كبيراً من الكائنات الروحانية المتفوقة هم الديفا، فراحوا يساعدونه في تخريب كل عمل طيب يصدر عن الله. وبذلك تم تشكيل عالم الملائكة وعالم الشياطين قبل خلق العالم المادي.
بعد أن تأسس الشر على المستوى الروحاني، عرف أهورا مزدا أن القضاء على الشيطان وأتباعه لن يتيسر قبل خلق العالم المادي، لأن عالم المادة سيكون بمثابة المسرح المناسب للصراع بين جند الحق وجند الباطل، ولسوف يعمد أنجرا ماينيو إلى مهاجمة خلق الله بكل ما أوتي من قوة، لأنه خلقٌ حسن وطيب وكامل، ولكن هذا الهجوم سوف يفُتُّ في عضد الشيطان تدريجياً حتى يفقد قوته وسلطانه في آخر الأمر، ويُحسم الصراع لصالح الخير عند نهاية التاريخ. ولقد خلق أهورا مزدا العالم على ست مراحل زمنية (تعادل الأيام الستة في المعتقدات المشرقية اللاحقة). في البداية خلق السماء من صخر كريستالي، ثم خلق الماء، فالأرض، فالحياة النباتية، فالحياة الحيوانية، وأخيراً خلق الإنسان الأول. بعد انتهاء أهورا مزدا من خلق الكون انقض عليه أنجرا ماينيو بكل قوته، فغطس في البحر ولوثه بالملح، وتوجه إلى الينابيع فجففها، وإلى الخضرة فأذبلها، ونشر الصحارى وبث فيها الأفاعي والعقارب وكل دابة مؤذية، وعمد إلى النار فلوثها بالدخان، ودخل في عقل آدم وحواء المدعوين هنا «ماشيا» و«ماشو» وزرع فيه النقائص الأخلاقية. ولكن الأميشا سبينتا تصدوا له ولجنده، ودخلوا معهم في صراع لا هوادة فيه. هذا الصراع لن يكون له نتائج إيجابية إلا بعون الإنسان، الذي يتوجب عليه أن يعي مسؤولياته الخلقية ويدعم قوى الخير بفكره وقوله وعمله.
وعلى هذا، فإن التاريخ يسعى بشكل دينامي إلى نهايته عبر ثلاث مراحل؛ فلقد خلق أهورا مزدا العالم في أكمل وأطيب صورة ممكنة، واستمر على هذه الحالة ردحاً من الزمن كان الشيطان خلاله نائماً، وهذه هي المرحلة الأولى مرحلة الخلق الكامل التي يسود فيها الخير. في المرحلة الثانية يهاجم الشيطان خلق الله فيمتزج الخير بالشر. في المرحلة الثالثة تبدأ عملية الفصل بين الخير والشر، وتنتهي بدحر الشيطان وعودة العالم إلى ما كان عليه في البداية. ولقد ابتدأت مرحلة الفصل هذه بميلاد زرادشت، وسوف تنتهي بظهور مخلَّص العالم المدعو ساوشيانط، الذي سيقود المعركة الأخيرة الفاصلة بين قوى النور وقوى الظلام. سوف يولد المخلِّص من عذراء تحمل به عندما تنزل للاستحمام في بحيرة كانا سافا، حيث تتسرب إلى رحمها بذور زرادشت التي حفظها هناك الملائكة إلى هذا اليوم الموعود.
يرتبط معتقد نهاية التاريخ ارتباطاً وثيقاً بمعتقد البعث والحساب والحياة الثانية. فبعد أن يودَع الميت في القبر، تمكث روحه عند رأسه ثلاثة أيام تتأمل في حسناتها وسيئاتها. وخلال ذلك يزورها ملائكة الرحمة ويواسونها إذا كانت من الأرواح الصالحة، أو ملائكة العذاب الذين يذيقونها عذاب القبر إذا كانت من الأرواح الشريرة. وفي اليوم الرابع تُساق الروح إلى جلسة الحساب، فتمثُل أمام ميترا قاضي العالم الآخر الذي يقف خلف ميزان الحساب، وعن يمينه وشماله مساعداه اللذان يقومان بوزن أعمال الميت، فيضعان حسناته في إحدى الكفتين وسيئاته في الكفة الأخرى، ليتوجه بعد ذلك إلى الفردوس أو إلى الجحيم عبر طريق يدعى بصراط المصير، وهو عبارة عن جسر يتسع أمام الروح الطيبة فتسير عليه الهوينى إلى الجهة الأخرى حيث بوابة الفردوس، ولكنه يضيق أمام الروح الشريرة فتتعثر وتسقط لتتلقفها نار الجحيم. يتألف الجحيم من عدة طبقات يقع أسفلها في مركز الأرض، وكل طبقة تستقبل أهلها حسب فداحة ذنوبهم وتقدم لهم من صنوف العذاب ما يوازيها. أما السماء فتتصاعد على ثلاثة درجات تنتهي بالسماء العليا المدعوة نمارو ديمانا، أي مسكن الغناء، وهناك تقيم الروح في بَرَكة وسلام إلى يوم القيامة.
مع ظهور المخلص تحل الأيام الأخيرة وتقترب الساعة. يوم تلفظ الأرض ما أُتخمت به من عظام الموتى، ويُفرغ الجحيم والفردوس من سكانهما ليعودوا إلى الحشر العظيم، حيث يلتقي من مات منذ آلاف السنين بمن بقي حياً إلى يوم الدينونة. عند ذلك يسلط الملائكة ناراً على الأرض تذيب معادن الجبال وتشكل نهراً من السائل الناري يرده الجميع، فأما الأحياء فيعبرونه كمن يخوض في نهر حليب دافئ، وأما الأشرار فينجرفون في التيار الذي يفنيهم ويمحو عن الأرض أثرهم بعد عذاب أليم. وفي ذلك الوقت يكون جند الظلام قد اندحروا في المعركة الفاصلة مع جند النور واستؤصلت شأفتهم، فيغوص نهر النار إلى أعماق الجحيم حيث لجأ الشيطان أنجرا ماينيو ومن بقي معه، فيلتهمهم جميعاً ويتم التخلص من آخر بقايا الشر. كما أن الجحيم نفسه يتطهر مثلما تطهرت بقية أجزاء الكون، ويغدو إقليماً من أقاليم الأرض الزاهرة، التي تحولت إلى جنة يسكنها الصالحون خالدين فيها أبداً.
العبادات:
كانت الديانة الأصلية التي أسس لها زرادشت ديانة بسيطة ولا تعتمد إلا القليل من الطقوس. فلقد دعا زرادشت أتباعه إلى خمس صلوات في اليوم، تقام عند الفجر والظهيرة والعصر والمغرب ومنتصف الليل. وتتخذ صلاتا الظهيرة ومنتصف الليل أهمية خاصة، لأن منتصف النهار هو الوقت الذي تكون فيه قوى النور في ذروة سيطرتها على العالم، أما منتصف الليل فهو الوقت الذي تكون فيه قوى الظلام في ذروة فعالياتها، فيقوم المؤمنون لإيقاد النار دعماً لقوى النور. ولترتيل الصلوات. وتسبق الصلاة عملية الوضوء التي تتضمن غسل الوجه واليدين والقدمين. بعد ذلك يقف المصلي منتصباً مسبل الذراعين في حضرة أهورا مزدا، ويتلو في صلاته مقاطع خاصة من أناشيد الغاثا القديمة المنسوبة إلى زرادشت.
تتجلى بساطة الديانة الأصلية في غياب المعابد والهياكل والمذابح. وزرادشت نفسه لم يعنَ بتشييد أماكن خاصة للعبادة، لأن الله موجود في كل مكان ويمكن التوجه إليه في أي مكان طاهر. كما منع النبي صنع الصور والمنحوتات لأهورا مزدا وبقية الكائنات القدسية؛ لذا فقد خلت المراكز الحضرية للمملكة الأخمينية من المعابد الضخمة، وكانت الصلوات تقام في البيوت أو في أماكن مفرزة للعبادة في الهواء الطلق مزودة بموقد للنار المقدسة. ولكن الملك أردشير الثاني الذي حكم بين عامي 485- 425 ق.م، خرج على هذه التقاليد وكان أول من بنى المعابد الضخمة على الطريقة البابلية وزينها بصور للكائنات السماوية. ولكن فريقاً من الكهنة عارضوا هذا الإجراء وردوا عليه بإقامة معابد تتصدرها شعلة النار المقدسة بدلاً من تماثيل الآلهة، وبذلك ظهرت لأول مرة معابد النار في إيران، وأخذ أهل الديانات الأخرى يصفون الزرادشتيين بأنهم عبدة النار، في الوقت الذي لم تكن النار بالنسبة إليهم إلا رمزاً للألوهة المطلقة الخافية. ومع ظهور معابد النار نشأت طبقة جديدة من الكهان المتفرغين لطقوس النار عُرفت تاريخياً باسم ماجي، وباللغة اليونانية ماجوس التي استمدت منها التسمية العربية مجوس.
الواجب الخلقي:
على الإنسان أن يُعنى بأخيه الإنسان وببقية مخلوقات الأرض، لأنهم جميعاً صنعة الله الواحد. وعليه أن يرعى جسده وروحه في آنٍ معاً؛ وتتحقق رعاية الجسد من اتباع الفرد لقواعد النظافة والصحة العامة، والاعتدال في المأكل والمشرب وتجنب الإفراط في كل شيء؛ أما رعاية الروح فتتحقق من اتباع النظام الأخلاقي السليم الذي يتلخص في ثلاثة عناصر هي: 1- الفكر الحسن، فلا يتداول الفرد في عقله إلا الأفكار الطيبة ويُبعد عنه الأفكار الخبيثة. 2- القول الحسن، فلا يصدر عنه سوى الكلام الطيب. 3- العمل الحسن الذي يفيد به نفسه وأسرته ومجتمعه، ولا يبادر إلى أذية أي مخلوق. من خلال هذه الأخلاق يستطيع الإنسان أن يكافح الشر ويساعد القوى الإلهية الخيرة على دحر الشيطان ورهطه.
طقوس الموت:
تقوم طقوس الموت في الزرادشتية على نظرة النبي إلى الموت باعتباره ناتجاً من نواتج فعاليات الشيطان في العالم. فأجساد الأحياء تنتمي إلى أهورا مزدا، بينما تنتمي جثث الموتى إلى الشيطان. إن لمس أي جثة هو مصدر للنجاسة، وعلى من احتك بها أن يطهر نفسه بالماء؛ كما أن أي جزء مقتطع من الجسم الحي مثل قصاصات الأظافر أو قصاصات الشعر هو جزء ميت ويجب عدم الاحتكاك به. وجميع الحيوانات التي تتغذى على الجثث من النمل والذباب والكلاب والضباع وما إليها، هي حيوانات نجسة يجب قتلها أينما وجدت. من هنا فقد خضعت عملية دفن الموتى إلى طقوس خاصة يقوم بها اختصاصيون يعرفون كيف يطهرون أنفسهم بعدها. فقد كانت جثة الميت تسجى على مصطبة حجرية في منطقة نائية أو في سفح جبل، ولا يسمح لها بالاحتكاك بتربة الأرض كيلا تلوثها، وهناك تترك مكشوفة حتى تتحلل بالعوامل الطبيعية أو انقضاض الجوارح عليها. وبعد فترة كافية لتحلل الجسد تدفن العظام تحت التراب انتظاراً لبعثها في يوم القيامة.
قواعد الطهارة:
لم تضاه الزرادشتية قبلها أو بعدها ملَّة في الحفاظ على طهارة الجسم والمأكل والمشرب. ويأتي حرص الزرادشتي المبالغ به على النظافة من اعتقاده بأن الفساد والتحلل والعفونة وكل أنواع القذارة هي من عمل الشيطان. من هنا فإن النظافة والبُعد عن الاحتكاك بكل ما هو قذر وملوث هو شأن يعادل الصلاة والعمل الطيب، لأن في التزام قواعد الطهارة محاربة لقوى الشيطان. وبذلك يستطيع الإنسان المساهمة في محاربة الشر الكوني من خلال أدائه لأصغر واجباته اليومية.
التطور التاريخي:
بقيت تعاليم زرادشت التي بثها في أناشيد الغاثا لفترة طويلة بمثابة الإنجيل الذي يحفظ جوهر الدين ويجمع المؤمنين حول العقيدة. ولكن لغة هذه الأناشيد صارت قديمة بمرور الزمن، ودعا أسلوبها البليغ المختصر الكهنة إلى التوسط من أجل تبسيط أفكارها وشرحها للناس. وقد تراكمت هذه الشروحات تدريجياً حتى شكلت مصدراً آخر من مصادر الديانة الزرادشتية، وجُمعت تحت اسم الأفيستا؛ ثم تطلبت هذه المجموعة من الشروحات بدورها الشرح والتفسير فنشأ على هامشها كتاب الزند أفيستا، أي شرح وتعليق على الأفيستا. وقد لعب المجوس دوراً مهماً في تحرير وتطوير الأفيستا، ولكنهم أدخلوا تعديلات مهمة على أفكار زرادشت الأصلية، فبنوا لاهوتاً متكاملاً عن مجمع الملائكة ومجمع الشياطين، فصارت الملائكة التي تعمل تحت إمرة سبينتا ماينيو تُعد بالآلاف، وكذلك الشياطين التي تعمل تحت إمرة أنجرا ماينيو. كما تحولت الأميشا سبينتا من قوى مجردة وغير مشخصة إلى كائنات إلهية لكل منها وظيفة محددة في نظام الكون والطبيعة، وصارت فروض العبادة والتقديس تقدم إليها بما هي كذلك. كما أدخل المجوس على العقيدة الأصلية تعديلاً جذرياً انحرف بها عن فكر زرادشت، عندما جعلوا أنجرا ماينيو يقف على قدم المساواة مع أهورا مزدا، ونظروا إليهما كخصمين متصارعين منذ البدء؛ وبذلك تحول أهورا مزدا من إله يسمو فوق الروحين البدئيين المتنافسين إلى طرف مباشر في الثنوية الكونية.
وفي عقيدة الزورفانية التي طورها فريق من المجوس، صار أهورا مزدا وأنجرا ماينيو (الذي يتخذ هنا اسم أهريمان) ابنين توأمين للإله الأعلى المدعو زورفان، أي الزمن. وقد عهد زورفان إلى أهورا مزدا بمهمة خلق العالم ليغدو مسرحاً للصراع المكشوف بين قوى الخير وقوى الشر، وحدد لصراعهما ردحاً معيناً من الزمن ينتهي بغلبة أهورا مزدا على خصمه أهريمان؛ وبقي بمثابة العلة الأولى والإطار الذي تجري ضمنه أحداث الكون. وقد تحولت هذه العقيدة من هرطقة تعيش على هامش زرادشتية الأفيستا إلى دين رسمي للدولة في عهد الأسرة الساسانية، حيث تحولت الزرادشتية في المراحل المتأخرة للتاريخ الإيراني القديم من ديانة عالمية تتوجه إلى جميع بني البشر إلى ديانة قومية خاصة بإيران. وهذا ما أضعف موقف الزرادشتية تجاه الديانات العالمية اللاحقة وهي المانوية والمسيحية والإسلام.
من كتاب «الرحمن والشيطان»
الثنوية الكونية:
الثنوية الكونية هي معتقد تم تطويره في ارتباط مع معتقد التوحيد وذلك في المنطقة الشرقية. وقد نشأ معتقد التوحيد عن معتقد وحدانية العبادة السابق عليها، والذي يقوم على عبادة إله واحد والإخلاص له من دون بقية الآلهة التي لا ينكر وجودها. كما نشأت وحدانية العبادة بدورها عن الوثنية التعددية التي تقوم على عبادة مجمع للآلهة مؤلف من مراتبية هرمية للقوى الإلهية، تقدم لها جميعاً فروض العبادة، لكل ما يناسب مقامه وأهمية القوة الطبيعانية التي يمثلها بالنسبة إلى حياة الجماعة.
يمكن تعريف الثنوية الكونية بأنها المعتقد الذي يقوم على مبدأين متناقضين وراء مظاهر الوجود وصيرورة الزمن والتاريخ، وهذان المبدآن يتصارعان من أجل أن يلغي أحدهما الآخر. وصراعهما يدفع عجلة الزمن نحو نهاية محتومة عبر ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى: مرحلة العصر الذهبي للخليقة قبل أن يتعدى الشر على الخير.
المرحلة الثانية: مرحلة امتزاج الخير بالشر.
المرحلة الثالثة: هي مرحلة الفصل بين الخير والشر والقضاء نهائياً على قوى الشر لكي يعود العالم طيباً نقياً كما كان.
يمكن تقسيم المعتقدات الثنوية إلى ثلاث فئات: الثنوية المطلقة ـــ الثنوية الجذرية ـــ الثنوية المعتدلة.
تقول الثنوية المطلقة بوجود مبدأين أزليين مستقلين ومتعارضين، لكل منهما عالمه وسلطانه المطلق على ذلك العالم، فعالم للروح وللنور الأزلي، وعالم للمادة وللظلمة الأزلية. وعندما دخلت الظلمة في نسيج النور كان لا بد من الفصل بينهما مجدداً وهذا هو معتقد المانوية.
أما الثنوية الجذرية فتقول بوجود مبدأين متساويين في القيمة النسبية وفي علاقتهما بالوجود. ولكن هذين المبدأين ليسا أزليين بل حادثين ومتولدين عن الإله الأزلي الواحد القديم، وهما في صراع دائم. وهذا هو معتقد الزرادشتية.
وأما الثنوية المعتدلة فتقول بمبدأ واحد، وأصل واحد قديم وأزلي وهو إله الأنوار الأعلى. ثم إن هذا الإله الأعلى قد خلق إلهاً أدنى منه مرتبة قام بدوره بخلق العالم المادي. فالمادة شر بطبيعتها، إذ لا يمكن لإله الخير أن يخلق الشر. وهذا أساس المعتقدات الغنوصية على تعدد فرقها واختلاف مذاهبها.
ويشكل المعتقدان المسيحي والإسلامي ثنوية خاصة بهما يمكن أن ندعوهما بالثنوية الأخلاقية. ذلك إن التناقض بين الله والشيطان لا يطال كل الوجود، وإنما يقتصر على الإنسان والمجتمعات الإنسانية.
والشيطان لا سلطة فعلية له إلا على النفس الإنسانية يعمل على إفسادها وحرفها عن طرق الله. فالثنوية هنا شكلية لا أساسية. فالعالم خلق من أجل الإنسان، فهو خليفة الله على الأرض وسيدها. من هنا، فإن سلطة الشيطان على الإنسان هي نوع من المشاركة في السلطة على العالم، خصوصاً في المعتقد المسيحي حيث نجد إنجيل يوحنا يدعو الشيطان برئيس هذا العالم، ويدعوه بولس الرسول بإله هذا الدهر.
لكي يتضح مفهوم الثنوية، لا بد من التمييز بينه وبين مفهوم القطبية الذي لا يتضمن معنى الصراع أكثر مما يتضمن معنى التكامل والتعاون. فالقطبية هي معتقد يقول بوجود ثنائية أصلية قوامها قطبان متعارضان ومتناقضان في كل شيء، ولكنهما في الوقت نفسه متعاونان ولا قيام لأحدهما بدون الآخر، وعن تناقضهما وتعاونهما تنشأ مظاهر الوجود المادي والحيوي وبهما تستمر.
إن النموذج الأكمل عن معتقد القطبية هو التاوية الصينية التي وضع أسسها المعلم لاو تسو في القرن السادس قبل الميلاد وذلك بوجود مبدأ أزلي قديم يدعى التاو، والتاو ليس شخصية إلهية بل هو القاع الكلي للوجود، والحقيقة المطلقة التي يقوم بها كل نسبي، وعن هذا المبدأ الكلي صدرت قوتان مجردتان، هما قوة اليانغ الموجبة والين السالبة، وبدوران هاتين القوتين نشأت الآلاف المؤلفة. تمثل قوة اليانغ باللون الأبيض الذي يرمز إلى النور، وقوة الين باللون الأسود الذي يرمز إلى الظلام، والظلام لا يحمل أي دلالة أخلاقية، ولا فضل لواحدهما على الآخر. وإن أحدهما لا يسعى للتغلب على الآخر، لأن هذا التغلب يعود بالكون إلى حالة الهيولى التي نشأ عنها.
في الديانات الشرقية نجد أشكالاً من المعتقدات الثنائية التي تنتمي إلى القطبية لا إلى الثنوية. ونموذج هذه الثنائيات عبادات الخصب الكنعانية التي مثلت الخصب والجفاف في شخصيتين إلهيتين هما بعل وموت. فالإله بعل هو المتحكم بأسباب الخصب والحياة، والإله موت هو المتحكم بأسباب الجفاف والموت. و تصور الأسطورة الأوغاريتية هذين الإلهين في حالة صراع دائم لا يحسم لصالح واحد منهما، فكلما سقط بعل صريعاً بعث بعد فترة إلى الحياة ودعا موت إلى النزال، وكلما وقع موت صريعاً قام إلى جولة ثانية وتحدى بعل.
إن هذا الصراع يرمز إلى تناوب الفصول ودورات الخصب والجفاف، وما الصراع الشكلي إلا من قبيل تناوب اليانغ والين في التاوية. ثم إن تناقض هذين القطبين لا ينطوي على دلالة أخلاقية، لأن موت ليس مبدأ للشر الأخلاقي، والإله بعل ليس مبدأ للخير الأخلاقي، ثم إن هذين الإلهين يتمتعان بالمكانة ذاتها في البانثيون الأوغاريتي، وتقدم إليهما فروض العبادة على قدم المساواة.
إن الفيضانات المدمرة والزلازل والبراكين والأعاصير هي شرور طبيعانية. وأما القتل العمد والاغتصاب والسرقة والظلم والكذب، فشرور أخلاقية تنجم عن العلاقات الاجتماعية. وبتعبير آخر فإن الشر الطبيعاني ينجم عن ظواهر فيزيائية بينما ينجم الشر الأخلاقي عن نقائص إنسانية. فصانع الشر على مستوى الطبيعة ليس بالضرورة حافزاً للشر على مستوى الحياة الإنسانية. كما أن صانع الخير على مستوى الطبيعة ليس بالضرورة راعياً للخير وباعثاً له في النفس الإنسانية. لهذا كله، فقد بقيت الأخلاق في المعتقدات القديمة شأناً اجتماعياً تحكمه قوانين المجتمعات الداخلية، ولم تتصل بالدين إلا في فترات متأخرة نسبياً من تاريخ الدين، وخصوصاً مع ظهور المعتقدات الثنوية التي طابقت بين الخير الطبيعاني والخير الأخلاقي وأرجعتهما إلى مصدر واحد، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالشر الطبيعاني والشر الأخلاقي.
إلا أن المعتقدات الثنوية تختلف في موقفها من هذه المسألة. فالثنوية الزرادشتية تعزو كل شر طبيعاني وأخلاقي إلى الشيطان، وكل خير طبيعاني وأخلاقي إلى الله. والثنوية الغنوصية ترى أن العالم كله شر لأنه ينتمي إلى المادة، وما الخير إلا المعرفة التي تعين الروح الإنسانية على التعرف إلى أصلها النوراني الأعلى، وبذلك يتم خلاصها واتصالها بأصلها مجدداً. وهنا لا تكتسب الأخلاق والسلوك القويم في الحياة أية قيمة خلاصية مباشرة، ولكنها تهيئ النفس في التناسخات المقبلة إلى المعرفة المخلّصة. فإذا جئنا إلى الثنوية الأخلاقية وجدناها تعزو الشر والخير الطبيعانيين إلى الله، لأن الشيطان لا يملك سلطاناً على مظاهر الكون والطبيعة. وليس ما يبدو من شر على المستوى الطبيعاني إلا تعبيراً عن غضب الله وعقابه، وكذلك ما يبدو من خير، فهو رضى من الله ونعمة لعباده. فالخير والشر الطبيعانيان هما أداتان في يد الخالق يستخدمهما وفق قصد إلهي قد يبدو للناس وقد يخفى عليهم.
إن هذه التصورات تخدم في النهاية مفهوماً فلسفياً وجودياً يدور حول حرية الفرد في الاختيار: اختيار ما هو عليه واختيار مصيره، وحرية الإنسان في رسم مستقبله. فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يخضع لجبرية الطبيعة، ولا تنجم أفعاله بالضرورة عن حتمية السبب والنتيجة مما يسود في عالم المادة. ذلك إن روحه هي قبس من عالم الروح الأسمى وعالم الحرية الإلهية، وليس شقاؤه في التاريخ إلا اختباراً لصلابة هذه الروح وامتحاناً لجدارتها بالحرية ولقدرتها على التغلب على جبرية المادة. ولسوف تبرر النتائج التي ستنجلي عنها نهاية الزمن كل بؤس التاريخ ووطأته.
من كتاب «مـغامرة العـقل الأولى»
جهد الإنسان دوماً في كشف حقيقة العالم والحياة وكانت وسيلته لمعرفة العالم مرتبطة بالمرحلة التاريخية لتطوره نفسياً وعقلياً، حيث اعتقد في البداية أن العالم بكل مظاهره المتنوعة يخضع لترابطات وقوانين وقواعد معينة، وأن معرفته بتلك الترابطات تساعده في السيطرة على الطبيعة المحيطة وإخضاعها لرغباته ومصالحه، فهو يستطيع مثلاً استجلاب الأمطار والقضاء على الأعداء ودفع الكوارث الطبيعية ....إلخ. وقد تجمعت لديه عبر القرون مجموعة من القواعد الذهبية التي تؤلف في مجموعها سفراَ متكاملاَ للسحر، ولم يكن الإنسان في ممارسته تلك يستعين بأي قوى خارقة أو إلهية من أي نوع بسبب إيمانه المطلق بأن تتابع الأحداث يخضع لقانون معين هو جزء أصيل من الطبيعة ذاتها لا خارجاً عنها ومتعالياً عليها.
ولكن الإنسان وبعد تاريخ طويل مليء بالمرارة والفشل في السيطرة على الطبيعة بواسطة السحر، اتجه إلى الدين مفترضاَ أن الكون ما هو إلا تبدٍ ماديٌ للطاقات الإلهية ومظهرا لفعاليتها وقواها المستمرة. فظهر الدين وتطور بشقيه: الشق الأول اعتقادي يستخدم الأسطورة أداة للمعرفة والكشف والفهم. الشق الثاني طقسي يستهدف استرضاء الآلهة والتعبد لها. فالأسطورة هي التفكير في القوى البدئية الفاعلة، الغائبة وراء هذا المظهر المتبدي للعالم وكيفية عملها وتأثيرها وترابطها مع عالمنا وحياتنا. إنها أسلوب في المعرفة والتوصل للحقائق والأداة الأقدم للتفكير الإنساني المبدع.
ولكن الأسطورة تهاوت بعد ذلك تحت مطارق الفلسفة، وتجرع سقراط السم جزاء اجترائه على آلهة اليونان، ومن بعده تابع أفلاطون وأرسطو المهمة. وتعاونت مع الفلسفة الديانتان المسيحية والإسلامية، ثم أدى تبلور المناهج العلمية في العصور الحديثة إلى ازدراء كامل للأسطورة بوصفها حكاية مسلية تتنافى مع التفكير العلمي السليم.
إلا أن القرن التاسع عشر في أوروبا جلب معه ثورة فنية وجمالية أعادت للأسطورة رونقها كشكل فني تعبيري من أشكال الفلكلور والأدب الشعبي، واعتبرها الرومانتيكيون أصلاً للفن والدين والتاريخ، ثم اتجهت العلوم الحديثة لتبحث خلف الشكل الظاهر للأسطورة عن الرموز الكامنة والمعاني العميقة التي تحتويها، فظهر فرع جديد من فروع المعرفة يعني بدراسة وتفسير الأساطير دعي بالميثولوجيا، وظهرت مدراس مختلفة تهدف إلى تفسير الأسطورة وبيان دلالاتها وبواعثها ووظيفتها ولعل أهم تلك المدراس تتمثل فيما يلي:
1- الأسطورة باعتبارها فناً أدبياً وحكمة:
ينظر هذا الاتجاه للأسطورة على أنها تراكم لنتاج الفكر الإنساني المبدع في مجال الأدب وأنها تعبر عن طابع فني وفكري وأدبي لكل شعب من الشعوب.
2- الأسطورة وظواهر الطبيعة:
يرجع هذا الاتجاه كل الأساطير إلى منشأ طبيعي يتصل بعناصر الطبيعة. فكثير من الأساطير كان باعثها القمر أو الشمس أو السماء الصافية ومظاهر الطبيعة الأخرى كالصواعق والرعود والبروق.
3- الأسطورة والإيتيولوجيا:
الإيتيولوجيا هي دراسة الأسباب. وقد وجدت الأسطورة لتقديم الأسباب الكامنة وراء كثير من الظواهر التي يراها الإنسان في العالم الواقعي. مثلاً هناك أسطورة فلبينية ترى أن تنوع ألوان العروق البشرية راجع إلى ساعة الخلق عندما وضع الإله الخالق حفنة من طين في الفرن لصنع الإنسان. ففي المرة الأولى أخرج الإله الطين قبل نضجه فكان الإنسان الأبيض، وفي المرة الثانية تأخر في إخراجه فاحترق فكان الإنسان الأسود، وفي المرة الثالثة أخذ الطين كفايته من الشي فخرج الإنسان الفلبيني البرونزي.
4- الأسطورة باعتبارها تاريخاً:
وفق هذا الاتجاه فالأسطورة ليست نتاج الخيال المجرد بل ترجمة لملاحظات واقعية ورصد لحوادث جارية. وعبرها انتقلت إلينا تجارب الأولين وخبراتهم المباشرة. وهي تعود في أصولها إلى أزمان سحيقة سابقة للتاريخ المكتوب. فقبل أن يتعلم الإنسان الكتابة كانت ذاكرته على قدر كبير من الحيوية، وقد استخدمها لنقل الأحداث بأمانة عبر الأجيال.
5- الأسطورة والطقس:
أسس هذا الاتجاه رائد الأسطورة الحديثة السير جيمس فريزر. حيث يرى أن الأسطورة قد استمدت من الطقوس، فبعد مرور زمن طويل على ممارسة طقس معين وفقدان الاتصال مع الأجيال التي أسسته، يبدو الطقس خالياً من المعنى ومن السبب والغاية وتخلق الحاجة لإعطاء تفسير له وتبرير. وهنا تأتي الأسطورة لإعطاء تبرير لطقس مبجل قديم، لا يريد أصحابه نبذه أو التخلي عنه.
6- الأسطورة والذرائعية:
أسس هذا الاتجاه عالم الأنتروبولوجيا الشهير مالينوفسكي، حيث يرى أن الأسطورة لم تظهر استجابة لدافع المعرفة والبحث، ولا علاقة لها بالطقس أو البواعث النفسية الكامنة، بل هي تنتمي للعالم الواقعي وتهدف إلى تحقيق نهاية عملية، فهي تروى لترسيخ عادات قبيلة معينة أو لتدعيم سلطة عشيرة أو نظام اجتماعي.
7- الأسطورة والكبت ــ فرويد:
حيث يرى فرويد في كتابه «تفسير الأحلام»، تشابهاً في آلية عمل كل من الحلم والأسطورة، وتشابه الرموز لكليهما، فهما نتاج العمليات النفسية اللاشعورية. ففي الأسطورة كما في الحلم، نجد الأحداث تقع خارج قيود وحدود الزمان والمكان. فالبطل في الأسطورة كما هي حال صاحب الحلم، يخضع لتحولات سحرية ويقوم بأفعال خارقة، هي انعكاس لرغبات وأمانٍ مكبوتة، تنطلق من عقالها بعيداً عن رقابة العقل الواعي الذي يمارس دور الحارس على بوابة اللاشعور. فالأسطورة ملأى بالرموز والتي إن فسرت، زودتنا بفهم عميق لنفس الإنسان الخافية ورغباته المكبوتة.
8- الأسطورة والنماذج البدئية ــ يونغ:
كان يونغ من أكثر تلامذة فرويد اهتماماً بالأسطورة، وتعمقاً في دراستها وتعويلاً على أهميتها وعمقها وبعد دلالتها. وهو يقتفي أثر فرويد في النظر للأسطورة كنتاج للاشعور، ولكنه يفترق عنه جذرياً عندما يقرر أن اللاشعور الذي تنتج عنه الأسطورة هو اللاشعور الجمعي للبشر وهو يناقض نظرية فرويد القائلة بأن الأسطورة والحلم إنما يشفان عن مكنونات العناصر المكبوتة في لا شعور الفرد وأنها نوع من التعويض عن رغبات لم يتم إرضاؤها بشكل حقيقي.
9- اللغة المنسية ــ أريك فروم:
قدم فروم في كتابه «اللغة المنسية» دراسة عميقة للأسطورة، منطلقاً أيضاً من فكرة فرويد عن العلاقة بين الحلم والأسطورة، مع مخالفته في النظر للأسطورة والحلم على أنهما نتاج العالم اللاعقلاني. فالعقل في حالة الحلم إنما يعمل ويفكر ولكن بطريقة أخرى ولغة أخرى، ولغة الرمز هي اللغة التي تنطق عن الخبرات والمشاعر والأفكار الباطنة كما تنطق لغتنا المحكية عن خبرات الواقع، مع فارق هام يكمن في شمولية لغة الرمز وعالميتها وتجاوزها لفوارق الزمن والثقافة والجنس. والأسطورة كما الحلم، تكمن أهميتها في تقديمها حكايا تشرح بلغة الرمز، حشداً من الأفكار الدينية والفلسفية والأخلاقية، وما علينا سوى أن نفهم مفردات تلك اللغة لينفتح أمامنا عالم مليء بمعارف غنية وثرية.
10- الأسطورة ــ مغامرة العقل الأولى:
تتعلق برؤيتنا الخاصة للأسطورة (رؤية فراس السواح)، فعندما حيرت الإنسان مظاهر الطبيعة المختلفة وأخذ يطرح أسئلة عن معنى وجوده وحياته وموته، كان عليه أن يبدأ مغامرة كبرى مع الكون وقفزة أولى نحو المعرفة، فكانت الأسطورة. فالأسطورة نظام فكري متكامل استوعب قلق الإنسان الوجودي وتوقه الأبدي لكشف الغوامض التي يطرحها محيطه، إنها رسم لوحة متكاملة للوجود.
والأسطورة حكاية مقدسة يلعب أدوارها الآلهة وأنصاف الآلهة، أحداثها ليست مصنوعة أو متخيلة، بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدسة، إنها سجل أفعال الآلهة، تلك الأفعال التي أخرجت الكون من لجة العماء، ووطدت نظام كل شيء قائم. والأسطورة حكاية مقدسة تقليدية بمعنى أنها تنتقل من جيل إلى جيل بالرواية الشفهية، وهي الأداة الأقوى في التثقيف والتطبيع، والقناة التي ترسخ ثقافة ما عبرها وجودها واستمرارها عبر الأجيال، إنها نص أدبي وضع في أبهى حلة فنية ممكنة.
ويمتزج تعبير الأسطورة في أذهان الكثيرين بتعبير «الخرافة» و«الحكاية الشعبية»، رغم البعد الشاسع بين هذه النتاجات الفكرية الثلاث. فالخرافة هي حكاية بطولية ملأى بالمبالغات والخوارق ولكن أبطالها الرئيسيين هم من البشر أو الجن ولا دور للآلهة فيها. أما الحكاية الشعبية فهي كالخرافة لا تحمل طابع القداسة ولا تلعب الآلهة أدوارها فيها كما أنها لا تتطرق - كما هو شأن الأسطورة - إلى موضوعات الحياة الكبرى وقضايا الإنسان المصيرية، بل تقف عند حدود الحياة اليومية والأمور الدنيوية العادية.
التكوين السـومري:
ازدهرت الثقافة السومرية في الجزء الأسفل من حوض دجلة والفرات وحول الشواطئ العليا للخليج العربي، منذ مطلع الألف الرابع قبل الميلاد. وقد كان للثقافة السومرية تأثير كبير على ثقافة الشرق القديم، فهي أعطت المنطقة الخط المسماري وطورت مبادئ دينية وروحية ظلت سائدة لفترة طويلة من الزمن ووصل تأثيرها إلى الثقافة الإغريقية في الفترات المتأخرة جداً. وهي التي وضعت أولى الملاحم الشعرية وأولى التراتيل الدينية وأولى التشريعات والقوانين والتنظيمات المدنية والسياسية، وباختصار فإن التاريخ يبدأ مع سومر.
لم تكن أفكار السومريين عن الخلق والتكوين أفكاراَ بدائية، بل أفكاراً ناضجة بالدرجة التي تتيحها معارف تلك الفترة من بداية حضارة الإنسان. وإن دراسة النصوص الأسطورية المتفرقة تعطينا التسلسل الأسطوري التالي لعملية خلق العالم والأكوان:
1. في البدء كانت الإلهة «نمو» ولا أحد معها. وهي المياه الأولى التي انبثق عنها كل شيء.
2. أنجبت الإلهة «نمو» ولداً وبنتاً. الأول «آن» إله السماء المذكر، والثانية «كي» إلهة الأرض المؤنثة، وكانا ملتصقين مع بعضهما وغير منفصلين عن أمهما «نمو».
3. تزوج «آن» و«كي» فأنجبا «إنليل» إله الهواء الذي كان بينهما في مساحة لا تسمح له بالحركة.
4. لم يطق «إنليل» ذلك السجن، فقام بقوته الخارقة بإبعاد أبيه «آن» عن أمه «كي»، رفع الأول فصار سماءً، وبسط الثانية فصارت أرضاً، ومضى يرتع بينهما. ولكن «إنليل» كان يعيش في ظلام دامس فأنجب ابنه «نانا» إله القمر، فيبدد الظلام في السماء وينير الأرض.
5. أنجب «نانا» إله القمر بعد ذلك «أوتو» إله الشمس.
6. وبعد أن أبعدت السماء عن الأرض، وصدر ضوء القمر الخافت، وضوء الشمس الدافئ، قام «إنليل» مع بقية الآلهة بخلق مظاهر الحياة الأخرى.
التكوين البابلي:
تتوضع أفكار البابليين في الخلق والتكوين، بشكلها الأكمل في ملحمة التكوين البابلية المعروفة باسم «الإينوما إيليش» واسم الملحمة مأخوذ من الكلمات الافتتاحية للنص، فإينوما إيليش تعني: «عندما في الأعالي». فعندما في الأعالي لم يكن هناك سماء، وفي الأسفل لم يكن هناك أرض، لم يكن في الوجود سوى المياه الأولى ممثلة في ثلاثة آلهة: «أبسو»، «تعامة»، و«ممو». فأبسو هو الماء العذب، وتعامة زوجته كانت الماء المالح، وممو هو الضباب المنتشر فوق تلك المياه المتلاطمة والناشئ عنها. هذه الكتلة المائية الأولى كانت تملأ الكون، وانبثقت عنها بقية الآلهة والموجودات، وكانت آلهتها الثلاثة تعيش في حالة سرمدية من السكون والصمت المطلق ممتزجة ببعضها البعض في حالة هيولية. ثم أخذت هذه الآلهة بالتناسل فولد لأبسو وتعامة إلهان جديدان هما «لخمو» و«لخامو»، وهذان بدورهما أنجبا «إنشار» و«كيشار» واللذين أنجبا بدورهما بعد ذلك «آنو» وهو الذي صار فيما بعد إله السماء. وآنو بدوره أنجب «إنكي» أو «إيا»، وهو إله الحكمة والفطنة والذي غدا فيما بعد إله المياه الباطنية وبلغ حداً من القوة والهيبة جعلته يسود حتى على آبائه.
وهكذا امتلأت أعماق الآلهة تعامة بالآلهة الجديدة المليئة بالحيوية والشباب والحركة الدائمة مما أنتج وضعاً جديداً لم تألفه آلهة السكون البدئية التي حاولت السيطرة على الموقف واستيعاب نشاط الآلهة الجديدة ولكن عبثاً، الأمر الذي دفعها للجوء إلى العنف، فقام أبسو بوضع خطة لإبادة النسل الجديد والعودة للنوم مرة أخرى. وباشر بتنفيذ خطته برغم معارضة تعامة التي ما زالت تكن بعض عواطف الأمومة. وعندما علم الآلهة الشباب بمخطط أبسو اضطربوا ولم يخلصهم من حيرتهم سوى أشدهم وأعقلهم وهو الإله إيا (إنكي) الذي وضع حلقة سحرية حول رفاقه تحميهم من بطش الآباء، ثم صنع تعويذة سحرية ألقاها على أبسو الذي راح في سبات عميق. كما نزع عن أبسو اللقب الإلهي وأسبغه على نفسه وذبحه وبنى فوقه مسكناً لنفسه، كما انقض إنكي على الإله ممو (الضباب المنتشر فوق المياه) وسحقه وخرم أنفه بحبل يجره وراءه أينما ذهب. وبعد هذه الأحداث الجسام ولد الإله «مردوخ» (ابن إنكي) أعظم آلهة بابل، الذي أنقذهم مرة أخرى من بطش الآلهة القديمة ورفع نفسه سيداً للمجمع المقدس. وكما كان الإنقاذ الأول على يد الأب إنكي، جاء الإنقاذ الثاني على يد الابن الشاب مردوخ. فتعامة التي تركت زوجها أبسو لمصيره المحزن دون أن تهرع لمساعدته وهو يُذبح على يد الآلهة الصغيرة، تجد نفسها الآن مقتنعة بضرورة السير على نفس الطريق، لأن الآلهة الصغيرة لم تغير مسلكها، وهنا اجتمعت الآلهة القديمة وحرضت تعامة على حرب الآلهة الشباب المتمردين على التقاليد الكونية، فوافقت تعامة وجهزت جيشاً قوامه أحد عشر نوعاً من الكائنات الغريبة، وجعلت عليهم الإله «كينغو» قائداً بعد أن اختارته زوجاً.
ارتعب الآلهة الشبان من جيش تعامة، وطلبوا من الإله إنكي أن ينقذهم هذه المرة كما أنقذهم في المرة الأولى، ولكن إنكي كان عاجزاً هذه المرة، فأرسلوا في طلب الإله مردوخ، الفتى القوي الذي أعطته الآلهة قوة تقرير المصائر وأعطوه قوة الكلمة الخالقة، ومضى مردوخ لقتال تعامة فانتصر عليها وعلى قائد جيشها كينغو وتمزق جيشه شر تمزيق. وبعد هذا الانتصار على قوة السكون والسلب والفوضى، التفت مردوخ لبناء الكون وتنظيمه وإخراجه من حالة الهيولى الأولى إلى حالة النظام والترتيب، حالة الحركة الفعلية والحضارة. ثم عاد مردوخ إلى جثة تعامة فشقها شقين، رفع النصف الأول فصارت سماء وسوى النصف الثاني فصارت أرضاً، ثم خلق النجوم وصنع الشمس والقمر. ثم خلق الإنسان من دماء الإله السجين كينغو، ونظم الآلهة في فريقين: الأول في السماء وهم «الأنوناكي»، والثاني جعله في الأرض وما تحتها وهم «الأيجيجي».
وبعد الانتهاء من عملية الخلق يجتمع الإله مردوخ مع بقية الآلهة ويحتفلون بتتويجه سيداً للكون، فبنوا مدينة بابل ورفعوا له في وسطها معبداً تناطح ذروته السحاب هو معبد الإيزاجيلا، وفي الاحتفال المهيب أعلنوا أسماء مردوخ الخمسين.
خاتمة
اجتذبت الفلسفة فراس السواح في بداياته المعرفية، وقرأ فيها حتى توصّل إلى أن حكمة البشر وثقافاتهم لا تجسدها الفلسفة، بل الأسطورة والدين. فالفلسفة هي نتاج فكري لشخص بعينه، سواء كان ديكارت أم كانط أم هيغل أم ابن رشد؛ أما الدين فيمثل حكمة ثقافة بأكملها. فإذا أردنا فهم الإنسان علينا أن نفهم أدبياته الدينية قبل أدبياته الفلسفية. فعندما كان السواح يقرأ الأسطورة كان يقرأ الدين، فالدين الإنساني، دين الإنسان والدين مؤلف من ثلاث مكونات: المعتقد، الطقس، الأسطورة. فلا يوجد دين بدون معتقد، ولا يوجد دين بدون أسطورة، أي حكاية مقدسة، ولا يوجد دين بدون طقس. فالأسطورة هي مكون أساسي من مكونات الدين ومن هنا تأتي قداستها. وبنظر السواح لا يوجد دين توحيدي ودين وثني، بل هناك دين للإنسان. وقد تمّ التعبير عن الموقف الديني للإنسان بأشكال مختلفة، ولكن الدين واحد. وإن دين الإنسان في العصر الحجري هو دين المسلم اليوم بشكل أو بآخر، اختلفت التجربة، اختلفت البيئة، اختلفت المرحلة، لكن هذا الدين دين واحد.
إن فراس السواح، مؤرخاً مخلصاً للحقيقة، يعي أن علم التاريخ هو أكثر العلوم انقياداً للأهواء الشخصية وللإيديولوجيات القومية والدينية. غير أن ما وصلتْ إليه مناهجُ البحث التاريخي وتقنياتُ التنقيب الأثري من تطور وتقدم إبان القرن العشرين قد ضيَّق، إلى حدٍّ كبير، الهامش المتاح أمام الباحث المغرِض، المتلون بالأهواء والإيديولوجيات.
وكما قلت في المقدمة فإن فراس السواح مسكونٌ بالدهشة وحب السؤال، لذلك جاءت أسئلته على صورة الراهن، فأسئلته وإن بدت مغلفة ببعد أكاديمي رفيع أو تبدت متخصصة ودرسية، فإن أسئلة الحاضر هي ما يشغله ويشف تماماً من وراء أي صفحة من صفحات كتبه. وهو يستعين في محاولته الإجابة عن هذه الأسئلة بمنهج صارم يعتمد على آليتين، فهو يرى أن في دراسة أية ظاهرة ثقافية هنالك نوعان من المحاكمة: الأولى تُدعى محاكمة وجود، والثانية تُدعى محاكمة قيمة. في المحاكمة الأولى يقوم الدارس بتقصِّي طبيعة موضوعه وتقديمها وفقاً لما تبدتْ له ظواهرُها، من غير تقييمها وإصدار الأحكام عليها، أما في المحاكمة الثانية فيبحث في أهميتها وجدواها ويصدر حكم قيمة عليها. وهو يحاول تبني محاكمة الوجود لا محاكمة القيمة، أو كما يقول: «لا أنطلق من موقف إيديولوجي معيَّن، ولا أسعى إلى الترويج لفكر معين. ما يهمني، بالدرجة الأولى، هو إرجاع القارئ إلى نفسه، وقد صار مسلّحاً بزاد يساعده على التفكير الحرِّ المستقل وتشكيل مواقفه الخاصة. أنا لست مهتماً بإقناع القارئ، بل بتحريره من كلِّ ما يعطِّل ملَكات المحاكمة الحرة لديه. إن خلاصات أيِّ مؤلَّف من مؤلفاتي ونتائجه ليست وقفاً عليَّ، بل على القراء الذين يتلقونه ويناقشونه، يختلفون معه أو يتفقون. فالكتاب، برأيي، محرِّض، لا ملِّقن؛ والكاتب هنا أشبه بمعلِّم السباحة، لا بالنوتي الذي يعبر بالناس إلى الضفة الأخرى.
أما الآلية الثانية التي يستعين بها فهي طريقة عرض الفكرة. إن نصف جهده الذهني – كما يصرح - ينصبُّ على الفكرة، بينما باقي المجهود ينصبُّ على أسلوب التوصيل إلى القارئ، في أبسط شكل ممكن وفي أوضح صيغة متاحة. إن فراس السواح جزء من تلك النخبة التي تنبذ الانتماءات العقائدية البغيضة، وتؤسس لثقافة جديدة تليق بالإنسان.
إن في تكريم فراس السواح انتصار للثقافة الوطنية وثقافة الإبداع والتجديد، لا ثقافة الاطمئنان والترداد، ثقافة الخلق لا ثقافة المرايا، ثقافة الحياة لا ثقافة الموت.
أنهي حديثي عن فراس السواح بكلمات المعلم الكبير لاو تسو: «المعلم لا يكتنز شيئاً، ورغم أنه أعطى الآخرين كل ما لديه، فإن لديه الكثير أيضاً».
المراجع
- الرحمن والشيطان.
- طريق إخوان الصفا.
- مغامرة العقل الأولى.
- آرام دمشق وإسرائيل.
- الأسطورة والمعنى.
- المقدمة وحياة المفكر وأعماله والخاتمة ومقالاته من المواقع الالكترونية.
إعداد: أسعد طرابية ومروان رضوان
اكتشف سورية