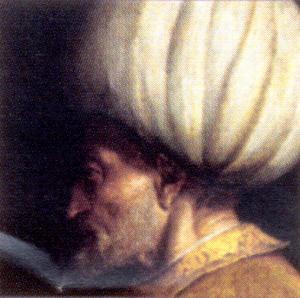سورية في العهد العثماني
دخل العثمانيون إلى سورية في أعقاب هزيمة المماليك بمعركة مرج دابق سنة 1616م بقيادة السلطان سليم الأول وسيطروا على حلب، ثم اتجهوا جنوباً فسيطروا على باقي بلاد الشام ليتوالى من بعدها خضوع كامل البلاد العربية باستثناء ما يعرف اليوم بالمملكة المغربية.
ظلت بلاد الشام طوال أربعة قرون، وسورية من جملتها، خاضعة للدولة العثمانية، ويمكن التمييز في تلك الفترة ما بين حقبتين لكل منهما خصائصها التي تتميز بها من الأخرى.
أما الحقبة الأولى فتبدأ مع بداية القرن السادس عشر، وتنتهي مع نهاية القرن الثامن عشر، لتبدأ الثانية من بداية القرن التاسع عشر وتنتهي بجلاء العثمانيين عن الأقطار العربية مع نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918م.
يتميز العصر الأول، وهو عصر قوة الدولة إلى حد ما، بفرض النظام الجديد الذي جاء به العثمانيون بحيث أبقوا البلاد على التقسيمات الإدارية التي كانت معروفة في العهد المملوكي. فكانت هناك ولاية حلب، ويتبعها ثمانية صناجق، وولاية دمشق ويتبعها تسعة صناجق، وولاية طرابلس ويتبع لها سبعة صناجق، ثم استحدثت ولاية صيدا فيما بعد بسبب تطور الأوضاع السياسية والاجتماعية والأحداث الداخلية التي طرأت على المنطقة فيما بعد.
كان جان بردي الغزالي، الذي خان مليكه قانصوه الغوري في معركة مرج دابق، أول والٍ على سورية، وأول من ثار على السلطان العثماني من الولاة، وبسبب تمرده وانقلابه على السلطان قسمت سورية إلى ثلاث ولايات لتسهل السيطرة عليها، وخوفاً من أن تجتمع بإمكاناتها بيد وال واحد.
سادت فترة من الهدوء في بلاد الشام بشكل عام لأكثر من نصف قرن، وكان جميع الولاة الذين تداولوا السلطة من كبار الشخصيات والوزراء العثمانيين الأكفاء، الأمر الذي مكنهم من ممارسة الحكم على النحو الذي تحقق فيه عامل الاستقرار، وقد ترافق وجود هذا النموذج من الولاة مع وجود سلاطين كبار، كالسلطان سليم وابنه السلطان سليمان المعروف بالقانوني، فلا عجب أن وصلت الدولة في هذا العصر إلى أوج مجدها. غير أن بوادر الضعف وأحداث الشغب وما تخللها من عسف وجور الولاة والموظفين بدأت تظهر من بعد وفاة السلطان سليمان القانوني، واعتلاء عرش السلطة من قبل سلاطين غير مؤهلين، كان لعزلتهم خلف أسوار القصور وانشغالهم بالملذات أثر كبير في فساد المؤسسات وانحطاط مستوى الجيش، مما نتج عنه أعمال عنف وتمرد بين صفوف العساكر والأمراء المحليين، بلغت ذروتها في بلاد الشام عند نهاية النصف الأول من القرن السابع عشر، كثورة علي باشا جانبلاط في جهات كلّس شمال حلب، وثورة فخر الدين المعني في جنوبي سورية.
في القرن الثامن عشر ظهر جيل جديد من الولاة والموظفين حظيت غالبيتهم بحماية الصدر الأعظم والكزلار آغا في مقر السلطنة، كآل العظم الذين تشير أغلب المصادر إلى أن أصلهم من معرة النعمان، وأول من ظهر منهم إسماعيل باشا العظم، ثم أخوه سليمان، ثم أسعد بن إسماعيل الذي بلغت الأسرة في عهده ذروة نفوذها في بلاد الشام، وفي الوقت الذي كان فيه هؤلاء ولاة على دمشق كان هناك عدد آخر من أبنائهم يديرون دفة الحكم في المناطق الأخرى، فإبراهيم بن إسماعيل كان والياً على طرابلس، وياسين بك بن إبراهيم كان حاكماً في اللاذقية، في حين كان أسعد في عهد أبيه نائباً على حماة والمعرة، وهكذا كما لو أن بلاد الشام كانت محكومة وراثياً من قبل أفراد هذه الأسرة. ويبدو أن القضاء على تمرد الخارجين على سلطان الدولة، سواء من قبل بعض طوائف الجند كالدلاتية والزرباوات، أم من هجمات البدو التي كانت تستهدف طرق التجارة وقوافل الحج، إضافة إلى إتباع سياسة التوازن بين مختلف القوى المحلية في الولاية الواحدة، كانت كلها عوامل استقرار جعلت سلاطين الدولة العثمانية يفضلون أفراد هذه الأسرة على غيرهم لإدارة أمر البلاد، بصرف النظر عما لحق بهم من عسف وجور مع المصادرة والعزل في كثير من الأحيان.
تعرضت البلاد عند نهاية القرن الثامن عشر إلى فوضى بسبب الصراع على النفوذ من قبل بعض الأسر، وفي الوقت نفسه تعرضت البلاد الشامية إلى كوارث ومجاعات وأوبئة ساعدت على تنامي هذه الاضطرابات التي انتهت باحتلال دمشق من قبل علي بك المملوكي، ومن بعده أحمد باشا الذي استمر والياً على الشام لعدة فترات، كان السلطان في أثنائها راضياً عن أدائه، لقدرته على إخضاع المتمردين، وبقي أحمد باشا سيد الموقف في بلاد الشام حتى مجيء نابليون إلى مصر ومحاولة سيطرته على الشام سنة 1799م.
لم يطرأ في هذه المرحلة تعيير جوهري في نظم البلاد أو الطريقة التي كانت تُدار بها، ولعل مردّ ذلك إلى أن ثمة هامشاً من الحرية في الإدارة جعلت الوالي يتمتع ببعض الصلاحيات لإدارة الولاية، فكان الحكم أقرب إلى اللامركزية، وأميل إلى البساطة والمحافظة. أما ما له صلة بالأنشطة الحضارية فيبدو أن الجهود كانت منصبة على الاهتمام بالجيش، لاعتقاد السلاطين أنه العنصر الأساس في مواجهة الأخطار المحتملة، في حين أن المستوى العلمي كان أدنى مما كان عليه في العهود السابقة، إلا من بعض المدارس التي أنشئت في كبريات المدن كدمشق وحلب، وهي ذات طابع ديني بحت، ولكن كان اهتمام الولاة الأكثر بالمنشآت العمرانية التي لا يزال قسم كبير منها باقياً على اليوم، كالتكايا والمساجد والخانات المنتشرة بكثرة في كل من دمشق وحلب على وجه الخصوص.
تعرّض المشرق العربي في مستهل الفترة الثانية من الحكم العثماني، إلى أحداث هزت الدولة العثمانية، أولها بروز الدعوة الوهابية وإقامة دولتها التي وحدت أقاليم الجزيرة العربية في ظل الأسرة السعودية والثاني بداية الزحف الاستعماري نحو البلاد العربية، والذي استهله نابليون بونابرت بحملته على مصر وبلاد الشام، أما الثالث فهو محاولة محمد علي باشا والي مصر تأسيس دولة قادرة على حماية نفسها، بعد أن فقد الثقة بقدرة العثمانيين على حماية ممتلكات دولتهم، هذه الأحداث كان لها دور مؤثر في تغيير عقلية الإنسان في المشرق العربي، وجعلته يصحو من رقاده ليتحمل مسؤولية الدفاع عن الأرض والإنسان والثقافة إزاء الأخطار التي بدت تلوح في الأفق، مع وصول طلائق القوى الاستعمارية التي راودتها، على ما يبدو، فكرة العودة إلى النمط الروماني القديم.
كانت ولاية دمشق من وجهة نظر محمد علي لا تقل أهمية عن ولاية مصر، فالبلدان يتمم كل منهما الآخر من الناحيتين العسكرية والاقتصادية، ومن أجل قطع الطريق على خصومه وأعدائه كان يرى ألاّ مناص من امتلاكهما، وقد واتته الفرصة حينما استغل فرار بعض الفلاحين إلى عكا، فوجه قواته إليها ودخلها سنة 1832م، وتابع تقدمه بسرعة إلى دمشق التي استقبلته منقذاً ومحرراً، وبموجب صلح، كوتاهية، أصبحت ولاية الشام خاضعة لإدارة محمد علي طوال حياته، وعلى الفور بدأ بسلسلة من الإصلاحات كإلغاء الضرائب عن السلع التجارية، وتحسين ظروف المزارعين، وأصبح في وسع التجار والصناع الاطمئنان إلى سلامة أموالهم، ونتيجة لهذه السياسة، فقد تطور الاقتصاد تطوراً ملحوظاً، وانتعشت بسببه المدن السورية، وتعززت الثقة في نفوس الأهالي.
أما على الصعيد العلمي فقد شملت الإصلاحات قطاع التعليم وأنشئت المدارس الابتدائية في المناطق والنواحي، والمدارس الثانوية في مراكز المدن كـدمشق وأنطاكية وحلب، على النظام نفسه الذي كان سائداً في مصر، وأُقرت القوانين التي كانت تلزم الطلاب بارتداء أزياء خاصة بهم، وشيدت أبنية سكنية ملحقة بالمدارس لإيواء الوافدين إليها من الطلبة، واشتملت المناهج على تدريس المواد الهادفة إلى غرس الوعي القومي في نفوس الدارسين، الأمر الذي جسد فكرة الانتماء القومي إلى الأمة العربية عند غالبية المثقفين العرب مع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
ولعل أهم ما تميزت به سنوات الوحدة ما بين مصر وسورية في عهد محمد علي، مظاهر التسامح الديني ما بين مختلف الطوائف، وإلغاء القيوم التي كان «باشاوات» العهود السابقة قد فرضوها على غير المسلمين من باب تأكيد فكرة المواطنة بين الجميع.
أما من الناحية الإدارية فقد اعتبرت بلاد الشام ولاية واحدة، قسمت إلى ألوية عاصمتها جميعاً دمشق، وقد أبدى كثير من القناصل الغربيين إعجابهم الشديد بما فعله محمد علي خلال فترة الوحدة.
كانت الدول الغربية تراقب ما يجري في بلاد الشام عن كثب، ولم تكن لترضى عن الوضع السياسي الجديد، وخاصة إذا كان من أهدافه قيام دولة قوية تجمع ما بين مصر الإفريقية وسورية الآسيوية، مما أفسد على هذه الدول خططها في إطار ما اصطلح على تسميته «بالمسألة الشرقية»، ومع أن هذه الدول كانت على خلافات مستمرة على تدويل المسألة السورية، وتوجهت إلى محمد علي بإنذار تطلب فيه الانسحاب من سورية في غضون عشرة أيام، واستنفرت بالوقت نفسه عن طريق عملائها بعض الجهات للانقلاب عليه مستغلة مسألة التجنيد الإجباري الذي كان قد فرضه إبراهيم باشا على السوريين، وقضية جمع الأسلحة من الأهالي، وتحت وطأة التمرد والعصيان من جانب الأهالي، والضربات التي وجهتها القوات الحليفة بعد نفاد مدة الإنذار، انهارت المقاومة المصرية في الشام وارتدت نحو مصر سنة 1840م، وقضي على أول تجربة وحدوية ما بين سورية ومصر في العصر الحديث، كان من شأنها أن تنقل البلدين إلى مصاف الدول المتقدمة.
تعرضت سورية منذ منتصف القرن التاسع عشر، وبالتحديد بعد انهيار مشروع الوحدة، إلى عدة أحداث، أبرزها إثارة الفتن الطائفية في دمشق، وبعض الثورات في جبل حوران كثورة 1851م، التي منيت فيها القوات العثمانية بخسائر كبيرة، وثورات عشائر البدو في قرى ونواحي دير الزور، وكان للقناصل الغربيين دور كبير في إثارتها، ولا أدل على ذلك من الدور الخطير الذي قام سفيرا بريطانيا وفرنسا في إثارة الفتنة ما بين الدروز والموارنة في لبنان، والتي امتد لهيبها إلى دمشق وتصدى لها الأمير عبد القادر الجزائري وكبار العلماء والوجهاء.
تعاقب على ولاية سورية في هذه الفترة عدد من الولاة العثمانيين ترك بعضهم أثاراً حسنة منهم: محمد رشد باشا1863-1866م ومحمد راشد باشا 1866-1871م الذي امتدحه القنصل الإنكليزي المقيم في دمشق بقوله: «في حدود معرفتي لا يوجد والٍ غادر سورية وكان الأسف عليه عاما كهذا الوالي».
ويعد مدحت باشا من أبرز ولاة هذه المرحلة، وكثيراً ما كان يعرب عن ضيقه وتأففه من تدخلات القنصلين الفرنسي والإنكليزي بالشأن الداخلي بحجة حماية الطوائف السورية، ولهذا الوالي أياد بيضاء في كثير من المسائل، كبناء المدارس الحديثة لصرف الأهالي عن المدارس الأجنبية والتبشيرية، وفي عهده تعاون المسلمون والمسيحيون على إنشاء غرفة للتجارة ومقر للبورصة في بيروت، وتم شق الطرق وتنظيم دوائر العدل وجهاز الشرطة. ومن هؤلاء الولاة حسن رفيق باشا الذي شيد معهد المعلمين في دمشق ومدت سكة الحديد في عهده، ويعدّ حسين ناظم باشا أطول الولاة عهداً 1897-1909م فقد نمت دمشق في عهده نمواً ملحوظاً، وهو الذي أمر بربط دمشق برقياً مع المدينة المنورة، وجرّ مياه عين الفيجة إلى دمشق، وبنى الثكنة العسكرية «الحميدية» التي تشغلها اليوم بعض كليات جامعة دمشق، وكان آخر ولاة الدولة العثمانية على دمشق الوالي رأفت بك، الذي انسحب منها بعد دخول القوات العربية والبريطانية إليها عام 1918م.
أما حلب فمن أشهر ولاتها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، الوالي أحمد جودت باشا، وهو من المؤرخين المشهورين، له «تاريخ جودت» في عدة مجلدات، وكان ذا عناية بالشؤون الثقافية، وناشد ناشد، وكامل باشا، وجميل باشا الذي امتدت ولايته ما بين 1879 و1886، وإليه ينسب بناء المكتب الرشدي العسكري ومشفى الغرباء في حلب، والوالي رأفت باشا 1885-1900م الذي أسف الأهالي بولاية حلب على عزله مع مطلع القرن العشرين.
دخلت مفاهيم الإصلاح والتغيير على الصعيد القومي والسياسي إلى سورية مع الحكم المصري، فبعد خروج إبراهيم باشا ظل أثر هذه المفاهيم يفعل فعله خاصة بين صفوف المتعلمين والفئات الواعية، وبلغ هذا التفاعل ذروته حينما قدم إلى سورية بعض الولاة المتنورين الذين قادوا حركة التمدن والإصلاح، وأدت المدارس التي تم افتتاحها في هذه الفترة دوراً كبيراً في توعية النشء قومياً وسياسياً، وبدأ الجمعيات بالظهور، وتوالى صدور الصحف، الأمر الذي زاد من وعي الأهالي، فظهر منهم قلة متأثرة بثقافة التغريب أخذت تنادي بالانفصال عن الدولة العثمانية، في حين رأت الغالبية خلاف ذلك، وأخذت تطالب بإصلاح النظم، والقضاء على المفاسد والاستبداد، وتطبيق مبدأ المساواة بين مختلف أعراق السلطنة حفاظاً على تماسكها واستمرارها خاصة بعد ما رأوا أن احتلال فرنسا لتونس وانكلترا لمصر يكشف عن التآمر الغربي على البلاد العربية والإسلامية، لكن تعسف بعض القادة العثمانيين في استخدام صلاحياتهم وظهور النزعة الطورانية ووصول أعضاء جمعية الاتحاد والترقي إلى الحكم، حالت دون تحقيق ما كان يدعو إليه المتمسكون بوحدة الإمبراطورية والرابطة العثمانية، ومما زاد الطين بلة، انحياز الدولة العثمانية إلى المعسكر الألماني، وما قام به جمال باشا من مذابح في سورية ولبنان، كل ذلك جعل النخبة العربية من المتطلعين إلى الحرية توازن بين الحكم التركي واستمرار طغيانه، وإمكانية الاتفاق مع حليف أجنبي يضمن لهم الحرية والاستقلال إذا ما انحازت إلى صفه، فرأت الغالبية منهم أن مصلحتهم في الخيار الثاني. وهكذا بدأ الإعداد للثورة العربية الكبرى، منذ أن أخذت الجمعيات العربية السرية وبعض الشخصيات العربية البارزة بالاتصال مع الشريف حسين بن علي أمير مكة. تطالبه بإنشاء دولة عربية مستقلة عن الدولة العثمانية، تضم الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، وفي ضوء هذه القاعدة جرت الاتصالات ما بين الحسين وبريطانيا التي اتفق من خلالها على وقوف العرب إلى جانب بريطانيا في الحرب مقابل اعتراف بريطانيا باستقلال المشرق العربي وبالشريف حسين ملكاً عليه. ويظهر من خلال مراسلات الحسين مكماهون أن بريطانيا كانت تتحفظ وتبدي من التأويلات الماكرة ما يجعلها مستقبلاً في حل من تعهداتها لتحقق مآربها الاستعمارية.وحين أعلنت الثورة في الحجاز يوم 10 حزيران 1916م لم يكن يدور في خلد بريطانيا أن هزيمة الحاميات العثمانية في مدن الحجاز ستكون بهذه السهولة، فما إن أعلن الشريف حسين ثورته حتى انضم إليها العديد من الضباط العرب العاملين في الجيش العثماني، وتوالى تحقيق الانتصارات بالسيطرة على كامل الحجاز والأردن وفلسطين ودخول فيصل بن الحسين إلى دمشق في تشرين الأول 1918م، وهذا يؤكد أن عودة العرب للمشاركة في صنع الحضارة من الأمور الممكنة إذا تهيأت لهم الظروف والإمكانيات، غير أن العرب وقبل أن يشتد ساعدهم فوجئوا بالمؤامرة الفرنسية البريطانية التي كشف النقاب عنها في مؤتمر الصلح الذي أعقب الحرب مباشرة، وتبين لهم أن المبادئ التي دعا إليها الرئيس الأمريكي ولسون في الحرية وحق تقرير المصير، ما هي إلا أكاذيب وأوهام في إستراتيجية الغرب، اعتمدها ولا يزال، في التضليل والخداع. ومهما يكن فقد احتلت القوات الفرنسية سورية ولبنان، واحتلت بريطانيا العراق والأردن وفلسطين بحسب نصوص اتفاقية سايكس بيكو السرية، وأنزل العلم العربي من على دور الحكومة في المدن السورية كافة لتبدأ البلاد مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع القوى الاستعمارية التي حطمت ما كان قائماً من الوحدة بين العرب حتى في ظل الإدارة العثمانية.